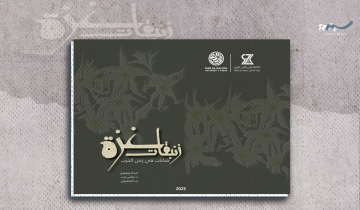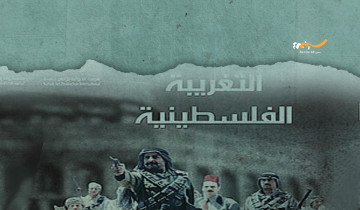تَجويف الثّقافة العربيّة الفلسطينيّة عَبر تَحويلِها إلى “مَنطقِة رَماديّة”

في الخامس والعشرين مِن حزيران 2025، تلقّيت اتصالًا هاتفيًّا مِن ممثّلة “لجنة رقابة الأفلام” التابعة لوزارة الثقافة الإسرائيلية، تُعلمني بمنع عرض فيلم “المهرّبون” للمخرج طوني قبطي في مسرح السرايا العربي الذي كان مزمعًا عرضه في السابع والعشرين من الشهر نفسه، بدَعوى عدم حصول الفيلم على موافقة اللجنة للعَرض في إسرائيل. يَكشف هذا التدخّل المباشر الأول من نوعه مِن قِبَل هذه اللجنة تحديدًا منذ تأسيس المسرح عام 1998، عن بروز آليّة رقابية جديدة-قديمة تنضمّ إلى منظومة متشعّبة مِن الأجهزة الرسمية وشبه الرسمية التي تَسعى لِفَرض هيمنتها على الثقافة العربية الفلسطينية في الداخل.
شهدت السنوات الأخيرة إعادة تفعيل لجنة الرقابة على الأفلام، تلك الآليّة البيروقراطية التي كانت قد تراجعت تدريجيًّا مع مرور العقود. جاء هذا التفعيل في سياق تَصاعد النشاط الشرطي والملاحَقات السياسية التي استهدفت عروضًا سينمائية في مسرح السرايا وغيره من المساحات، بما في ذلك فيلما “جنين جنين” و”لدّ”، حيث لجأت أجهزة الأمن إلى التهديد المباشِر بإغلاق العروض والمطالبة بإلغائها.
في أعقاب هذه الحملة القمعيّة، أعادت وزارة الثقافة هيكلة اللجنة وصياغة نظام عمل جديد يُلزم المؤسسات الثقافية المدعومة حكوميًّا بتقديم الأفلام المُزمع عرضها مسبقًا للمصادقة عليها. تعمل هذه اللجنة بالتّنسيق مع جهات حكومية متعددة، وتُقيّم الأعمال الفنية وفقًا لمعايير مطّاطة وغامضة مثل “الخطاب الجماهيري اللائق” و”عدم المسّ بمشاعر الجمهور”، وهي مصطلحات فضفاضة تفتح المجال واسعًا أمام التفسيرات التعسّفية والانتقائية.يُمثّل هذا النظام الرقابي الجديد مَصدَر قَلَق، ويستطيع أن يشكّل أداة لتدجين الثقافة العربية وتفريغها مِن مضمونها النقدي.
تُجسّد الحادِثة الأخيرة حول فيلم “المهرّبون” نمطًا يوميًّا تعيشه المؤسسات الثقافية العربية في الداخل، وتَندرج ضمن سلسلة من التدخّلات القمعية كان أخطرها التدخّل المباشر لأجهزة الشرطة الإسرائيلية لمنع عرض فيلم “جنين جنين” لمحمد بكري في آب 2024، وفيلم “لدّ” لرامي يونس ومايا فريلاند في تشرين الأول 2024.
الأمر الأكثر إثارَة للقلق هو أن منع فيلم “لدّ” في مسرح السرايا في يافا تزامَن مع السماح بعرضه في صالة “سينماتك” في تل أبيب، وهو ما يكشف عن بروز سياسة جديدة ومقلقة تتمثّل في تحويل القانون إلى مجرّد توصية غير ملزمة، يُطبّق أو لا يُطبّق بحسب هويّة المنظّم. يتجلّى هذا النمط بوضوح أيضًا في قضية الفنان نضال بدرانة، الذي مُنع مِن تقديم عرضه "الكبّة الحديديّة" في حيفا والناصرة إثر حملة تحريض شرسة أدّت لاحقًا إلى اعتقاله مِن منزله في حيفا، بسبب مقاطع ساتيرا وصفت أنّها "حسّاسة للمجتمع الإسرائيلي"، في المقابل نَجِد أنّ مقاطع في سياق مماثل تُعرض على شاشات التلفزيون الإسرائيلي ويقدّمها فنانون يهود، دون مساءَلة.
هذا النوع مِن الرقابة لا يُمارَس باسم القانون، بل مِن خلال تفريغ القانون من صلاحيته والانصياع خلف ضغوط جهات غير رسمية متطرّفة، تعمل بشكل استراتيجي وممنهج لتحويل الانتقائية في التطبيق القانوني إلى أداة تخلق نظامًا هرميًّا من المواطنة، حيث تتمتع مجموعات بحماية كاملة، بينما تُترك أخرى في منطقة رماديّة من الحقوق المنقوصَة والحريات المُقيّدة.
يؤطّر الفيلسوف ميشيل فوكو في نظريّته حول “المَناطق الرماديّة” هذه الظاهرة بوصفها آلية لإعادة صياغة ديناميكيات القوة عبر التطبيق الانتقائي للقوانين. السلطات، وفقًا لفوكو، لا تحتاج إلى إلغاء القوانين صراحة، بل تكتفي باستخدامها بانتقائيّة لإدارة المجتمعات المهمّشة والحفاظ على الهيمنة السياسية والثقافية. يدعم عالم الاجتماع ديفيد غارلاند هذا التحليل، مبيّنًا أن السلطات تستخدم التلاعب بالآليات القانونية للتحكّم بالمجموعات المهمّشة وتعزيز التسلسلات الهرميّة الاجتماعية والسياسية. بهذا الشكل، تتحوّل الانتقائية في تطبيق القانون إلى سلاح يهدف إلى تجويف الثقافة العربية الفلسطينية، حيث يصبح القول الفصل لهيئات رقابية متعدّدة، رسمية وغير رسمية (ويمكن القول: شبه رسمية)، وليس للقانون الذي يتخلّى عن مكانته عندما يتعلّق الأمر بالمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.
الانتقائيّة في تطبيق القانون ليست ظاهرة جديدة في ما يخصّ القضايا التي تمسّ المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. خلال الحرب الأخيرة، وثّقت تقارير ومَقاطع مصوّرة طرد مواطنين عرب من الملاجئ العامة إو منع دخولهم إليها، دون أيّ مساءلة جديّة من قبل الشرطة. بينما حَصَلت أحداث أخرى لمنع دخول مواطنين يهود للملاجئ على مُعالَجة من قبل هذه الجهات. ولعلّ أبرز قضيتين تُوظّف فيهما هذه الانتقائية هما هدم البيوت والجريمة في المجتمع العربي، حيث تُطبّق قوانين البناء والتخطيط بصرامة قاسية. وبالتوازي، لا تُنفّذ القوانين المتعلّقة بالجريمة المنظّمة والأسلحة غير المشروعة بالجدّية المطلوبة. هذا النهج المزدوج يقوّض الثقة في المؤسسات ويعزّز الشكّوك حول وجود سياسة تهميش متعمّدة.
علاوةً على ذلك، خلال أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021، مارَست الشرطة الإسرائيلية سياسات قمعيّة ضد المتظاهرين العرب، بينما وفّرت الحماية وسهّلت المظاهرات اليهودية، وكأن الحقّ في التظاهر وحرية التعبير محميّان لمجموعة ما ومستهدَفان بالنسبة لأخرى. وعلى المنوال نفسه، شهدنا بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023 تفاوتات صارخة في تطبيق قوانين التّحريض، حيث تمّت ملاحقة مواطنين عرب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها الشرطة تحريضًا، بينما تجاهلت تحريضات كثيرة دَعَت صراحة إلى العنف والقتل من قِبل مواطنين يهود. وفي هذا السياق أيضًا، شهدنا اعتقال فنانين فلسطينيين مثل دلال أبو آمنة وميساء عبد الهادي بسبب منشورات على وسائل التواصل، في حين لم يُفتح حتى تحقيق ضد المغني الإسرائيلي إيال غولان الذي دعا إلى “محو غزة وعدم الإبقاء على أحد هناك”. كما لم يُعاقَب أو يُستدعَ للتحقيق أي من الفنانين الإسرائيليين الذين قاموا بأعمال تحريض واضحة ومباشرة.
تترك الانتقائية القانونية في المجال الثقافي عواقب جسيمة على الإنتاج الثقافي العربي في الداخل، إذ تُعزّز “الرقابة الذاتية” لدى الفاعلين في المجال على حساب جودة العمل وعمقه الفنّي والإنساني، كما تؤدي إلى تآكل النظام القانوني ذاته. وحين تجد المؤسسات الثقافية نفسها بلا حماية قانونية، تصبح أكثر عرضة للضغوط الرسمية وغير الرسمية، ما يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار تُعيق عملية الإنتاج الثقافي برمتها. في هذا المناخ المسموم، تَفقد الثقافة دورها كفضاء للإبداع، وتتحوّل إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين من يملك سلطة القانون ومن يُترك وحيدًا أمام العنف المؤسساتي وغير المؤسساتي.
يحتاج الإنتاج الثقافي إلى مناخ آمن لا إلى بيئة من التهديد والترهيب، وإلى حماية قانونية حقيقية لا إلى “مراعاة أمنيّة” انتقائيّة. وحين تُستخدم الشرطة لإغلاق صالات العرض بدلًا من محاسبة المحرّضين عليها، تجد الثقافة العربية في الداخل نفسها في معركة بقاء، تقاوم بنية تحتية راسخة للإقصاء السياسي والثقافي. إن حماية الحَقل الثقافي تتطلب بنية قانونية وتنفيذية عادلة وشفافة وقابلة للمساءلة. لكن كلّ هذا يبدو اليوم، في ظلّ هذه الظروف، ضربًا من المستحيل.
في مواجهة هذه المنظومة المعقّدة من القمع الممنهج، تجد المؤسسات الثقافية العربية نفسها في موقِف شديد التّعقيد. فمن جهة، لا يمكن الاستسلام لهذا التَجويف المقصود للثقافة الفلسطينية، ومن جهة أخرى، فإن كلّ محاولة مقاومة تحمل في طياتها مخاطرَ حقيقيّة على استمرارية العمل الثقافي ذاته.
نَعَم، نَجَحنا أحيانًا في كسر بعض الحواجز - عَرَضنا فيلم “فرحة” (تشرين الأوّل 2022) رغم التهديدات الرسمية بإغلاق المسرح، ودفعنا لعرض “لدّ” في مكان آخر، وأقمنا مؤخرًا عرضًا لفيلم “المهرّبون” على الرغم من محاولة المنع- لكن كل “انتصار” من هذه الانتصارات فيه مخاطرة حقيقيّة يمكن أن يكون ثمنها باهظًا. هذه “الانتصارات” الجزئيّة قد تُخفي حقيقة أوسع وأعمق: أن المنظومة التحريضيّة تعمل بفعالية، وأن الكثير مِن المؤسسات الثقافية تمارس رقابة ذاتية. كم مِن فيلم لم يُعرض؟ كم مِن نشاط ثقافي أُلغي قبل الإعلان عنه؟ كَم فكرة وُضِعت على الرفّ حتّى إشعارٍ آخر؟
إن ما نواجهه ليس مجرّد قرارات رقابية منفردة، بل مشروع ممنهَج لتحويل الثقافة العربية الفلسطينية إلى مجرد “فولكلور” مُستَأْنس، مُفرّغ من مضمونه النقدي والسياسي. وفي مواجهة هذا المَشروع، تُصبح كلّ محاولة للحفاظ على مساحة ثقافية حقيقية فعلًا مقاومًا، حتى لو بدا صغيرًا أو محدود الأثر.