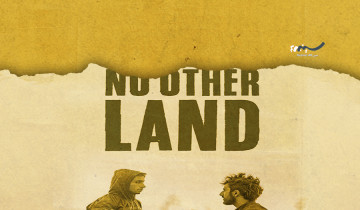الفَنّ بَين التَّعبير والتَّغيير

في البَدء كانت الكَلمة ومِن الكَلمة وُلد المَسرح، منذ فجر الحضارة شكّل الإنسان علاقته بالفَنّ بوصفه وسيلة أساسية للتّعبير عن ذاته وكيانه، وعمّا في داخله مِن مَشاعر، وأفكار، وهواجس. والمَسرح وُلد مِن رحِم الطقوس الدينية في الحضارة اليونانية القديمة، من خلال الشّعائر المتعلقة بالإله ديونيسوس وتحوّل لاحقًا إلى فنّ مستقل قائم على "الفعل"، وهذا هو معنى كلمة دراما في اليونانية. لقد كانت هذه الانطلاقة تعبيرًا عن حاجة الإنسان المستمرّة لأن يُجسّد ما بداخله.
ظَهَرت الفنون بوصفها لُغة بديلة، تَنقل مكنونات النّفس التي تَعجَز اللغة اليومية عن التّعبير عنها. هي وسيلة لقول "ما لا يُقال"، وشكل من أشكال الإِفصاح عن دوافعنا وهواجسنا الدّفينة.
ويقوم المَسرح، بوصفه "أبا الفنون"، على المُحاكاة كَما وصفها أرسطو في كتاب "فنّ الشِّعر"، حيث يُعبّر الإنسان عن ذاته مِن خلال فِعل أدائي يتضمن: الجسد، والصوت، والإيقاع، والوزن، والحركة، والفضاء. لا تَعمَل هذه العناصر بمعزِل عن بعضها، بل تتكامل لتخلِق لحظة فنّية قادرة على اختراق وَعيِ المتلقي و"لا وعيه" في آن.
وقد جاءت السينما لاحقًا، مضيفة أدوات جديدة تُمكّن مِن الوصول إلى جمهور أوسَع، وتشترك مع المسرح في الهدف الجوهريّ: تجسيد الإنسان في حالاته المختلفة، وعرض الواقع والاحتياجات الإنسانيّة الدّفينة بصورة إبداعية وخلاقة.
ليس الفنّ مجرّد مرآة للواقع، بل هو قَناة للتغيُّر والتحرُّر، من خلال تَجسيد الشخصيات والأحداث، يَدخل الفنان في حالة اندماج مع ما يقدّمه؛ فكلُّ ممثل يضع جزءًا مِن ذاته على الشخصية التي يؤديها، وكلّ مُخرج يبني رؤيته وفقًا لدوافعه وتجربته الداخلية، وكذلك الكاتب. لهذا السبب، يُمكن أن نشاهِد عروضًا عدّة للنصّ المسرحيّ ذاته على مرّ السنين، ونشهد في كلّ مرّة رؤية وولادة جديدة.
تولّد هذه العمليّة الفنيّة ما يُعرف بـ "الكاثارزيس" أو التطهير سواء لدى الفنان أو لدى المتلقّي. وهي لحظة تطهير النَّفس من خلال العواطف التي تكون في ذروتها، وتُلامس أعماق النَّفس وتُخرج ما كان مختبئًا في كياننا فتنقّي ذواتنا وأحيانًا تحرِّر وتُطَهر.
مِن هنا، لا يُمكن النّظر إلى الفنّ – والمَسرح تحديدًا – إلا بوصفه طقسًا إنسانيًّا عميقًا، يتجاوز التّسلية أو التّرفيه. إنّه شكل مِن أَشكال فهم الذات والعالَم (وربما التّصالح معه أحيانًا). ويُشاركُ كلّ عنصر في العَمل الفنيّ -النصّ والإخراج والتمثيل، وحتى المكان والزمان- في تَشكيل رؤية شاملة تعبّر عَن مقولة فكريّة وفنّية عميقة. وحين يتفاعل المتلقّي مع هذه الحالة الفنّية، فإنه لا يكتفي بالمشاهَدة، بل يَدخل بدوره في التّجربة، ويصير جزءًا مِنَ الفِعل والطقس الفنّي ذاته.
يقودُني ما سَبَق إلى السُؤال المركزيّ: هل الفنّ أداة لارتقاء بالوعي أم لتزييف الوعي؟ وهل الفنّ مقولة وجود أم أَداة فَناء؟
في خضَم ما يعيشه العالم من أزمات وجودية، ومآسٍ يومية، تتزايد الحاجة إلى مراجَعة موقع الفنّ في حياتنا، فهو أداة مهمة ومؤثرة وأحيانًا خطرة في تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام.
مِن هذا المنطلق، لا يمكن النَّظر إلى أيّ عمل فنيّ على أنه وليد الصُدفة، فهو ينطلق مِن حاجة داخلية، ويمتدّ أثره إلى وعي المتلقّي، وربما إلى تشكيل تصوّراته عن العالم وفي كثير من الأحيان، يتعامل المتلقّي مع الشخصيات المسرحية أو السينمائية وكأنّها شخصيات حقيقية، يتعاطف معها، يصدّقها، ويتبنّى وجهة نظرها، أو العكس، وتصبِح الأحداث وكأنّها تصير في بيته ومَعَه. ومِن هنا تَنبُع خطورة تحوّل هذه الفنون إلى قناة لتمرير مَقولات مشوَّهة.
في زمن الإبادة والموت، حيث تتراكم النّكبات والنكسات على شعبنا الفلسطيني، يصبح مِن غير المقبول إنتاج أعمال تدّعي الحياد، أو تروّج لـ "تعايش وهمي". هَل مِن المنطق أن نعبّر عن وعينا وأعماقنا بأعمال فيها أجندات تَنفي وجودَنا ونَرضى بذلك؟ ليس الفنّ فقط تسليةَ وقضاء وقت، إنّما هو رسالة ومَقولة. تُحوِّل هذه الأعمال المشتركة بين المستعمِر والمستَعمر الأكذوبةَ إلى سرديّة مقبولة.
تُعرض بَعض هذه الإنتاجات على منصّات عالمية مثل "نتفلكس" أو في مهرجانات مسرحيّة دولية، وتُقدَّم بمستوى فنيّ عالٍ، وبأدوات فنيّة وميزانيات كبيرة لكي تَجعل مِن السّهل الانبهار في أدائها لتغطي على الرسائل المشوهة التي تختزنها، كما حَدَث في كثير من الأعمال التي استندت بعرضها على أحداث سياسية مستندة على الواقع الذي صيغ بأسلوب ووفق أجندات حوَّلت هذا الواقع لأكذوبة مشوهة، وبسبب التقنيّات الفنّية العالية، كانت النتيجة أن البعض تعاطف مع الشخصيات وتبنّى سرديّتها وانبهر بأسلوب العمل وغَفِل عن ما يحمله العمل من رسائل خطيرة، والنتيجة أن تُكتب هذه الأعمال بأقلام لا تُمثّلنا، بل تناقض وجودنا وتحمل أجندات تهدف إلى طمس الوعي، وتغيير الحقائق حتى لو استندَت عليها.
وحتى عندما تُطرح المواضيع بأسلوب غير سياسي مباشر، وإنما بأسلوب اجتماعي –على سبيل المثال أن يتطرّق مسلسل أو مسرحية لقصّة عن الحياة اليوميّة لـ "جيران" عرب ويهود، فما المانع؟ أليس هذا الطَّرح إنسانيًّا واجتماعيًّا؟– لكن هذا المثال يَعرض في حقيقته واقعًا مصغرًا لمجتمع متجانس ومتناغِم ويُسوَّق كواقع قائم، في حين يُخفي الواقع الحقيقي مِن قهر واضطهاد. وتدريجياً يُخلق وعيٌ جديد بعيد عن الحقيقة التاريخية والراهنة.
إن قوة المسرح والسينما تَكمن في "الفعل". نحن لا نراقِب الحدث فقط، بل نَعيشه. ومِن هنا فإنّ التأثير الناتج عن المحاكاة الفنّية قد يكون أَعمق. لذلك، فإن تَمرير سرديّات مشوَّهة باسم الفنّ هو أمر في غاية الخطورة.
إزاء هذا الواقع، يُطرح السؤال الحاسم: هل يمكن للفنان، وخصوصًا في زمن انكشاف الحَقائق وسُقوط الأقنعة، أن يظلّ محايدًا أو مساهمًا – ولو دون قصد – في تكريس روايات لا تمثِّله؟ وهل نبقى في دائرة النجاح الشخصي على حساب البَقاء الجمعي؟ وهل يكون مَن يرفض هذه الأعمال بمعزل عن السّاحة الفنّية؟ ليس الرّفض هنا ترفًا، بل مَوقف أخلاقيّ وفكريّ وله تداعِياته وتحدّياته، هو واجب -قبل أن يكون وطنيًّا- أخلاقي وإنساني.
الفن في جوهره، فعل تحوّل. وإذا كان المسرح هو "فنّ الفِعل"، فقد حان الوقت لنُعيد توجيه هذا الفِعل نحو إنتاج أعمال مستقلّة، نابعة مِن واقعنا، تعبّر عن آلامنا وتطلّعاتنا، لا عن سرديّات الآخرين. نعم، التحدّيات كثيرة، من التّمويل إلى فرص العرض والعمل، لكنّ الصمت أو الاستسلام أخطر.
في الختام
في زمنٍ يعجّ بالموت، وانعدام اليقين، حيث تتعرض الذاكرة للطَّمس، والهويّة للتهديد، تصبح الفنون فعلًا وجوديًا. قد تَحفر الأعمال الفنية في وعينا معانيَ تساعدنا على التمسّك بالحقيقة والبقاء، أو قد تنحِت فينا سرديّات مضلِّلة تشوه الذاكرة وتطمس كياننا.
إن اختيار أيّ عمل فني، ومن يقف خلفه، وكيف يُقدّم، ولمن يُعرض – كلّ ذلك ليس تفصيلًا بسيطًا، بل هو مقولة كاملة: إما أن تكون تأكيدًا لوجودنا... أو خطوة نَحو فنائنا.