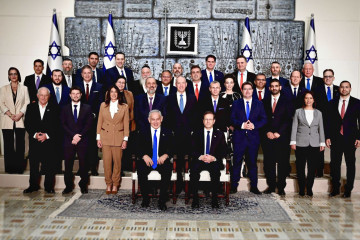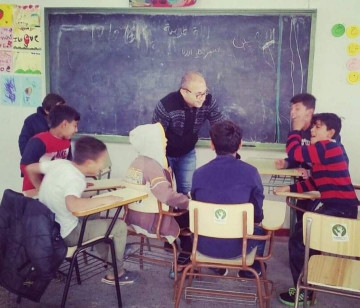نكبة 1948 إلى ما بعد "أكتوبر غزة": ما الذي تَكرّر؟ ما الذي تَغيّر؟

مُنذ العام 1948، لم تَخرج النكبة الفلسطينية من الوعي الجَمعي، ليس لأنها ذكرى مأساويّة فحسب، بل لأَنها مستمرة بزَخَم متجدّد، تتخِذ وجوهًا وأدوات متعدّدة، لكن هدفها واحد: اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتاريخه ووعيه. لكن ما يجري منذ أكتوبر 2023 في غزة لا يدفعنا إلى مجرد استدعاء النكبة الأولى، بل يفرض علينا إعادة تعريف النكبة، وطرح أسئلة موجعة: هل ما نعيشه في غزة اليوم نكبة ثانية أم هي امتداد للنظام النكبوي الذي تأسس منذ قيام المشروع الصهيوني؟ هل مِن العدل مقارنة نكبة الماضي بما يجري حاليًا؟ وهل المقارنة ظُلم لأيّ منهما؟ ثم، ما هو مَوقع الاحتلال الإسرائيلي في هذا التَسلسل؟ هل هو مجرد سبب مباشر، أم نظام مستمر لإعادة إنتاج النّكبات؟
النكبة كتصوّر صهيوني لا كَحَدث عابر
بِهَدَف فَهم النكبة بوصفها مشروعًا لا حادِثة، من الضروري التوقّف عند الإنتاج الخِطابي داخل إسرائيل، ليس فقط الرسميّ منه، بل المدني أيضًا، وخصوصًا متابعة ما يُنشر منه في الصحف الإسرائيلية ومواقع التحليل والسياسات مُتابعةً دقيقة، إذ نجِد أنه يكشف تصورًا مقلقًا حول غزة: ليس كمنطقة مأهولة بالسكان المدنيين، بل كمشكلة ديمغرافية – أَمنيّة ينبغي التخلّص منها. يبرز هذا في تكرار عبارات من نوع: "غزة عبء يجب إنهاؤه"، و"غزة يجب ابادتها"، و"غزة بدون سكان"، كما ظهر في دعوات التهجير والترانسفير المتكررة.
اللافت أن هذه اللغة لم تعد حكرًا على الأطراف اليمينية أو المؤسسة العسكرية، بل بدأت تتسرّب إلى صحف مركزية وتعبيرات المجتمع المدني في إسرائيل، مما يشير إلى تحوّل عميق في المزاج العام الإسرائيلي نحو تقبّل فكرة الإبادة كحلّ مشروع، تحت غطاء أمني أو ديمغرافي. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل. هل ما يحدث في غزة نكبة أم شيء آخر؟
ارتبطت نكبة 1948 بالتّطهير العرقي، والمجازر، وتهجير نحو 750 ألف فلسطيني. لكن ما يحدث في غزة منذ أكتوبر 2023 يتجاوز هذا الإطار الكلاسيكي. نحن أمام مشهد إبادة موثَّقة، ليس فقط في عدد الشهداء (أكثر من ٥٧ ألفًا حتى كتابة هذه السطور)، بل في أدوات القتل والتدمير: "استخدام المجاعة كسلاح، استهداف الأطفال والمدارس، تدمير ممنهج للبنى التحتية، وتجريف ذاكرة المدينة بصواريخ ذكية وعمياء في آن واحد".
ومع ذلك، فإن الرابط الأهم بين النكبتين ليس فقط في النتيجة، بل في النيّة السياسية – الأيديولوجية – التي تقف خَلف الفِعل، رغبة مدروسة في تفريغ المكان من أهله، سواء عبر القتل أو بدفعهم للرحيل.
إن هذا الربط لا يمكن فَصله عن الأهداف الحقيقية للاحتلال باعتباره نظامًا نكبويًّا مستمرًّا، كما لا يمكن اختزال الاحتلال في كونِه نتيجة للصراع، بل هو امتداد عضويّ للنكبة، وهو أداته المتجدّدة في: مشروع الاستيطان، منظومة الجدار، سياسات الحصار، محاولات الأسرلة، كلّها تعبيرات معاصرة عن فلسفة النكبة.الاحتلال ليس فقط فاعلًا عسكريًا، بل نظام نكبوي شامل، يُعيد إنتاج أدوات الطرد والتّفكيك والتذويب، بشكل مُمَنهَج ومَدروس.
الخطير أن هذا النظام بات أقلّ حرصًا على تبرير فِعله أَمام العالم، وأكثر جُرأة في الإعلان عن نواياه. في 1948، نُكبت فلسطين باسم الدولة الوليدة. اليوم، تُباد غزة باسم أمن الدولة القائمة.
نكبة الجيل الجديد: مِن التشبّث بالأرض إلى الرّغبة في الرّحيل
في النكبة الأولى، فُرضت الهجرة القسرية. أما اليوم، فإنّ النكبة تُغرس في الوجدان، وتُبرمج في اللاوعي. الجيل الذي لطالما اعتُمد عليه في التشبث بالأرض، صار اليوم يَحلم بالرحيل عنها. لم تَعد غزة بالنسبة له رمزية الصمود فقط، بل رمز الانغلاق والاختناق والموت البطيء، هو جيل لا يتمنّى البقاء، ليس ضعفًا، بل يأسًا؛ وهذا – في حدّ ذاته – أخطر ما في النكبة الجديدة: "أن تَفقد الأمل قبل أن تَفقد الأرض".
إذا كانت النكبة الأولى لحظة تأسيس لمأساة مستمرة، فإن نكبة غزة الحالية هي "نكبة الأمل الذي يُلغي الوجود".
النكبة كأداة للوعي والمواجهة
إذا كانت النكبة الأولى لحظة تأسيس لمأساة مستمرة، فإن النكبة الحاليّة هي تتويج لسيرورة من الإبادة الرمزية والمادية؛ لكنّها – paradoxically – تمنحُنا أيضًا لحظة وعي حاسمة أن الصراع ليس حول حدود أو حكومات، بل حول حقّ شعب في أن يكون.
المطلوب إذًا ليس فقط إحياء ذكرى النكبة، بل إحياؤها كأداة تحليل ورفض ومواجهة، لأن النكبة ليست ذكرى من الماضي، بل مشروع مستمر، لا يُهزم إلا بوعي جماعي يرى الصورة كاملة من 1948 إلى أكتوبر 2023 غزة، من التطهير العرقي إلى الإبادة، من الرغبة في البقاء إلى الحلم بالهروب… وما بينهما، كلّ ما يعني أن نكون أو لا نكون.

د. إسلام موسى (عطا الله)
باحث فلسطيني متخصص في العلوم السياسية، حاصل على دكتوراه من جامعة قرطاج بتونس. يعمل في وحدة أبحاث الأمن القومي بمركز التخطيط الفلسطيني، وباحثًا رئيسيًا في المركز الفرنسي لبحوث وتحليل السياسات الدولية (CFRAPI) في باريس. تركز أبحاثه على الأمن القومي والتحولات السياسية في الشرق الأوسط.