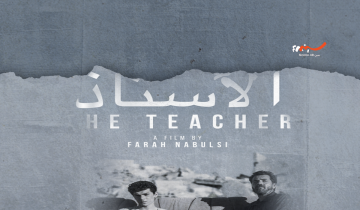دائرة الحياة والموت: مشهد موت "مُفاسا" من فيلم "الأسد الملك"

في زمن يتكشّف فيه الموت يوميًّا أَمام أعيُن الأَطفال، عَبر الشّاشات والأخبار والصُوَر والصَواريخ، تُصبح السينما أَكثر مِن مجرّد أَداة تَرفيه؛ وتتحوّل إلى مساحة نفسية، وتأملية، بل وأخلاقية. مِن بين كلّ مَشاهد المَوت التي عَرَفَتها أفلام الرّسوم المتحركة، يظلّ مَشهد موت مُفاسا في فيلم "الأسَد المَلك" (1994) لحظة فارقة، لا تُنسى.
يبدأ المَشهد بلَحظة نادرة مِن الرَّجاء: الأَب يُحاول إنقاذ ابنه، يتسلّق الجَرف بصعوبة، يَصرخ مستنجدًا، فيمدّ له أخوه سكار، يَدًا، لا ليُساعده، بل لِيَطعنه. الكفّ الذي بدا في لحظة ما وكأنّه يَد الخلاص، ينقلب إلى مخلَب للخيانة.
مَشهد الغَدر هذا يُقدِّم القتلَ للأطفال بطريقة صادمة، لكن مَحسوبة: لا يُظهر الفيلم دمًا ولا عنفًا مباشِرًا، بل يستخدم عناصر بصرية وصوتيّة لبناء لحظة من الرّعب الأخلاقي. سكار لا يَقتُل بمخالِب حادّة بل بخيانة، بِيَدٍ ممدودة تتحوّل إلى دَفْعة مميتة، ما يَجعل القَتل هنا تمثيلًا رمزيًّا للخيانة، والتخلّي، وغياب الأمان مِنَ الأقربين. بالنسبة للأطفال، لا يتمثّل الخوف مِن الموت في حدّ ذاته، بل في إمكانية أن يأتي من شخص يُفترض به أن يكون مَصدر ثِقَة. يُزرع هذا التصوير في وعي الطّفل كسؤال أخلاقي عميق حول الثّقة، والسُلطة، والعدالة، أكثر مِن كونه مجرّد لحظة درامية.
ثم تَأتي الضرّبة: دفعة واحدة تُسقِط الأسد الملك من أعلى الجَرف وسط زئير مَكتوم، ليصطدم جسده بقوّة بالصخور، قبل أن يستقر ساكنًا وسط الغُبار. هذه ليست لحظة رمزيّة عابرة، بل مَشهد موتٍ مباشر، بَصَري، محسوس. نرى الجَسَد، نرى السُّقوط، ونَسمع زئير الاستنجاد. لا يتمّ تغليف الحَدَث برمزية غامضة ولا يُخفى خلف سِتار مِن الاستعارات. الموت هنا جسديّ، حقيقيّ، قاسٍ. ومع ذلك، يظلّ المَشهد مصاغًا بذكاء فنيّ فائق: لا دَم، لا رُعبَ مبالغًا فيه، بل مزيج دقيق من التأثير والاحتواء.
لكنّ اللحظة الأشدّ ألمًا ليست السقوط بحدّ ذاته، بل ما يَتبعه: سيمبا، الطفل، الشبل الصغير، يَركُض نَحو جثّة والده. يهزّه، يُحاول إيقاظه، يَصرخ. وحين لا يأتي الردّ، يتكوّر الصغير في حُضن والده، في عناق بارد مِن طَرَف واحد. إنها لحظة اختزال عاطفيّ كثيف لمعنى الفُقدان عند الطفل: الارتباك، الإنكار، الصّدمة، والتمسّك بالجسد كدليل أخير على العلاقة.
مِن مَنظور نفسي–ثقافي، يَكشف هذا المَشهد عن فَهم عميق لطبيعة الحُزن الأطفاليّ. فالأطفال لا يملكون اللغة المجرّدة للموت ومفاهيمه، بل يتعامَلون مَعه عبر الجسد، والصّوت، والغياب الفوري. الجسد المُلقى على الأرض يصبح رمزًا للفقدان، والخذلان، والخوف مِن الوحدة. وهنا تتجلّى عبقرية صانعي الفيلم: لقد رَسَموا ملامح الحزن دون أن يَسلبوا الطّفل قدرته على الاستيعاب، ودون أن ينفصلوا عن الواقع الحسيّ له، وطَبعًا دون أن يخفوه وراء ستارة من الإخفاء.
تستند سردّية الفيلم إلى نموذج كيوبلر-روس (Kübler-Ross) الشّهير، الذي يقترح أن الحُزن يتنقّل عبر خمس مراحل: الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والقَبول. تُستخدم هذه النظرية، رغم تَبسيطها، كإطار لفهم كيفية تعامل الإنسان – والطّفل بِشَكل خاص – مع الفُقدان والصَدَمات. في فيلم الأَسَد المَلِك، تُجسّد هذه المراحل بشكل رمزي وعاطفي من خلال رحلة "سيمبا" بعد وفاة والده "مفاسا"، مما يمنح المُشاهد – الطفل والمربّي على حدّ سواء – فرصةً لفهم الحُزن كمسار داخلي معقَّد.
يَبدأ سيمبا بالإنكار الكّامل: يَهرب مِن مَوقع الحادث، مِن ماضيه، ومِن ذاكرة والده. وبينما يَبدو الهروب جسديًا، فإنه في جوهره هروب نفسي مِن الحقيقة المؤلمة. يَجِد سيمبا في عبارة "هاكونا ماتاتا"، التي تعني "لا تقلَق"، فلسفة كاملة مبنيّة على النّسيان والإنكار. هُنا، لا يتعامل الطفل–الأَسَد مع الألم، بل يدفنه تحت غلاف من اللامبالاة والمِزاح، في مَشهد ساخر ظاهريًا مُشبَع بالحزن المكبوت. لكنّ الهروب لا يصمد، ومع الوقت تَظهر مشاعر الغَضَب واللوم الذاتي. يتّهم سيمبا نفسه ضمنيًا، ويُحمّل ذاته عبء الخطيئة: "كلّ هذا بسببي"، يقولها بِصَوت مَكسور، في تعبير واضح عن مرحلة المساومة الداخلية، حيث يُحاول الطفل أن يجد تفسيرًا للألم حتى لو كان على حساب ذاته.
مَع مُرور الوَقت، يدخل سيمبا في حالة مِن الاكتئاب الصّامت، يَعيش في ظلال الحياة وفَلسفة "الهاكونا ماتاتا"، دون هَدَف، وكأن الفقدان قد اقتطع منه جوهره. إنّها لحظة ضَياع وجودي، لا تَحمل فقط أَلَم مَوت الأَب، بل تفككًا لهويّة الابن. لكنّه، ومع استحضار صورة والده في السماء، ومَع كلمات الحكيم "رفيقي"، يبدأ بالتحوّل. يبدأ القبول ليسَ كنهاية للحزن، بل كنقطة انطلاق جديدة. لا يَعود سيمبا إلى "أَرض العزة" لينتقم، بل ليُعيد التوازن، وليعترف بأن الفقدان جُزء من دَورة الحياة. يتصالَح مع الذاكرة، لا يدفنها. يتقدم إلى الأمام، وهو يَحمل أباه داخله لا على ظهره.
في أحد أكثر مشاهد الأَسَد المَلِك شاعرية وعمقًا، ينظر سيمبا إلى سَطح الماء فيرى انعكاس وجهه، ثم تتداخل الملامح تدريجيًا ليظهر وجه والده مفاسا. تحمل هذه اللحظة بعدًا رمزيًا هائلًا: فالأَب لم يَمت تمامًا، بل يَسكن في ملامح الابن، في صوته، في ذاكرته. الماء، كمرآة للحقيقة الداخلية، تُظهر لسيمبا أن ما يبحث عنه في الخارج – أَي صورة الأب الغائب – موجود بالفعل في داخله، كجزء من هويّته وتكوينه العاطفي.هذا التصوير البصري العميق يُتَرجِم بطريقة حسّية واحدةً من أبرز الأفكار في علم النفس الوجودي: أن الفقدان لا يُمحى، بل يتحوّل إلى حُضور داخليّ دائم، إلى حِوار داخلي مع مَن رَحَلوا.
وحين يتصاعَد المشهد ليرى سيمبا والده في السماء، من خِلال سحب مضيئة وصَوت مفاسا الذي يناديه: "تذكّر من أنت". لا يعود الحديث هنا عن الحُزن فحسب، بل عَن المسؤولية، عن الجذور، عن الاستمرار في حَمل الرسالة التي تَرَكها الفقيد. تُصبح السماء موضعًا للذاكرة، ويتحوّل النّداء الأَبَوي إلى بوصلة أخلاقية وروحية في حياة الابن. في هذا التصوير، يقدّم الفيلم رؤية تربويّة عميقة: الغائبون لا يغيبون تمامًا، بل يعودون في ذاكرتنا، في قراراتنا، في أصواتهم التي تَهمس في أعماقنا لَحظة الشكّ. وهكذا، لا يُصبح الحزن عبئًا، بل رابطًا إنسانيًا متجدّدًا، يرافقنا في الطريق دون أن يُعيق السَير فيه.
لا يُقدَّم هذا المسار في الفيلم كعِلاج سَطحي، بل كرحلة وجوديّة عَميقة، تبيّن أن الحُزن لَيس مرضًا يجب التخلّص منه، بل تجربة إنسانية تستحق أن تُعاش بكلّ مراحلها، وأن التّشافي لا يعني نهاية الألم، بل تحوّله إلى مصدر قوّة واتصال بالذات. بهذا، يقدّم الفيلم رؤية ناضجة للأطفال، بل وللكبار، حول مَعنى الفقدان، ويَزرع فيهم بذورًا من الحكمة والشجاعة في مواجهة غِياب مَن نُحب.
ورغم أن نموذج كيوبلر-روس لمراحل الحزن يُستخدم على نطاق واسع كأداة لفهم تجربة الفقدان، فإنه لا ينبغي التعامل معه كمسار خطّي حتمي أو وصفة علاجية واحدة. فالحزن، بخلاف ما تقترحه المراحل الخمس، لا يسير دائمًا وفق ترتيب واضح، بل يتحرّك في موجات، يتكرّر ويتحوّل، وقد تظهر مراحل متعددة في آن واحد، أو تعود بعد أن اعتقدنا أننا تجاوزناها. إن الطفل – كالبالغ – لا يمرّ بمرحلة "القَبول" لينسى أو يُنهي حزنه، بل ليحمله بشكل مختلف، أقلّ حدّة ربما، لكنه لا يُمحى. بهذا المعنى، يُمكن اعتبار المراحل أدوات للتسمية والفهم، لا خارطة إلزامية، ويُستحسن أن نتعامل مع الحزن كحركة داخلية ديناميكية، تتشكّل مِن العلاقة بين الفقدان، والزمن، والذاكرة، لا مِن تسلسل نفسي صارم.
تُشير أبحاث في علم النفس التربوي والعلاج بالفن إلى أن الأطفال غالبًا ما يعجزون عن التّعبير المُباشر عن مَشاعر الفقدان والحزن، وأنهم يستجيبون بشكل أكثر أمانًا وانفتاحًا عندما تُقدَّم لهم هذه المشاعر في سياق غير مباشر ورمزي، مثل القصص أو الأفلام. وفقًا لدراسات في علم النفس التربوي، فإن السّرد القصصي والتمثيل الرمزي يساعدان الأطفال على إدراك الفُقدان بطريقة تتناسب مع مستوى نموّهم المعرفي والعاطفي، ويمنحانهم أدوات للحديث عن مشاعر يصعب تسميتها. مِن هذا المنظور، يقدّم فيلم الأَسَد المَلِك مساحة آمنة ومؤثرة يتعرّف فيها الطفل على تجربة الحزن من خلال شخصية "سيمبا"، دون أن يَشعر بأنه هو نفسه في قَلب الحَدَث. يسمح له هذا التّباعد العاطفي بالاقتراب، لا بالانسحاب، ويفتح أمامه قناة للتفكير والتساؤل والمشاركة.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر دراسات في العلاج بالدراما أنّ رؤية شخصيات مألوفة تَعيش ألمًا مشابهًا وتمضي في مسار للتعافي، يعزّز لدى الأطفال الشُّعور بالتماهي والقُدرة على التحمّل. يشير الباحث روبرت لاندي إلى أن القصص التي تتناول الفقدان تُسهم في بناء "لغة مشتركة" بين الطفل والبالغ، وتُساعد في فتح الحوار حول مواضيع مؤلمة يصعب التوجّه إليها. في هذا الإطار، لا يُعدّ فيلم الأَسَد المَلِك مجرّد قصّة حَزينة، بل ممارسة تربوية ونفسية توفّر نموذجًا لمعالجة الحُزن عبر التخييل، وتُظهر للطفل أن الحزن ليس خطأ، وأن العودة مِن الضياع ممكنة. بل إن الفيلم نفسه، في بنيته الدائرية، يُعيد تعريف المَوت كجزء من "دائرة الحياة"، لا كنقطة نهاية، مما يمنح الطفل تصوّرًا أكثر اتساعًا للوجود وما بَعد الخسارة.
في السياق الذي نعيشه اليوم، حيث يسمع الأطفال صفّارات الإنذار أكثر مما يسمعون الموسيقى، ويشاهدون مَشاهد الركام أكثر مما يشاهدون الرسوم المتحركة، يصبح هذا المشهد مرآة ضرورية. فهو لا يقدّم الموت كبطولة أو تجريد، بل كألم، وغياب، وأثر دائم على الطفل. ومن خلاله، يُتيح لنا مَشهد مَوت مُفاسا فُرصة للحديث عن الموت، لا كنهاية، بل كجزء من رحلة التشكّل النفسي والإنساني.
أفلامُ الأطفال العظيمة لا تَحمي الطفل مِن الواقع، بل تمنحه أدوات لفهمه. وفي مَشهد موت مُفاسا، نَرى كيف يمكن للسينما أن تكون جسرًا بين الفقدان والخيال، بين الجرح والتعافي، بين الطفل والأسئلة التي لا يَملك أحدٌ إجاباتها الكاملة.

د. لؤي وتد
باحث وناقد متخصص في أدب الأطفال والسياسة الثقافية، يركز في أبحاثه على الأدب الفلسطيني وتمثيلات الطفولة في سياقات استعمارية.