"الأُستاذ" لِفَرَح نابلسي… المُقاوَمَة بِوَصفها احتِرافًا
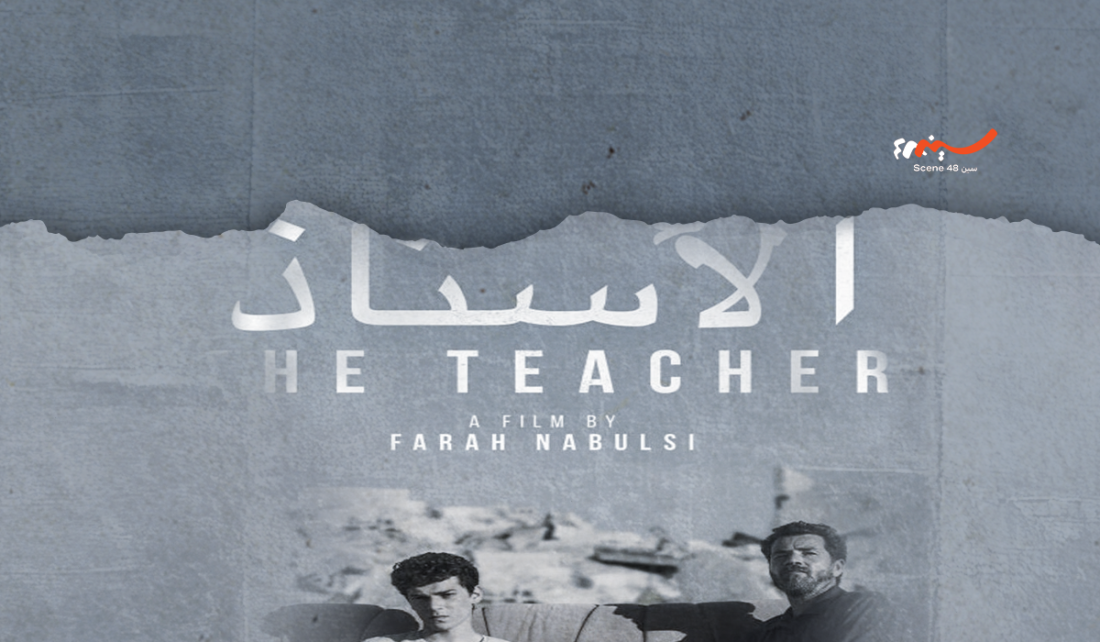
في فيلمها القَصير، "الهديّة"، قدّمت فَرَح نابلسي ضِمن سياق فلسطيني تقليدي، تنويعًا بالبعد الإنساني والقدرة الطفوليّة على التحقيق، في ما هو خارج المتوقَّع والمقبول بقوانين الكبار، أيّ بشروط الواقع، فعَبَرت الطفلة الحاجز كما لم يَنتظر أَحَد. وبفيلمها الطّويل الأول “الأستاذ"، حَمَلت نابلسي أهمّ قيمتين في فيلمها القصير: إنسانية الحالة الفلسطينية والقدرة على التحقيق بتحدٍّ للشروط الواقعية للاحتلال. عُنصران جعلا من الفيلم إضافةً نوعيّة لمسيرة السينما الفلسطينية، لسببٍ رفعَهما وهو الشّغل البصَري الممتع في نقل سرديةٍ مكتوبة بعناية.
أبقى الفيلمُ القصّة الفلسطينية في سياقها المحليّ المسيطِر على عموم هذه السينما، لكن بانزياحٍ عن المتكرّر ضِمن هذا السياق، فلم تُبنَ القصّة على عناصر إنشائية وإسمنتية للاحتلال، بل على استقلالية فلسطينية ضمن حالة الاحتلال. ولم تَحُم حَول جدار، أو حاجز، أو جندي، أو جيب عسكري، ولم تتصرّف الشخصية الرئيسة، الأستاذ باسم، بردّ فعلٍ على ذلك. بل كان التصرّف مبنيًا على حالةٍ دائمة للاحتلال وليس حدثٍ فرديّ راهِن يتطلّب ردّ فعلٍ تجاهه، مصغّرًا، الحدثُ وردُّ الفعل، ديمومةَ الاحتلال وضرورةَ المقاومة بوصفها استمرارية، وبشكلها الاحترافي، بِمَعزل عن الحدث الراهن.
في الفيلم، المشارِك في مهرجان تورونتو السينمائي ضمن تظاهرة "اكتشاف" (٢٠٢٣)، أستاذُ لغة إنكليزية يتقرّب من طالبيه الشقيقين إثر هدْم بيتهما، المجاور لبيته. ويَقتل مستوطنون حاولوا إحراق أشجار زيتونٍ، الأخَ الأكبر، يعقوب، حين حاول منعهم، فيُمضي الأستاذ الوقت مع الأخ الأصغر، آدم، حاثًّا إياه على عدم الانتقام، مقدّمًا له الكتب وغرفة ابنه الذي قضى طفلًا أسيرًا، كما تنشأ علاقة بينه وبين أخصائيّة اجتماعية بريطانية، زميلته في المدرسة. يُحضر رفاقُ الأستاذ جنديًّا إسرائيليًّا مخطوفًا لإخفائه في بيته، يَكتشف أَمرَه آدم، فينقذ الأخيرُ الأستاذَ في تفتيشٍ أوّل للجيش، ثم تنقذه زميلته في تفتيش ثانٍ للمخابرات. تتطوّر الأحداث وتَنعطف ضمن الحلقة الثلاثية والمواقع المتشابكة لكلّ من الشخصيات الثلاث، وفي مآل كلٍّ منها.
ليسَت المقاومة هنا آنية لحدث متعلّق بالقصّة وينتهي معها، ولا هي عَفَوية عشوائية وجدت الشخصية نفسها مضطرةً إليها وتفشل غالبًا في مسارها، ولا هي بحدّها الأدنى معبَّر عنها بكلامٍ وممارسة عاجزة محصورة بإثبات الوجود ومتلخّصة في أن النجاة بحدّ ذاتها مقاوَمة، ولا هي جماهيرية شعبية غير منظَّمة، وهي ليست مُدانة شعبيًّا ومعزولة مجتمعيًّا. ولهذه كلّها أمثلة عديدة في عُموم السينما الفلسطينية. المقاوَمة هنا منظَّمة ومسيطِرة ومحكَمة وسرّية، وهي قبل كلّ شيء غير متوقَّعة. فالأستاذ الذي بدا حكيمًا رزينًا هادئًا، يمنع طالبَه من مواجهة مباشرة مع جندي سلّمه أمرًا بهدم البيت، ولا أقول يتحوّل إلى مقاوم، بل يبقى على رزانته هذه واتّزانه، مستحضرًا إياها في الجانب الآخر للأستاذ الذي أُسِر ثلاث مرّات سابقة، وانضمّ للمقاومة سرًّا، ليخفي الجنديَّ في بيته، في محاولة لتحرير أَلف أسير فلسطيني مقابله.
الإعلان
فعلُ المقاومة هنا سابقٌ لأحداث الفيلم، سابق لدقيقته الأولى، ومستمرٌّ مِن بعدها، في مَشهد أخير نَجِد التلميذ فيه مواصلًا ما مارسه المعلّم. التحوّل في الشخصيات، الأستاذ وطالبه، كان بتقدّمٍ درامي محكَم، نقلات انعطافية برّر لها سياق القصّة، لا انفعال واستفعال لدى الشخصيات كانت في غير موقعها، بنَقلات تراجيديّة في حالات الشخصيات وظروفها، وهذا الصعود الدرامي وتناسقه مع سلوك الشخصيات وحواراتها، مهّد لما هو غير متوقَّع ليكون مقبولًا تمامًا لدى مُشاهده. ليست المقاوَمة التي مثّلتها شخصية الأستاذ مستقرّة في راهنها وممتدة في تاريخها وحسب، بل التنقُّل بما تتطلّبه الأحداث وتطوّرُها، باستقرارٍ لفعل المقاومة الدائمة خارج منطق ردّ الفعل الآني، مَنَحها موثوقية تفيد في أن المقاوِم المنظَّم والمحترف هو ذاته الحكيم والهادئ خارج الفعل المقاوِم. هذا كلّه حرّر الشخصية مِن مبالغات عاطفية مبتذلة تتكرّر في السينما الفلسطينية.
أتاح هذا الوعي لطبيعة الشخصية المقاوِمة، كتابةً وتصويرًا، للفيلم إدخال العنصر الإنساني متخللًا فعل المقاومة، منسجمًا معه، من دون مقايضات سياسية من خلال إنسانويّة تتكرّر كذلك في السينما الفلسطينية، فلم تكن البريطانية، امرأة غربيّة بيضاء تخلّص الفلسطيني مِن محنته. أتى حضورها في سياقه السّردي وضِمن حدوده، ولم يكن تصوير والدَي المخطوف الإسرائيلي الأمريكي، لضرورة اتّزانٍ إنسانوي يستجيب لهواجس وشكوك مموّلين ومبرمجين ومحكّمين ومُشاهِدين غربيين، بل كان لتعزيز مسألة الأسرى الفلسطينيين، تحديدًا في حوار قصير بين والد المخطوف والأستاذ، حين قال الأخير للأب إن المَخطوف سيَبقى حيًا، فلا يَقلق، وذلك لأن ابنًا واحدًا من الإسرائيليين يساوي أَلفَ ابن من الفلسطينيين.
يتأسّس الفيلم على فعلٍ مقاوِم مستقرّ تمارسه الشخصية الرئيسيّة، وهذا ما تستبعده السينما الفلسطينية المُنحازة إلى تَصوير المقاومة السالِبة (لا السلبيّة)، المقاوِمة بالنّجاة، والبقاء، المقاوِمة برد الضّربات وحسب. الشخصية الفلسطينية في "الأستاذ" تضرب ومن دون بطولة مفتعَلة، تقرّر بوعيٍ لا برغبة، تفعل لا يُفعَل بها، تذهب إلى حتفها بنفسها ولا تُدفَع إليه. يَخطف الفلسطيني هنا ويواصل الخطف، يقاوم لا لأنّ حدثًا بدأ بالفيلم وينتهي به قد حصل، بل لأن تاريخًا طويلًا يحيط بالقصّة، لأن حالةً سَبَقت الفيلم وتستمر من بعده، حاصلة. لذلك، يَختار الفيلم مشهدًا أخيرًا لا يمكن تلخيصه سوى بالقول إنّ فعل المقاومة إنْ كان فليكن محترِفًا، وليكن منهجًا مستمرًا.
عن "القدس العربي".




