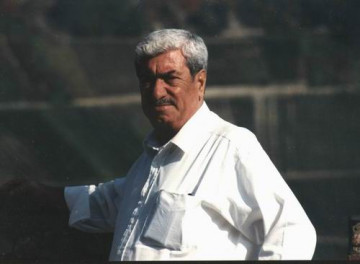في المدرسة: من الاغتراب إلى الانتماء

"في ظل غَرقي في حالة الاغتراب اليومي الذي ألتمسه بمجرد وصولي إلى هذا المكان، ثمة استجابات نفسيّة وسلوكيّة "للعَربيّ " هُنا، تشغلني... كالإحساس مثلًا في المحظوظيّة بمجرد التواجد هنا "في عالمهم" أو الشعور بشيءٍ من الامتنان تجاههم لتعاملهم بصفة انسان فقط، او كأن تعتقد بان ترددك بفعلٍ ما تجنبًا لإثارة الشكوك هو أمر اعتياديّ، وحتى تلك المحاولات المتكررة في إخفاء لفظ الحروف بمخارجها الصحيحة وتلازُمها مع الشعور الدائم في الحاجة لضبط اللكنّة لتبدو كلكنتهم، أو كأن تسمع حوارًا (بيّن عرب) فتطغى على مسامعك اللغة العبريّة وحتى أنك قد لا تشعُر بشيءٍ من الاستهجان، وكذلك الاحتفاء المبالغ فيه اذ نطق أحدهم مجرد كلمة في اللغة العربية أو إذ أبدى اهتمامًا بسيطًا بما يخُصنا، وأما عن أقبحها فهو تقديم التنازلات خوفًا على الصورة بأن تبدو متطرفة... إن في بعض هذه الاستجابات انعكاسا للنظرة الدونيّة لمكانة الثقافة واللغة، ومحاولات بائسة لاستجلاب القَبول، وقد يأخُذُ بعضها شكلًا من الذوبان اللاوعي، من البديهيّ أن ننسب هذه الاستجابات لواقعنا الصعب، وقد يبدو بعضها طبيعيًا ومتوقعًا تحت ظلِ الاحتلال وتحديدًا في سياقنا المُركب الذي تكسوه التناقضات وأَزمات الهويّات، ولكنّ المفارقة تكمُن في الوعي لهذه وبهذه الاستجابات وفي طريقة التعامل معها، والظاهر بأن نجاعة التعامل معها تتوافق طرديًا مع نسبة الوعي القومي والثقافي. بالمناسبة؛ كُلَّ ما هُنا ينكُرنا، من الألِف الى الياء، من اللغةِ الى العَلم وحتى الوجوه والأسماء، عافانا وعافاكم من التعايُشِ والاعتيّادِ والذوبان، وأما عن حالتي في الاغترابِ هذه، فهيَّ في معاجمنا انتماء. وزيّ ما بقولوا : للحديث خلفيّة وبقيّة".
منذ أن قرأت هذا المنشور (قبل شهرين تقريبًا) لإحدى الطالبات في إحدى الجامعات، وأنا أتراوح تارة بين الشعور بالغبطة لحالِ هذه الطالبة المتفوقة وبين الحسرة تارة أخرى لما في هذا المنشور من تجسيد لحال المجتمع عامة. كنت أتمنى أن هذه القدرات التعبيرية والتفكيرية واللغوية والتبصّر الذاتي والاجتماعي والوعي الذاتي والمجتمعي الذي أبرزته هذهِ الطالبة، هو ما تفرزهُ مدارسنا وتبنيه المناهج التعليمية فيها. لكن في الحقيقة يحكي الواقع قصة أخرى يظهر فيها الفلسطيني في إسرائيل بعد 12 سنة في المدرسة شخصًا هشًا سريع الانكسار ومتهرّب من إرثه، مع أنه قادر على تحقيق إنجازات تعليمية.
ليس جديدا تناول إشكالية منهاج التعليم في المدارس العربية كمصدرٍ لتنمية طالب مسلوب الفكر، والإبداع، ومشوّه الانتماء، والهوية. ولا يخفى أن الأمر يعكس سياسة غايتها المراقبة والسيطرة على المنهاج التعليمي خصوصا، والسيرورة التربوية عمومًا، في المدارس العربية. أضف إلى ذلك، إن تحديات المدارس العربية تناولتها أقلام الباحثين وتناقلها الساسة على امتداد تواجدها. مع كل ذلك لي في القضية حصّة، ومع ذلك لست بصدد تكرار ما قيل، وإنما أود الاشارة إلى نواحٍ أخرى في ذات الأمر، لم تنل نصيبها من الاهتمام والبحث. تتناول هذه النواحي جوانب في البنية المجتمعية وأخرى تصيب السياق السياسي.
كبرياء وانتماء وإبداع
واجب المدرسة الأول تعزيز انتماءنا الفلسطيني بكل مركباته الديني والثقافي واللغوي بكل تشعباته، على الرغم من الازدواج والتأزم والتضاد والصراع، وعلى الرغم من السيطرة والمراقبة والسياسات على امتدادها وتشعباتها. أتدركون حجم المصيبة حين يتبادل معلمي اللغة العربية مثلا رسائل نصية باللغة العبرية، أو هل تستوعبون هول الهزيمة لما تكتب معلمة رسالة عبر البريد الالكتروني بكلمات عربية لكن بأحرف عبرية، أو لماذا لا يعرف طالب جامعي متى حدثت "نكسة حزيران" وكم من الوقت استمرت؟ وهل تقدرون حجم النقص بمعانيه المتعددة عندما يتلعثم طالب وطالبة عربية في حوار متعدد حول تاريخه وحول النكبة وحول الحكم العسكري وحول مخيمات اللاجئين. ما يزيدنا الألم على الجُرح، هنالك من اقتنعوا "في ثلاثِ خرافات: 1) لغتنا العربية لا تواكب العلم والحضارة، 2) ثقافتنا هي جوفاء و"دقة قديمة" وأخيرًا، 3) ديننا أغلق أبواب الانفتاح على العالم الحديث والتقنيّة. لو يدرك طلابنا أن مهمّتنا هي الحفاظ على كبرياء وانتماء وابداع، ولن يكون هناك مجالًا لمثلِ هذهِ الخرافات.
صبيّة في الجامعة وشابّ في الشارع!
لست بصدد اثارة جدل حول القضايا الجندرية، مع العلم أن جذورها وتفرعاتها كلّها من مخلّفات النمو المتباين للبنات والبنين. في هذا الصدد أود لفت الأنظار على ظاهرة عزوف البنين عن التعليم الأكاديمي بالمقابل تسابق البنات عليه. في لغة الإحصاء، نحو 70% من بين الطلاب والطالبات العرب في المؤسسات الأكاديمية نجدهنّ إناث في حين أن فقط حوالي 30% هم من البنين (بحسب دائرة الإحصاء المركزية 2022). هذا الحال هو وليد العقود الثلاثة الأخيرة، خلالها حدث ارتفاع متزايد في نسب البنات في الجامعات مقابل انخفاض نسبة البنين. لنتخيل فقط أنها حاصلة على درجة الماجستير وهو بالكاد أنهى الصفّ العاشر. أليست هذه الفجوة مصدرًا لإضعاف المبنى الاجتماعي. هل للمدرسة دور في جسر الفجوة هذه؟
لا قيمة للتعليم في حياتنا!
لم يكن التعليم واكتساب المعرفة غاية، وإنما وسيلة لتحقيق الربح المالي، كما عند معظم مجتمعنا. هكذا كانت أحلام أمهاتنا أن نصبح أطباء او محامين او مهندسين، لأنها اعتبرت مصدرًا لكسب المال. لكن، لما ضعفت هذه المهن وباقي المهن الاكاديمية في تحقيق الربح المالي، فقدت من قيمتها لدى الشباب بالذات، فقلت نسبة الطلاب التي تذكر أهدافا أكاديمية في تطلعها للمستقبل، ويعلنون مع بداية المرحلة الثانوية، إن أهدافا أخرى حلت محل التعليم، ويصرحون "التعليم ما بستاهل" أو من يقول "لماذا أقضي سنوات في التعليم لأبحث بعدها عن عمل لا يمكنني العيش بكرامة". هل نمنح التعليم قيمة؟ هل للمدرسة دور في ذلك؟
المدرسة ليست منشأ العنف، ولكن محطّة نهايته
الدور الأساسي للمدرسة هو التغيير الاجتماعي، والمعلمات والمعلمين "وكلاء تغيير اجتماعي". مثلًا، قد يأتي إلى المدرسة طالب قد اكتسب طرقا سلبية للتعامل مع الآخرين، واجب المدرسة تغيير ذلك، واكسابه طرقا بديلة. بحيثُ يأتي الطفل إلى العالم ولا يملك سوى العدوانية وسيلة لتحقيق أهدافه (هكذا تحصل الطفلة على اللعبة من أختها)، ومن واجب البيت والمدرسة أيضًا توسيع مخزن سلوك الطفل ليشمل وسائل أخرى غير العنف، ليحقّق أهدافه. فلا يقتصر دور المعلمة على اكساب المعلومات وإنما أيضا اكساب المهارات. أيعقل مثلًا أن يصل الشابّ إلى 18 عامًا، ولا يعرف إلّا العنف وسيلة لتحقيق أهدافه؟ أيعقل أن تتنصل المدرسة من واجبها؟

د. سامي جمال محاجنة
محاضر في مجالي التربية وعلم النفس في الكلية العربية الأكاديمية "بيت بيرل"