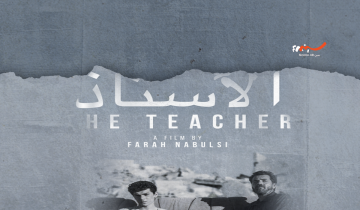الثّقافة في مُواجَهة الإبادَة

حين مَرَرتُ بالقرب مِن شجر الزيتون الذي حطّمته آليات الاحتلال قَبل عام، فوجئت بأغصان خضراء تنمو، ابتسمت، فقد انتصرت الأشجار/ الأبناء على الاحتلال بسهولة:
"إذا أنْتَ حَدَّقْتَ فيهَا قَرأْتَ حكَايتَنَا كُلَّهَا:
وُلدْنَا هُنَا بَيْنَ ماءٍ ونارٍ.. ونولَدُ ثانيةً في الْغُيومْ
على حافّة السّاحل اللاّزَوَرديّ بَعْدَ الْقيامَةِ.. عَمّا قليلْ
فلا تَقْتُلِ العُشْبَ أكثر، للْعُشبِ روحٌ يُدافعُ فينا عن الرّوحِ في
الأرضِ/
يا سيّد الخَيْل! عَلِّم حصانك أنْ يعْتَذِرْ
لِروحِ الطَّبِيعةِ عَمَّا صَنَعْتَ بأشْجَارِنَا:
آهٍ، يا أَخْتِيَ الشَّجَرَةْ
لَقدْ عذَّبوكِ كما عَذَّبُونِي
فلا تَطْلبي الْمَغْفِرةْ
لحَطّابِ أمّي وأمِّكْ.."
هذا ما خاطَب به محمود درويش على لسان "سياتل" زعيم دواميش في رائعته الخالدة: خطبة الهندي الأحمر: ما قبل الأخيرة، أمام الرحل الأبيض. لقد مرّت عقود على الإبادة، لكن لَم ينتهِ الأمريكيون الأصليون ولا ثقافتهم.
في فلسطين المحتلة، فإن شجر الزيتّون يعود ثانية، إنّه بَعث الفينيق، العنقاء، تلك معجزة فلسطين، وليست أسطورة أبدًا.
ماذا نَقول في الطفل الذي انقضّ جنود الاحتلال عليه، فأشبعوه ضربًا وركلًا "بالبساطير" الأمريكية وحواف البنادق المعدنيّة، وحين فتح عينيه أمام الكاميرات، ابتسم مِن خلال وجه اكتسى دمًا، ورَفَع علامة النّصر!
منذ وَعَت عيني، وأنا في اللاوعي والوعي أَشهَد مقاومة الاحتلال، من خلال الرّموز، تلك قِصص كثيرة يصعب إيرادها، لكنّ النّاظم فيها هو وعي الفلسطينيين لأهمية التشبّث بالهوية، والخصوصية الثقافية والرموز الوطنية.
حينَ استغرَبَ أحد جنود الاحتلال وجودَ عَلم فلسطين في مُطرَّزة جميلة أبدعتها الحاجة نعمة، أختي، قلتُ له ببساطة مشيرًا إلى عَلم الاحتلال، ما هذا؟ فأجاب علم دولة إسرائيل! قلت له ونحن شعب فلسطين ولَنا عَلم، فهل تتوقّع أن نَرفع عَلَمكم هنا؟ فأنهى المحتل العشريني الكَلام، لكنّه لم يُخف إعجابه بالمطرَّزة، فقلت له: هل تعلم كم عُمر تفاصيل هذه المطرّزة؟ فأشار بالنفي. قلت له: هذه عمرها آلاف السنين! وهنا خَرَج من البيت مطأطئ الرأس قائلاً: أنتم بيت مرتّب، ومضى.
كلّ وقصصه، لكن كيف لي أن أنسى احتفاظ أبي بزيّه الفلسطيني، وهو يَجتاز جموع المحتلين، غير آبه بهم، فوَرِثت ذلك، وكم تأثّرت بسلوكه حين رفض دخول أيّ مبنى حكومي بعد هزيمة عام 1967 عليه أيّ رمز للاحتلال، حتى ولو لغة عبرية.
قال أبي وكثيرون: سنغلبهم بهذا وهذا، مشيرين للكتب التي بين أيدينا والشّجر الذي أمامنا ونحن نجلس أمام البيت.
بالرغم من محاولات إبادتنا منذ عام 1948، وصولًا إلى حرب الإبادة على غزة، ونحن نزداد تجذرًا وقوة ثقافية وفنية، فنحن الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال ونسبة التعليم فيه تفوق دولة الاحتلال!
لَمْ نُبَد، وَلَن، فكلّ فلسطيني يصير أمة!
استعار محمود درويش في قصيدة "خطبة الهندي الأحمر: ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض" التي تضمّنها ديوان "أحد عشر كوكبا" (صدر عام 1992)، حالة الأمريكيين الأصليين، شعب القارة الأصلي، وهو هنا بذكاء يفرّق بين أمرين، قامت عليهما القصيدة. أما الهندي الأحمر فكانت خطبته الأخيرة بعد المعركة التي خسرها، وهو قد اعتاد أن يتحدّث عن استخلاصاته لقومه، كما روى درويش حين قدّم لقصيدته التي ألقاها. لكن محمود درويش، الهندي الآخر الذي ما زال يقاوم سيّد البيض، فكانت خطبته قبل الأخيرة، لا لأنه لَم ينهزم، بل لأنّه يثق بأن خطبته الأخيرة هي إعلان نصره على سيّد البيض!
ذلك في نظري هو دور الثقافة والفنون، فهُما وإن كانا أهم ما يميّزان الشعوب، مثل الشاهنامة للفردوسي، فإنهما يشكّلان ما يمكن تسميته بالدينامو، إن الثقافة والفنون رافعتان للشعوب، وهما باعثان للحياة، وهل كانت الثقافة والفنون في الحضارات جميعًا إلا أساس النهضة والحضارة!
لقد حاكى العبرانيّون الجدد العبرانيين القُدامى حين انهالوا على الرموز الثقافية القديمة مِن كنعان ويبوس، لكن يبدو أن فلسطين عصيّة على الإبادة، حيث أن غنى الثقافة والفولكلور يمتد على الأرض وفي داخل البَشر هنا، فكلّ ما يُحيط بهم، وكلّ ما يتعلّق بهم يصير ثقافة، كالزيت والزعتر والجدران الاستنادية في جبال فلسطين.
زعم الصهاينة أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهكذا كانت "الأرض الجديدة القديمة" رواية طوباوية نشرها مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرتسل عام 1902، أيّ بعد إعلان تأسيس الحركة الصهيونية عام 1987 بخمس سنوات.
"تحكي الرواية قصة فريدريش لوينبيرج، وهو شاب يهودي مفكّر مِن فيينا، انضمّ إلى أرستقراطي بروسي أمريكي يُدعى كينجسكورت في رحلة إلى جزيرة نائية في المحيط الهادئ. توقفا في يافا في طريقهم إلى المحيط الهادئ، ووجدوا فلسطين أرضًا متخلّفة ومعدَمة وذات كثافة سكانية منخفضة، كما بدت لهرتسل في زيارته عام 1898".
امتلأت الرواية بالمغالطات، ونَفَت وجود شعب فلسطين، وتتابع الصهاينة والمسيحيون الصهيونيون في إزاحة الفلسطيني من فضاء فلسطين، واستمر ذلك حتى الآن، إنّهم لا يروننا! ورغم ذلك، فإن فلسطين هي الأكثر حضورًا.
باختصار، ما فعله الصهاينة هنا كان فقط محاكاة لما فعله البيض في أمريكا: الإبادة، لكن ذلك لم يتحقّق، بل صارت فلسطين أكثر نضرة وجمالًا، وتجلّى ذلك بالطبيعة والزراعة والإبداع. دومًا كنت مقتنعًا بأن "كروم عنب بيت دقو.. وفلسطين" تنتصر بسهولة على الاحتلال، ودوما كنت أرى دواوين محمود درويش، وما أنجزه المبدعون هنا أسلحة في مواجهة الاحتلال.
"وكولومبوسُ الحُرّ يَبْحثُ عَنْ لُغةٍ لم يجِدْها هُنا،
وعَنْ ذَهبٍ في جَماجِم أجدادنا الطّيّبين، وكَانَ لهُ
ما يُريدُ من الْحيّ والميْتِ فينا. إذاً
لماذا يُواصلُ حَرْب الإبادَة، من قَبْرِه، للنِّهَايَةْ؟
ولَمْ يَبْقَ مِنَّا سِوَى زِينَةٍ للْخرابِ، وريشٍ خَفيفٍ عَلَى
ثياب الْبحيْرات. سَبْعونَ مليون قلْبٍ فَقأْت.. سيَكْفي
ويكْفي، لترْجع منْ مَوْتنا ملكًا فَوْق عَرْش الْزمانِ الْجَديد.."
هي القصيدة-الاستعارة، والرمز، التي تفسّر مواصلة حرب الإِبادة الفاشلة (غزة مثال ساطع من خلال الأدب الجديد الذي يظهر الآن)، تلك نبوءة درويش وتلك مقاومته.
كتب محمود درويش القصيدة قبل 33 عامًا، لكنّها تزداد حضورًا ونُضرة. وكذلك صِرنا أكثر بقاء من الاحتلال نفسه، الذي يُنهي نفسه بنفسه، وأمّا نحن فسنواصل الزراعة والغناء.