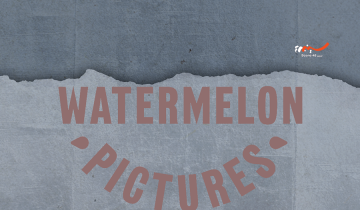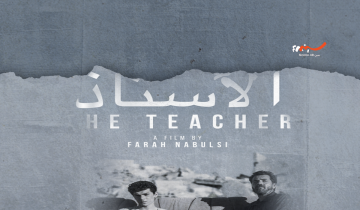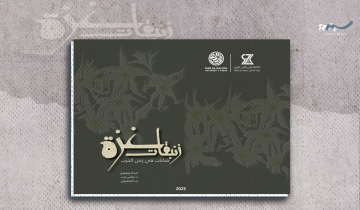السُلطَة تُلاحِق الخَيال في الدّاخِل الفِلسطيني مُنذ السّابع مِن أُكتوبر!
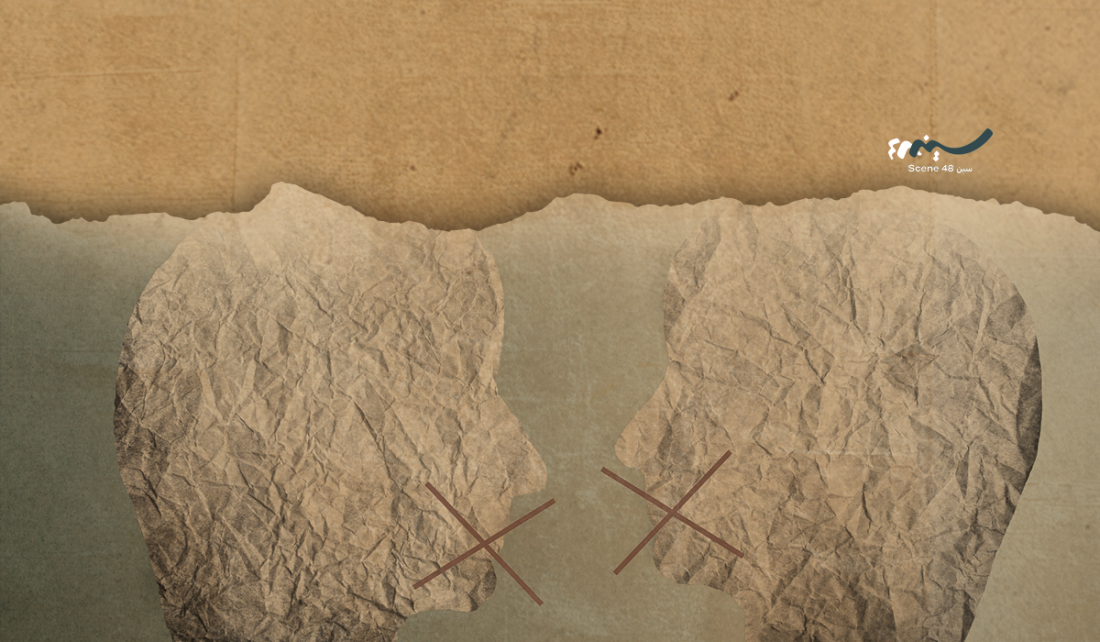
منذ السابع مِن أكتوبر، وفي ظلّ الحَرب على غزة واتّساع حالة الطّوارئ، يَشهَد المَشهد الثقافي في الداخل الفلسطيني استهدافًا ممنهَجًا وغَير مَسبوق. تَستخدِم الدولة، بأذرعها المختلفة؛ الأمن والقانون، كأدوات لإعادَة تعريف حدود الثقافة والفنّ بما يتماشى مع الرّواية الرسميّة، ليتحوّل التّعبير الثقافي والفنّي، بصوَرِه المختلفة، مِن فضاء حرّ إلى غَرَض مَشبوه يَجب معاينَته ومراقَبَته باستمرار. في هذا السياق، تتحكّم المنظومة الحاكِمة لا بأشكال التّعبير فقط، بل تقيّد أيضًا الخيال وتَستبق تحقّقه. ولَم تَعُد تَبِعات مَنع حدث فنّي مقتصِرَة على الحَدَث بحدّ ذاته، بل تهدف في جوهرها إلى ضبط الوعي الجماعي والتخيّل المشتَرَك.
مِن هنا، تَبرز الحاجة إلى مساءَلة مَعنى الفنّ وجدواه في زمن الإبادة - إن وُجدت جدوى. فما معنى التّعبير الفنّي والثقافي في ظلّ المَحو المستمر لكلّ أشكال الحَياة والوجود في غزة، حين يُسحَق المَعنى ويُهدر الدم؟ وحين يُمحى، بالتوازي، كلّ أثر للتّعبير السياسي عن الهويّة والرأي في الداخل الفلسطيني؟ عادةً، في فترات الطوارئ والقَمع، حين تَسود الرّقابة والمُلاحَقَة، يتحوّل الفنّ إلى ضَرورة؛ إلى بَديل سياسيّ، وأحيانًا الرافعة الوحيدة للرأي المناقِض في الفَضاء العام. كما يشكّل محاولة لاستعادة المَعنى نَفسُه للكلمات التي تُستخدَم، في الخِطاب الرَسمي، أَدوات للقمع، والقتل والتدمير. لكن، أحيانًا، حين تُطبِق الدولة ترسانَتَها الأمنيّة والقانونية بكامل أدواتها، لا لإغلاق المجال فحسب بل لسدّ أُفُق الخَيال، يُصبح الفنّ ليس أداة مقاومة فقط، بل طَوق نَجاة أخير، يمنع الفنان والإنسان مِن التحوّل إلى “شيء” خاضع ومسلوب الإرادة.
بَدت ملامح القَمع المتزايد جليّة منذ الأيام الأولى التي تَلَت السابع مِن أكتوبر، مِن خلال تصريحات السياسيين والمسؤولين، وبدأت مساحات التّعبير السياسي ضدّ الحرب تتقلّص حتى أصبحت شبه معدومة.
قبل هذا المُنعطَف، لعلّ الحدث الأبرز الذي كان الوسط الثقافي والفنّي يستحضره قبل السابع من أكتوبر، كان إغلاق مسرح الميدان في العام 2017 بعد سلسلة من الملاحقات الإدارية على ضوء عرض مسرحية 'الزمن الموازي'، وهي مستوحاة مِن حياة الأَسير وليد دقة. حينها، أَوقَفَت مؤسسات حكومية ورسمية تمويل المَسرح. لاحقًا، بعد تقديم دعوى للمحكمة، توصل المسرح والجهات المعنية إلى اتفاق يقضي باستمرار تمرير الميزانيات، إلا أن التمويل بدأ ينخفض بشكل تدريجيّ، حتى أغلق المسرح بشكل كلي لاحقًا. اعتبرت المؤسسة هذا الحدث انتصارًا لسرديّتها بمحاربة الفنّ 'غير الشرعي' و'المحرِّض'، واعتبر الفنانون الفلسطينيون ذلك شاهدًا على تبعات الملاحقة السياسية لأحد رموز المَشهد الثقافي.
إلا أنه وفي ظلّ حالة الطوارئ المستمرة منذ السابع من أكتوبر، تعمّقَت سياسات الإسكات وملاحقة المَشهد الثقافي لتتجاوز الحَدَث المذكور، كجزء مِن ملاحقة أيّ فكرة أو شعور جمعيّ ممكن أن تنتجُه تلك المَشاهد، في حملة كانت مصحوبة بخضوع تام لنوايا ومناشدات جهات يمينيّة محرِّضة.
فعلى سبيل المثال، في آب 2024، كان من المَنْوي إقامة عرض لفيلم 'جَنين جِنين' (2024) للمخرج محمد بكري في أحد فروع الحزب الشيوعي في حيفا، وكان من المفترض أن يشمل الحدث أيضًا حملة جمع تبرّعات ومساعدات إنسانية لغزة. أعقبت الدعوة للجمهور حملة تحريضيّة من جهات يمينية ضد الحدث ومنظّميه. بداية، ادّعت الشرطة أن الفيلم ممنوع مِن العرض وأن الحَدَث مخالِف للقانون، وأن إقامة حَدَث كهذا مِن شأنه أن يخلّ بسلامة الجمهور، وبناءً على ذلك اقترحت أن تُعاين الفيلم - لكن سرعان ما أوضح منظّمو الحَدَث أنّ الحديث يدور عن فيلم آخر للمخرج محمد بكري (جِنين جِنين (2002)) وأن لا صلاحية للشرطة لفرض رقابة كهذه على الفيلم. بعد ذلك ادّعت الشرطة أن المبنى لم يحصل على التراخيص اللازمة حسب قانون ترخيص المصالح (1968)، على الرغم من أن الحديث لا يدور عن مصلحة تجارية. لاحقًا، وفي اليوم نفسه المقرّر لعرض فيلم البكري، أصدرت الشرطة أمرًا بإغلاق فرع الحزب الشيوعي حتى صباح اليوم التالي، مما أدّى عمليًا لمنع عرض الفيلم. ويجدر بالذكر أن الشرطة لم تتخذ قرارًا شبيهًا يقضي بإغلاق فرع حزب سياسيّ منذ فترة الحُكم العسكري. بعد أسبوع، مُنِع عَرض الفيلم ذاته في مسرح السرايا العربي في يافا.
في قضيّة موازِية، طالت الملاحقة الفنان الكوميدي نضال بدارنة، بعد حَملة تحريض واسعة ضدّه على خلفية مقاطع فيديو ساخرة كان قد نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" قبل أشهر، ولم تُثِر في حينها أيّ دعوى قانونية أو مجتمعيّة. وكذلك كان الحال بالنسبة لعشرات العروض التي قَدَّم فيها المحتوى نفسه قبل اعتقاله. إلا أنّ تصاعد التّحريض مِن جهات يمينية أدّى إلى اعتقاله في شباط 2025، بتهمة “الإخلال بسلامة الجمهور” (התנהגות שעלולה להפר את שלום הציבור). هُنا، تَجدر الإشارة إلى أن هذه التّهمة تُستخدم بشكل واسع لتقييد حرّية التّعبير، دون الحاجة لتصريح مِن النّيابة العامة، ما يجعلها أداة مَرِنة لتجاوز الضّوابط القانونية المرتبطة بالتحقيق في تُهَم التّحريض. في حالة بدارنة، لم تُقدَّم أدلّة على وجود خطر فعليّ ناتج عن المواد المنشورة، وتم الإفراج عنه لاحقًا دون شروط تقييدية. وفعليًا كانت الرّقابة المفروضة ترتكز في جوهرها على تَفسير الشرطة والجهات المُحرِّضة لمحتوى العروض. بالتوازي، أُلغيت بعض عروضه بعد ضُغوط مارستها الشرطة على القاعات المستَضيفة، في خطوة تؤشّر إلى تنسيق غير مباشر بين التّحريض الإعلامي والسياسات الشرطيّة، بِهَدف عَزل الأصوات النقدية وتضييق الحيّز الثقافي. رغم ذلك، فإن الملاحقة الفعليّة لم تتوقّف. بعد فترة قصيرة، أَغلقت الشّرطة المَلَف ضدّ بدارنة. استمر بدارنة في تقديم عُروض جديدة بعد الإفراج عنه، لكنّ بعض المسارح والمؤسسات الثقافية الرسمية تمارس رقابة غير معلَنَة، وتَرفض استضافته تحت ذرائع إداريّة أو “اعتبارات حسّاسة”، في استجابة غير مباشرة لضغوط أمنيّة أو خوفًا من التّحريض العَلني.
في هذه الأمثلة وحالات أخرى كثيرة، استخدَمَت الشرطة والمنظومة القضائية أدواتها المختلفة للقَمع الجمعي والفردي في السياق الثقافي والفنيّ، ما يشير إلى تحوّل تدريجيّ في موقع الثقافة داخِل المَنظومة السياسية والأمنية، لتُخضَع لاعتبارات “السّلامة العامة” و”التّحريض” بمعانيها الواسعة، حتى دون وجود خطر فعلي أو مساسٍ مباشر بالقانون. حيث لا تقتصر الملاحَقَة على الأفراد أو على مَضمون معيّن، بل تُمَوضع كلّ إمكانية تعبير جمعي في مَوقع الهدف، سواء كان ذلك فنًا أو ذاكرة. لا يُمارس هذا النّوع مِن السّياسات دائمًا بشكل مباشر، إنما يتحقّق عَبر شبكة مِن الإجراءات القانونية، والضغوط المؤسسية، وآليات الرّدع المسبق. في ظلّ هذا المَشهد، يبدو المستقبَل غامضًا، لكن ما يتضح بشكل جليّ هو أن رقعة التّعبير في الداخل الفلسطيني تتقلص باستمرار، ما يحوّل الثقافة ذاتها إلى هَدَف أمنيّ، ليجعل مِن كلّ تعَبير موضِع شكّ.