اختِفاء الحَارَة: خَسَارات الطُفولَة في ظِلّ تَحوّلات الفَضَاء الفِلسطينيّ العَام

"عندما أَنوي الخُروج مع طِفلي، يعلو التساؤل: إلى أين سأذهب معه؟ على الأرجح سأضطر للخروج خارجَ البلد، لأن الترفيه هنا ليسَ مريحًا ولا آمنًا. إنه ببساطة مخيف". هكذا وَصَفت سعاد، الأم الشّابة مِن منطقة المثلث، واقعَ الحياة اليومية في بلدتها خلال مقابلة ميدانية أجريتُها معها. عندما سألتها عما يثير خوفها، أجابت دون تردّد:
"أولًا، هناك إطلاق نار طوال الوقت، رَصاصة طائشة لا تَعْرف أين ستُصيب. قبل أسبوعين، وبعد عودتنا من الغداء خارج البيت، وَجدنا رصاصتين في ساحة منزلنا! وفي مرّة أخرى وَجدنا رصاصة على السيارة. وإن لم يكن ذلك كافيًا، قبل يومين كنّا جالسين عند الجيران، نَشرب القهوة، وفي اليوم التالي أخبرَتني الجارة 'بعد لحظة من مغادرتكم أصابت رصاصة الطاولة حيث كنّا نجلس'".
واقع العنف وعشوائيّة انتشاره في بلداتنا لَه تبعات متعدّدة، إحدى أهمها تَبْرُز من خلال قضية محوريّة تمسّ حياة أطفالنا بشكل مباشر: اختفاء الحارة كفضاء اجتماعي آمن للأطفال والعائلات. فَلم تَعد الحارة التي كانت في الماضي ملعبًا وفضاءً تعليميًا ومساحة للتنشئة الاجتماعية موجودة في واقعنا المعاصر، يحمل تحوّله تداعيات عميقة على واقع الطّفولة الفلسطينية في الداخل.
الحارَة، فَضاء اجتماعي متحوّل
أسْمَع من أهالينا في البلدات والقرى حنينًا إلى ماضٍ عائلي ومجتمعي أكثر أمانًا. في الماضي القريب، كانت الحارة تنبض بالحياة والضّحكات، تتردّد فيها أصوات الأطفال وهم يلعبون كرة القدم وألعاب الحارة التقليدية، بينما يراقبهم الكِبار من شرفات المنازل أو أثناء جلساتهم المسائية. كانت الحارة أَشبَه بمدرسة حياة مفتوحة، يتعلّم فيها الصغار القِيَم والعادات عبر التفاعل اليوميّ مع أقرانهم، ومع مختلف الأعمار.
لَم تكُن الحارة مجرّد مكان جغرافي، بل كانت نسيجًا اجتماعيًا متكاملًا، حيث تتشارك العائلات المسؤولية تجاه بعضها البعض. كان بإمكان أيّ شخص بالغ توجيه طفل ونصحه دون حساسيّات، وكان الأطفال يتعلّمون احترام الكبار ومساعدة المحتاجين من خلال المشاهَدة والممارسة اليوميّة. سادت في هذا الفضاء الاجتماعي روح "الحارة الواحدة" المستندة إلى مبدأ "كلّنا مسؤولون عن بعضنا البعض"، وهو ما وفّر إحساسًا عميقًا بالأمان الجماعي وقلّل من الشعور بالخوف.
في المقابل، تغيّر المشهد اليوم بشكلٍ جذري. حيث تعكس عمليّة "اختفاء" الحيّز العام حاضرًا اجتماعيًّا متفككًا. أصبحت الشوارع والساحات العامة في المجتمع العربي مصدرًا لقلق الأهالي وخوفهم. علّ تصريح أحمد، ابن الخامسة والثلاثين: "لا أسمح لبناتي بالذهاب إلى محل البقالة بمفردهن، أذهب دائمًا معهن"، يختصر التحوّل الكبير في مفهوم الحارة وطبيعتها.
يَطال العنف في المجتمع العربي كلّ زاوية. قائمةُ الضحايا لا تَنتهي: رصاص طائش، مقتل سيدة في باحة منزلها، مقتل طفل في حديقة ألعاب وخطف آخر من أمام بيته، قتل فتاة في مقتَبَل العمر، شاب دُفن قريبًا من بيت عائلته، مقتل أم وأب، أخ وأخت... كأن الجميع "مَشروع موت محتَمَل" في ظلّ عشوائية العنف.
الخوف من الفضاء العام قلَّصه لدرجة انعدامه، أصبحَ الخوف دافعًا للانعزال داخل المَنازل، طبيعة هذا العنف العشوائية تَجعل الحياة في البلدات العربيّة أَشبَه بـ"محميّات المَوت" - وهو مفهوم محليّ يربط بين الحياة في البلدة العربية والحضور الفعليّ للموت.
الاقتصادي السّياسي وتَفَكّك الحارَة
تشير دراسات حول تأثير السياسات الاقتصادية في عَصر الرأسمالية المتأخّرة إلى أن هناك تراجعًا في دور الحيّ[1]كساحة للّقاء بين الناس، في مقابل صُعود التلفزيون ووسائل الإعلام الإلكترونية. اختفاء الأحياء نتيجةٌ مباشرة لما خَلَقته الرأسمالية المتأخرة من "سباق استهلاكي" يُضعف المجتمعات المحليّة. السّباق هو كالتالي: الناس يعملون بجهد أكبر ويكسبون المزيد من المال، لكن في الوقت نفسه ترتفع معايير الاستهلاك المجتمعيّة بوتيرة مماثلة، هذا يجعلهم أو يجعلنا جميعًا في سباق دائم يستنزف الطاقات الاجتماعية ويقلّل من الوقت المخصّص للتّفاعل المجتمعي. هكذا، بدلًا من استثمار الوقت في علاقات الحيّ، يقوم الناس في ظلّ الرأسمالية المتأخّرة "بشراء الوقت" من خلال الخدمات (التوصيل، العاملات المنزليّات، رعاية الأطفال)، مما يقلّل من فُرَص اللقاءات غير الرسمية في الحياة اليومية.
يتخذ هذا النمط التسابقي أبعادًا خاصة في السياق الفلسطيني مع تطبيق السياسات النيوليبرالية الإسرائيلية، التي وبرغم ما تضمّنته من ميزانيات للبنى التحتية والتعليم، فإنها تأتي ضمن منظومة اقتصادية تشجّع الخصخصة والفردانيّة وتُعزّز الاندماج في دوائر الاستهلاك. المفارقة أن هذه السياسات تؤدّي إلى تطوّر مَلحوظ في ثقافة الاستهلاك في المجتمع العربي، بالتّزامن مع تفشّي موجات العنف.
وكما لاحظتُ في دراستي الإثنوغرافية، فإن السّياسات النيوليبرالية تعزّز في الواقع إنشاء "محميّات" يعيش فيها الفلسطينيون كمجتمع متطوّر اقتصاديًا لكنّه خاضع للرقابة، حيث غالبًا ما يُشترط الدعم الحكومي بإنشاء مراكز شرطة بالقرب من البلدات، دون معالجة حقيقيّة للأسباب البنيوية للعنف والتهميش.
التّداعيات النّفسيّة والاجتماعية على الأَطفال
يَنشَأ أطفالنا اليوم في عزلة مضاعَفة؛ جدران البيت تحميهم من عنف الخارج، وشاشات الأجهزة تسلب منهم فُرصَة بناء ذاتهم الاجتماعية. إن اختفاء الحارة ليس مجرّد فقدان لمكان جغرافي، بل هو انهيار منظومة اجتماعية كاملة كانت تشكّل هوية الطفل الفلسطيني وانتماءه.
ثمّة تحوّل جَذري من طفولة كانت تتشكل في الفضاء العام المشتَرَك إلى طفولة محاصرة بين جدران المنزل، من مسؤولية جماعيّة في تربية الأطفال إلى عبء يقع حصرًا على الأسرة النووية. النتيجة؟ جيل يَفتقر للمهارات الاجتماعية، مَحدود العلاقات، مُثقَل بالمخاوف المتوارَثَة، وضعيف الارتباط بالهوية الجماعيّة. إننا نرى أمام أعيننا تفكّك النسيج الاجتماعي الذي كان يوفر للطفل الفلسطيني شعورًا بالأمان والانتماء، وهويةً متماسكة في مواجهة التحدّيات الوجوديّة.
نَحو إعادة بِناء المَساحات الاجتماعيّة الآمنة
يقدّم علماء الاجتماع مفهومًا جوهريًا في فهم أَزمَتنا: "المكان الثالث"[2] وهو فضاء اجتماعي يتوسّط المسافة بين المنزل والعمل والمدرسة، حيث ينسِج الناس علاقاتهم ويبنون مجتمعهم. إنها المَقاهي، السّاحات العامة، الحَدائق، ونوادي الحيّ - أو في السّياق الفلسطيني: الحارَة.
اختفاء الحارة كـ "مكان ثالث" هو بَتر للنسيج الاجتماعي الذي يَمنح المجتمع قوّته ويشكل هويّة أفراده. الحلول ليست ترفًا، بل ضرورة وجوديّة: استثمار في مساحات عامة آمنة، إحياء للنشاطات الحاراتية المشتركة، إشراك الأطفال في تصميم فضاءاتها ودعم المبادَرات المجتمعيّة. في عُمق الأَزمة، علينا أن نُدرِك أن مكافَحة العنف تبدأ باستعادة الفَضاء العام المفقود وإعادة بناء الثّقة المجتمعيّة من خلال "الأماكن الثالثة" التي عليها أن تُصبِح أولى أولويّاتنا، لتحتضن أطفالنا وتصون هويّتهم وحقّهم في النّمو والإبداع.
[1]تشير شور في كتابها "الأميركي المفرط في الإنفاق" إلى أن النظام النيوليبرالي أدى إلى تحول نمط الاستهلاك والتفاعل الاجتماعي، مما أضعف الروابط التقليدية داخل الأحياء السكنية. فقد أصبحت العلاقات الاجتماعية أكثر تسليعًا وأقل استدامة، وغالبًا ما يتم استبدال التفاعلات المجتمعية بأنشطة استهلاكية فردية. (Schor, J. B. (1998). The Overspent American: Why We Want What We Don't Need. Basic Books.)
[2]يعرّف أولدنبرغ وبريسيت "المكان الثالث" بأنه مساحة اجتماعية تقع بين المنزل (المكان الأول) ومكان العمل أو المدرسة (المكان الثاني). وتتميز هذه المساحات بكونها محايدة وغير رسمية وتساعد على تكوين هويات اجتماعية خارج نطاق العائلة والوظيفة، وتعزز شعور الانتماء للمجتمع والتماسك الاجتماعي. (Oldenburg, R., & Brissett, D. (1982). The Third Place. Qualitative Sociology, 5(4), 265-284. https://doi.org/10.1007/BF00986754)
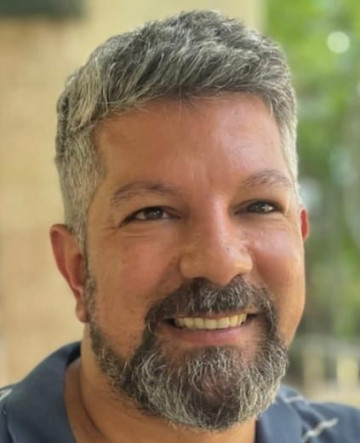
د. شهاب إدريس
حاصل على شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا، وباحث مختص في دراسة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. يتمحور بحثه حول الوالدية في المجتمع الفلسطيني في العصر النيوليبرالي، وتسلل ثقافة الاستهلاك والتغيرات التي طرأت على الأسرة والمجتمع بشكل عام، مع التركيز على التربية العاطفية، ومفاهيم الذات، والتصورات الأخلاقية، ورؤى الطفولة والوالدية. هذا المقال مستند إلى أطروحة الدكتوراه التي قمت بإعدادها، والتي تتناول بالتحليل العميق التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، وكيف تؤثر هذه التحولات على أنماط التربية والعلاقات الأسرية في ظل التحديات المعاصرة.



