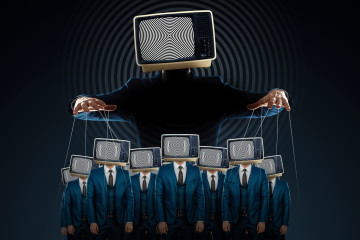لقاء العادات واللّهجات والعقليّات...

لقاء العادات واللّهجات والعقليّات وغيرها في وطننا الكبير - داخل القطر الواحد أو بين الأقطار - قد يكون نِعْمَة وقد يكون نَقْمَة على الأفراد والعائلات والمجتمعات. قد يُصبح طرفة تتناقلها الأجيال، وقد يُبقي لدى المرء مذاقًا مُرًّا لا يزول. سنبدأ إطلالتنا هذه بتناول الفطور مع البيروتيّة عنبرة سلام (1897-1986) والمقدسيّ أحمد سامح الخالدي (1896-1951) وبحضور عقد قرانهما، وسنُنهيها بحضور مراسم زفاف والدي المغربيّة ليلى أبو زيد (1950-)، وبالتعرُّف على علاقة أهل والدها البدويّ نصف الأمازيغيّ بأهل والدتها المدينيّة.
فطور القدس وفطور بيروت
كان اللّقاء الأوّل بين المقدسيّ أحمد سامح الخالدي (1896-1951) والبيروتيّة عنبرة سلام (1897-1986) بتاريخ 20 كانون الثّاني 1929 في بيروت، في بيت جوليا دمشقيّة، معلّمة عنبرة. هذا اللّقاء بين صبيّة وشابّ، وبمباركة أهل الصّبيّة، كان خارج المألوف في تلك الحقبة الزّمنيّة. اقتضى الأمر عدّة لقاءات بين أحمد، مدير الكليّة العربيّة بالقدس، وعنبرة، النّاشطة الاجتماعيّة الّتي عادت لتوّها من إنكلترا، حتّى اقتنعت عنبرة بشخص أحمد، شريك حياتها المستقبليّ. كان لا بدّ من فترة خطوبة. ووقع ذلك "المقلب" في أوّل زيارة للخطيب القادم من القدس لزيارة خطيبته في بيتها البيروتيّ. تكتب عنبرة: "ومن المفارقات التي حصلت في المرة الأولى لزيارة احمد لبيروت في اثناء الخطبة انه اتى لزيارتنا مرة فقال له اخي محمد وهو يودعه: "ننتظرك غدا على الفطور" فأجاب بالإيجاب".[1] أخال ذلك الشّاب المقدسيّ يتقلّب في فراشه البيروتيّ في تلك اللّيلة الباردة منتظرًا لقاء خطيبته. تروي عنبرة أنّ أحمد "اتى في صباح الغد الباكر فوجد البعض من افراد العائلة لا يزال نائما [...] فجلس في غرفة الاستقبال ينتظر حتى اتى البعض للترحيب به، ثم قدمت له القهوة وبعض وسائل الضيافة".[2] كان المقدسيّ في انتظار الفطور الموعود! لم يصل الفطور وامتدّت قعدته. تروي عنبرة: "ولما طال به المقام قدمت له القهوة ثانية".[3]طال ترقّبه وقهوة بعدَ قهوةٍ ولم يُقدَّم فطور! تكتب عنبرة عن أحمد في تلك اللّحظات: "لم يشعر بما يشير الى دعوته للطعام، فقرر ان يستأذن بالانصراف، فودعوه قائلين: "سنراك على الفطور ظهرا"".[4] وتضيف عنبرة: "عندها ادرك ان فطور بيروت ظهرا هو غير فطور القدس الصباحي".[5] وتجمل عنبرة إنّ أحمد "قد شرب مقلبا على الريق".[6] كيف تعامل الحاضرون مع الموقف، وهل كان مقلبًا عابرًا؟! تكتب عنبرة: "واندفع الجميع يتضاحكون وأصبحت النكتة عائلية دائمة بين فطور بيروت وغداء القدس".[7]
أحمد سامح الخالدي وعنبرة سلام
سَجِّل أنا عنبرة!
عُقد قران عنبرة سلام وأحمد سامح الخالدي في القدس في 9 آب 1929 "وذلك بحسب التقاليد المتعارفة بأن يكون العقد في مقر العريس".[8] حضر والدها وأخواها محمّد وصائب القران. لكن، كانت هناك عادة أخرى لم ترُق لهذه المرأة الثّوريّة، كما عرّفت نفسها، وعليها فقد ذاق العريس أحمد "عَلْقَة" جدّيّة من عروسه، علقة استحقّها، والبادي أظلم، كما يُقال. تؤكّد عنبرة: "وقد جاء في بطاقة الدعوة انها "بمناسبة عقد قران احمد سامح الخالدي على كريمة سليم سلام" مما اثار في نفسي غضبة انتقاد شديد لعدم ذكر اسمي، فأرسلت الى احمد كتابا مليئا بالعتاب لهذا الاهمال الموجه اليّ، وتساءلت هل من العيب ان يذكر اسمي؟".[9] لم ينتهِ العتاب هنا، وهي تضيف: "ألم يكن ممكنا ان لسليم سلام عدة بنات؟ فمن ايهنَّ سيتزوج احمد سامح الخالدي يا ترى؟".[10] كيف لرجل تربية مثل أحمد سامح الخالدي أن يُقْدِم على هذه الفِعلة الشّنيعة؟! كان لا بدّ له من الاعتذار واسترضاء عروسه! وكيف يعتذر؟ وكيف يسترضيها؟ اختار العريس الشِّعر، فقرّر نظم قصيدة. الخطأ كان فاحشًا، وبالتالي على القصيدة أن ترتقي إلى مستوى الاسترضاء المطلوب! وكيف يرتقي بقصيدته؟ التّفاصيل عند عنبرة: "وهكذا مما جعل احمد يسترضيني حالا بقصيدة لطيفة فيها الكثير من الدعابة، وقد عاونه عليها صديقه شاعر فلسطين الأول ابراهيم طوقان، فأزال جوها كل أثر لما شعرت به من عتب او غضب".[11] منذ ذلك اليوم أعطت لنفسها هذه المرأة الثّائرة الرّاضية اسم "عنبرة سلام الخالدي". أمّا بخصوص حياتها الزّوجيّة، فتؤكّد: "كان بدء حياتنا معا كما كانت نهايتها، سعادة دائمة وانسجاما تاما".[12]
قهوة عين غزال وقهوة صفد
للقهوة وعاداتها قصصٌ وحكايات في مجتمعنا، وإحدى هذه الحكايات وقعت مع تلميذ أحمد سامح الخالدي في الكلّيّة العربيّة في القدس إحسان عبّاس (1920-2003)، ابن قرية عين غزال السّاحليّة الفلسطينيّة. يكتب إحسان في "غربة الراعي" أنّه في العام 1941 "صدر القرار بأن أكون معلما في مدرسة صفد الثانوية، وهي مدينة لم أزرها من قبل، وأكاد لا أعرف عنها شيئاً".[13] وكان على ابن القرية الانتقال للسّكن في تلك المدينة الجليليّة. كما الكثير من الشّباب العرب الذّكور لم يكن إحسان يعرف "شيئاً كثيراً أو قليلاً من شؤون الطبخ، فقد رافقتني والدتي لتساعدني في ذلك، واستأجرت شقة في حي النصارى".[14] ويضيف: "وبعد أيام من استقراري في البلد جاء للتسليم عليّ عدد من أهل صفد".[15]عادة عربيّة جميلة ولفتة طيّبة من أهالي صفد. وكان لا بدّ أن يقوم هذا الشّابّ القرويّ الكريم بإكرام ضيوفه كما جرت العادة في قريته عين غزال. وبماذا يبدأ الضّيافة؟! يقول: "طلبت من والدتي أن تصنع لهم القهوة، وقدمتها أنا اليهم بعد وصولهم بقليل".[16] وماذا فعل أهل صفد بعد شرب القهوة؟ هل انتظروا بعض وسائل الضّيافة الأخرى أو الطّعام، كما انتظره المقدسيّ أحمد في بيت خطيبته عنبرة في بيروت؟ يؤكّد إحسان: "فما استقر بهم المقام الا دقائق، ثم قاموا وانصرفوا مودعين".[17] يقول إحسان في سلوك هؤلاء: "وعجبت لِمَ فعلوا ذلك [...]".[18] بعد أن استفسر عن الموضوع أتاه الجواب المفاجئ: "قيل لي إن العادة في المدينة الا تقدم القهوة إلا بعد أن يمكث الزائرون وقتاً، وتقديمها لدى وصولهم يعني ايذانهم بالانصراف، فقلت هذا عكس عادتنا في القرى، إذ تقدم القهوة للضيف أحيانا حال ان ينزل عن فرسه ويدخل الديوان. وأسفت لما حدث لكن بعد فوات الأوان".[19] كان إحسان - كما يؤكّد غير مرّة في سيرته - يتعلّم من أخطائه، وبعد حادثة القهوة كتب ما استخلصه منها: "إذن فأنا أحتاج الى أن أتعرّف الى أساتذة من أهل البلد وأفيد منهم بعض المعلومات عن العادات التي يراعيها أهل بلدهم ومنذ البداية أصبح مصباح الخليفة من أقرب الجلساء إليّ، وهو صفدي وقد أفدت كثيراً من صحبته وتوجيهاته".[20]
ما دمنا في سيرة أخطاء إحسان فسنبقى معه في حادثة أخرى.
ريفيٌّ يتوق أن يتمدّن
نعود إلى مرحلة طفولة إحسان عبّاس، فبعد أن أنهى الصّفّ الثّالث في مدرسة قريته عين غزال انتقل إلى حيفا لمواصلة دراسته فيها. الحكاية التالية التي يذكرها في سيرته وقعت معه عام 1935 قرب جامع الاستقلال في المدينة. يكتب في ذلك: "سأختم جولاتي حول جامع الاستقلال بحكاية تدل على مدى سذاجتي الريفية".[21] كان إحسان يرى في مدينة حيفا "كثيراً من الناس يضعون على عيونهم نظارات".[22] ويضيف: "وظننت أن ذلك من سمات التمدن".[23] إذًا، سيصبح هذا الرّيفيّ متمدّنًا. المسألة سهلة. يشتري نظّارة ويضعها على عينيه فيتحوّل في لحظة إلى متمدّن! وهكذا كان. اشترى نظّارة. يكتب عبّاس: "رأيت تحت إحدى قناطر الجامع السفلية رجلاً كبير السن يجلس إلى جانب صندوق ذي غطاء زجاجي اقتربت منه وسألته هل لديه نظارات ذات عدستين زجاجيتين".[24] كان لدى الرّجل ما يفتّش عنه الطّالب الرّيفيّ. اشترى عبّاس النّظّارة. اشتراها دون أن يُجرّبها! وبعد أن دفع ثمن النّظّارة يقول: "وضعت النظارة على عيني فلم أر شيئاً".[25] كيف شعر في تلك اللحظات؟ وكم خسر عبّاس في محاولته هذه لأن يصبح متمدّنًا؟ يقول في ذلك: "عندئذ أدركني الندم لأني خسرت قرشين كانا كل النقد الذي أملكه".[26] وبخصوص مستقبل النّظّارة ومستقبل تمدّنه يؤكّد: "ولما عدت رميت النظارة في سلة قمامة لأنها لم تستطع أن تجعل مني انسانا متمدنا ينظر إلى الدنيا من وراء زجاج".[27] سنبقى مع هذا الرّيفيّ الّذي لا يُمَلُّ من قصصه وصراحته.
.jpeg) |
|---|
إحسان عبّاس
ريفيّ في بيتِ أصحابه "الحيفاويّين"
في سنته الثّانية في حيفا تصادق إحسان مع الأخوين هنري وتوفيق الزيبق. يقول: "أصبحت أزورهما في بيتهما".[28] وجاءت الصّدمة، فيروي: "وفي مرة كنت في بيت آل الزيبق فرأيت فيه قزماً قصير الساقين [...]".[29] لا، لم تكن الصّدمة من شكل هذا الرّجل الّذي كان يتردّد على بيت آل الزيبق! يبدو أنّ إحسان كان قد استغرب من أمر تردّد هذا الشّاب على بيت صديقيه. يكتب: "فسألت هنري: لماذا يتردد هذا على بيتكم؟ فقال لي - دون أن يتلعثم - إنه يحب أختي، فصدمتني هذه الحقيقة، وفتحت أمامي باباً لفهم فرق شاسع بين ابن القرية والمدينة".[30] لم تكن تجارب إحسان كلّها بمثابة صدمات في المدينة.
السّينما والمسرح
إلى جانب الخذلان والصّدمات كانت لإحسان تجارب إيجابيّة في حيفا، ففيها انكشف على السّينما والمسرح. بخصوص المسرح يقول: "ولا أنسَ [...] حضور تمثيلية لاول مرة عن حياة الكتّاب الذي كان قبل ظهور المدرسة الحديثة، وضحكت كثيراً، ومن بعد جمعت عدداً من ابناء القرية واعدنا تمثيل المسرحية فكانت صورة جديدة في حياة القرية نفسها".[31] لحيفا أختٌ اسمها النّاصرة. سنزورها قبل أن ننطلق إلى مصر ولبنان والمغرب.
بِفَضْل اللّحاف والكشتبان
ذكرنا في إطلالة سابقة أنّ حنّا أبو حنّا (1928-2022) أطلق على نفسه اسم "يحيى"، الاسم العربيّ لحنّا، في سيرته الذّاتيّة "ظلّ الغيمة". يصف طفولته كما يلي: "مثل غيمة تنقّلت طفولة يحيى في سماء بلده [...] كان أبوه موظفا في دائرة "مساحة فلسطين" [...] والعائلة تنتقل مع الوالد من بلد إلى آخر ومن قرية إلى أخرى".[32] في أحد تنقّلاتها مع الوالد سكنت العائلة في النّاصرة، وكان لا بدّ من تسجيل يحيى في المدرسة. يكتب يحيى: "في اليوم الثاني للإستقرار في البيت الجديد سألت الأمّ والد يحيى عند عودته إلى البيت: "هل سجّلت يحيى في المدرسة؟"".[33] أجابها الوالد: "نعم، ولكن حكاية ذلك طويلة. رفضوا تسجيله، فالصفوف مكتظّة والسنة الدراسية في منتصفها".[34] لم يتنازل الوالد عن حقّ ابنه في التّعليم! وجد الطّريقة المناسبة. يقول الوالد: "ذهبت إلى بيت مدير المدرسة بعد الظهر دون موعد سابق".[35] ثمّ يضيف الوالد: "عرّفته على غاية زيارتي معتذراً عن التطفّل واقتحام البيت لشأن من شؤون العمل".[36]يبدو أنّ الاعتذار عن التّطفّل لم يكن السّبب في إقناع المدير بتسجيل يحيى في المدرسة! يشكّل الاعتذار المشهد الثّاني في لقاء الوالد بالمدير. يصف الوالد المشهد الأوّل بقوله: "قرعت الباب ففتح لي الرجل وفي يده كشتبان، وعلى أرض الغرفة لحاف مفروش وهو يبيّته. أحرِج الرجل".[37] خلال هذا اللّقاء القصير قال المدير لوالد يحيى: "تعال مع ابنك غداً لنسجّله".[38] أمّا بخصوص شعور الوالد وتحليله للموقف، فيكتب يحيى: "عاد الوالد راضياً وهو مقتنع قناعة ذاتيّة أن افتضاح المدير وهو يقوم بـ "أعمال النساء" كان العنصر الحاسم في رضوخه لتسجيل الصبي".[39]
٢.jpeg) |
|---|
حنّا أبو حنّا
اختلاف اللّهجات
كان إحسان عبّاس يعي اختلاف لهجة قريته عين غزال عن اللّهجة الحيفاويّة، ويقول في هذا الخصوص: "لم تكن لهجتي الريفية خفيفة على مسامع المدينيين".[40] قد يكون لقاء اللّهجات مصدرًا للاستهزاء أو حتّى للتّنمّر. في "قصة حياتي" يروي الطّالب أحمد لطفي السّيّد (1872-1963)، ابن قرية برقين الواقعة بمديريّة الدقهليّة في مصر، أنّه بعد أن أنهى الكتّاب في قريته أدخله أبوه عام 1882 إلى القسم الدّاخليّ في مدرسة المنصورة الابتدائيّة. وكيف تعامل بقيّة التّلاميذ مع لهجته المغايرة؟ يكتب في ذلك: "ولما اختلطت بزملائي التلاميذ شعرت بعد أيام بشيء من القلق؛ لأنهم كانوا يضحكون مني حينما أنطق القاف جافًا كأهل بلدتي!".[41]
٢.jpeg) |
|---|
أحمد لطفي السّيّد
بنطلون "غولف"
إذا كانت معاناة الطّالب أحمد لطفي السّيّد من موضوع اللّهجة، فقد عانى الطّالب اللّبنانيّ كمال الصَّليبي (1929-2011) على مستويات مختلفة عندما انتقل مع أسرته للسّكن في بيروت واضطُرّ إلى الانتقال من مدرسته "القديمة العائليّة الطابع في بحمدون [...] إلى مدرسة جديدة في بيروت خاضعة لنظم ثابتة [...]".[42] عن يومه الأوّل في المدرسة البيروتيّة يروي كمال في "طائر على سنديانة": "كنت مصطفّاً في الساحة مع زملاء لا أعرف واحداً منهم، ننتظر أستاذاً يتفقّد لياقتنا قبل بداية الدروس، والواقف إلى جانبي تلميذ أرستقراطي المظهر يلبس بنطلون "غولف" لم أرَ مثله من قبل".[43] دار حديث بين صاحب بنطلون الغولف الدّمشقيّ يوسف إيبش ورفيقه حسن حسني على مرأى ومسمع كمال. سأل حسن يوسف: "من أين لك هذا البنطلون الحلو؟".[44] جاوبه يوسف: "اشتراه أبي من لندن".[45] ويضيف كمال في وصف المشهد مع يوسف: "ثمّ أمسك بأطراف ذلك البنطلون، وأضاف وهو رافع إيّاها ليبيّن فخامة النسيج: "هيك بيلبسوا الإنكليز"".[46] يقول كمال إنّه في تلك اللحظات "نظرت خفية إلى بنطلوني "الكاكي" القصير مقارناً إيّاه ببنطلونه، ووددت لو تنشقّ الأرض وتبلعني. فأين ملابسي من ملابس الإنكليز؟".[47] عندها وجّه كمال انتقادًا لاذعًا إلى معشر الإنكليز ومَلِكِهم قائلًا: "كيف ذلك، وأنا الأجدر بأن ألبس ملابسهم نظراً لكوني من ملّتهم، وجورج السّادس، ملك إنكلترا، بمثابة الأب الروحي لجميع البروتستانت في العالم؟".[48] نعم، كان كمال بروتستانتيًّا. وهل كونه بروتستانتيًّا أسعفه في هذا الموقف؟! وهل نظر الإنكليز، وفي مقدّمتهم الملك جورج السادس، في شكوى ابنهم الرّوحيّ كمال؟! أشكّ في ذلك.
كمال الصَّليبي
للمعلّم دور "البطولة" في السّخرية
ما زال الطّالب كمال الصّليبي مصطفًّا في السّاحة. خلافًا لحالة أخيه أحمد لطفي السّيّد الّذي سخر أقرانه الطّلّاب من لهجته، فقد كان للمعلّم دور "البطولة" في الاستهزاء من كمال. يروي كمال: "جاء الأسوأ عندما وصل دوري للتفتيش، فوقف أستاذ صفّنا أمامي (وهو شاب أنيق اسمه جوفر حدّاد) يهزّ رأسه وكأنّ منظري لم يعجبه. تفقّد الأظفار من يديّ، فوجدها "مقرقطة"، وعليّ أن أعيد الاعتناء بها".[49] لم ينتهِ الأستاذ من انتقاداته: "وأشار إلى زِرّ في قميصي يكاد يفلت من مكانه قائلاً: "روح قول لأمّك تقطب لك هالزِرّ" وهو يعقد حرف القاف في "مقرقطة" و"قول" و"تقطب لك" وكأنّه يستهزئ بلهجة الجبل (التي يلفظ فيها حرف القاف فصيحاً)، معتبراً إيّاها لهجتي".[50] وجاءت لحظة فحص الشَّعر، ولا يزال الفاحص هو الأستاذ جوفر والشَّعر المفحوص هو شَعْر الطّالب كمال. يصف كمال ما قام به أستاذه: "انتقل بعد ذلك إلى معاينة شعري، فوضع يده على رأسي قائلاً: "مين قاصص لك هالقصّة عالقرميد؟"". ماذا يعني الأستاذ بكلامه هذا؟! يكتب كمال: "لم أفهم تماماً ماذا يعني "القصّ على القرميد"، بل جلّ ما فهمت هو أنّي ابن قرية محاط لأوّل مرّة بأبناء مدينة: لهم كامل الحق بأن يهزأوا من تصرّفاتي وهندامي، وعليّ أن أتكيّف مع واقعي الجديد".[51]
بيّاع الخواتم والبوظة والجرن
على ذكر اللّقاء بين اللّهجات تطرّق نجيب محفوظ (1911-2006) في "صفحات من مذكرات نجيب محفوظ" إلى موضوع اللّهجات قائلًا: "لدينا عدة لهجات من العامية. فتجد لأهل الصعيد لهجة، ولأهل الوجه البحري لهجة، وداخل البلد الواحد قد لا يفهم سكانه بعضهم بعضا بسبب اختلاف اللهجات المحلية".[52]ويعطي نجيب مثالًا على لقاء اللّهجات بين لبنان ومصر، فيكتب: "وأذكر أن فيلم "بياع الخواتم" بطولة فيروز ترجم إلى اللغة العربية الفصحى عندما عرض في القاهرة بسبب صعوبة اللهجة المحلية اللبنانية بالنسبة للمشاهد المصري".[53] وتناول اللّبنانيّ مارون عبّود (1886-1962) هذا الموضوع في كتابه "في المختبر" الذي تطرَّقَ فيه إلى سيرة أحمد أمين "حياتي"، فكتب: "إن لأحمد أمين مقامًا ساميًا في نفسي، وقد قدرت جهاده قبل أن أقرأ كتابه في سيرة حياته، فكيف بي الآن وقد رافقته في جميع مراحل السن، أطال الله مدته وبارك في عمره!".[54] كان لدى مارون مأخذ واحد على سيرة "حياتي" لأحمد أمين: "وما أسفت لشيء في هذا الكتاب إلا لأن الأستاذ الجليل لم يشرح لنا بعض الفاظ محلية، مثل البوظة والجرن وأشباههما؛ لأننا لا نستطيع فهمها لاختلاف مدلولها بين الأقطار، ولعل الأستاذ يفعل ذلك عندما يعيد طبع كتابه النفيس".[55] وهل يمكن لمارون عبّود أن ينهي كلامه دون طرفة أو سخرية، فيكتب: "جزى الله الأستاذ الأمين صالحة، ووقاني وإياه غدرات السكَّري".[56]
-jasy83.jpeg) | -eacswz.jpeg) |
|---|
مارون عبّود ونجيب محفوظ وأحمد أمين
الزّوجان البدويّ نصف الأمازيغيّ والمدينيّة... وأهلهما
تروي المغربيّة ليلى أبو زيد (1950-) في "رجوع إلى الطفولة" قصّة زواج والديها. كان والد ليلى بدويًّا "من بني ملال وهي مدينة عربية يقال إن اسمها تحريف لبني هلال، القبيلة العربية المعروفة التي نزحت إلى شمال إفريقيا".[57] وكانت أمّه أمازيغيّة. خلال عمله كمترجم بين العربيّة والأمازيغيّة التقى والدها "رجلا من صفرو، وأعجب بطريقة عيش المدينيات، فطلب منه أن يزوجه من بلدته، فوجد له أخت زوجته، أمي، وهو شيء خارق للعادة".[58] تفسّر ليلى هذا الشّيء الخارق بوصفها لأهل صفرو قائلة: "وكان يطغى على أهلها شأن الأندلسيين شعور حاد بالشوفينية والنفور من الأجنبي، فلم تكن تزوج بناتها للأجانب، ناهيك إن كانوا أمازيغا أو بدوا".[59] وبخصوص وضع والدها من هذه الناحية فتقول: "كان والدي متعلما وموظفا ولكنه كان أجنبيا وبدويا".[60]إذًا، ما السِّرّ في قبول أهل أمّها بأبيها البدويّ نصف الأمازيغيّ زوجًا لابنتهم؟! تكتب ليلى: "وإذا كانوا قد قبلوه فذلك لأنها كانت مطلقة بطفلة".[61]
ليلى أبو زيد
اختلاف البيت واختلاف النّظرة...
وُلِدت ليلى أبو زيد وكبرت وأصبح في مقدورها وصف بيت جدّيها وطريقة حياة كلّ من البيتين ونظرتهما الواحد تجاه الآخر. عن أُسْرة والدها تقول: "كان من أسرة مرموقة من حيث الوضع الاجتماعي لا من حيث الغنى، وإن كان الإسراف البدوي الذي يجعل جاه المرء فيما يستهلكه، لا في الإطار الذي يعيش فيه".[62] ولا بدّ لموضوع الإسراف أن يدخلنا في قضايا الكرم والبخل! قبل أن نخوض في هذا الموضوع سنتوقّف عند وصف ليلى لبَيتَي جدّيها. تكتب: "كان في بيت جدي لأبي ملاحف وحنابل بدوية، وحصر وقدور طين [...]".[63] وتضيف: "وكان في بيت جدي لأمي موائد ومطارف صوف، ووسائد مخملية مزينة بحواشي الحرير والأهذاب [...] وخزائن ورفوف منقوشة، عليها زبيدات من خزف فاسي عتيق".[64] بيتان مختلفان كلّ الاختلاف. وعقليّتان وعادات... وليت الاختلاف لا يفسد للودّ قضيّة في هذه القضيّة! لكنّه يُفسد! لا بدّ من إطلاق الأحكام! تؤكّد ليلى: "وكان أهل أمي يسخرون من أهل أبي ويقولون: "بدون لحم لا يأكلون"، "قالب سكر في اليوم"، "همهم في بطونهم وفروجهم"".[65] لم يقف أهل أبيها مكتوفي الأيدي في هذا التّناحر، فيرُدّون النّار بالمثل: "وكان أهل أبي يسخرون من أهل أمي ويقولون: "المديني، الزليج والرخام والشح والتقتير. كل شيء عندهم مصغر، البويضة والخبيزة و... أسيدي ناكل ونشرب والرجا ف الله"".[66]
أَدركَنا الوقت ولا يزال في جعبتنا الكثير عن اللّقاءات على صعيد الدّيانات والمذاهب والمعتقدات والفكر. نتابع الموضوع في الإطلالة القادمة. سنزور اللبنانيّين حسين مروّة (1908-1987)، حين سكن وعائلته في العراق، وأنيس فريحة (1902-1993) الّذي كتب: "مساكين نحن الذين نُعنى بقضايا الفكر والأدب!"[67]. كما سنطلُّ على طبيعة العلاقات بين بعض مثقّفينا مختلفي العقيدة والمذهب والميل في "عصر النهضة العربية الحديثة"[68] كما أسماه عبّاس محمود العقّاد (1889-1964). سيحدّثنا في هذا السّياق توفيق الحكيم (1898-1987) عمّا حدث بين الصّديقين الصّدوقين، أَلدّارْوِنِيِّ شبلي شميّل (1850-1917) والمؤمن بوجود الله حافظ إبراهيم (1872-1933)، خلال حضورهما أمسية غنائيّة. وفي سياق الاختلاف، سنستمع إلى شهادة ميّ زيادة (1886-1941) عن طبيعة العلاقات بين بعض المثقّفين الّذين شاركوا في مجلسها الأدبيّ "النّدوة".
ألقاكم/نّ بخير.
[1] . سلام الخالدي، عنبرة. (1978). جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت: دار النهار للنشر. ص 176.
[2] . المصدر السابق. ص 176-177.
[3] . المصدر السابق. ص 177.
[4] . المصدر السابق. ص 177.
[5] . المصدر السابق. ص 177.
[6] . المصدر السابق. ص 177.
[7] . المصدر السابق. ص 177.
[8] . المصدر السابق. ص 176.
[9] . المصدر السابق. ص 176.
[10] . المصدر السابق. ص 176.
[11] . المصدر السابق. ص 176.
[12] . المصدر السابق. ص 175.
[13] . عبّاس، إحسان. (2006). غربة الراعي: سيرة ذاتية. الإصدار الثاني. عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع. ص 145.
[14] . المصدر السابق. ص 145-146.
[15] . المصدر السابق. ص 148.
[16] . المصدر السابق. ص 148.
[17] . المصدر السابق. ص 148.
[18] . المصدر السابق. ص 148.
[19] . المصدر السابق. ص 148-149.
[20] . المصدر السابق. ص 149.
[21] . المصدر السابق. ص 84.
[22] . المصدر السابق. ص 85.
[23] . المصدر السابق. ص 85.
[24] . المصدر السابق. ص 85.
[25] . المصدر السابق. ص 85.
[26] . المصدر السابق. ص 85.
[27] . المصدر السابق. ص 85.
[28] . المصدر السابق. ص 52.
[29] . المصدر السابق. ص 52.
[30] . المصدر السابق. ص 52.
[31] . المصدر السابق. ص 48.
[32] . أبو حنّا، حنّا. (2001). ظلّ الغيمة: سيرة. بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر. ص 18.
[33] . المصدر السابق. ص 60.
[34] . المصدر السابق. ص 60.
[35] . المصدر السابق. ص 60.
[36] . المصدر السابق. ص 60.
[37] . المصدر السابق. ص 60.
[38] . المصدر السابق. ص 60.
[39] . المصدر السابق. ص 60.
[40] . عبّاس، إحسان. (2006). غربة الراعي: سيرة ذاتية. الإصدار الثاني. عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع. ص 45.
[41] . السيد، أحمد لطفي. (2013). قصة حياتي. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. ص 9.
[42] . الصَّليبي، كمال. (2002). طائر على سنديانة: مذكّرات. عمان: دار الشروق. ص 81.
[43] . المصدر السابق. ص 81.
[44] . المصدر السابق. ص 82.
[45] . المصدر السابق. ص 82.
[46] . المصدر السابق. ص 82.
[47] . المصدر السابق. ص 82.
[48] . المصدر السابق. ص 82.
[49] . المصدر السابق. ص 82.
[50] . المصدر السابق. ص 82.
[51] . المصدر السابق. ص 82.
[52] . النقاش، رجاء. (1997). صفحات من مذكّرات نجيب محفوظ. دار الشروق. ص 66-67.
[53] . المصدر السابق. ص 67.
[54] . عبود، مارون. (2021). في المختبر: تحليل ونقد لآثار الكتَّاب المعاصرين. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 68.
[55] . المصدر السابق. ص 68.
[56] . المصدر السابق. ص 69.
[57] . أبو زيد، ليلى. (2007). رجوع إلى الطفولة. الطبعة الثامنة. الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع المدارس. ص 15.
[58] . المصدر السابق. ص 16-17.
[59] . المصدر السابق. ص 17.
[60] . المصدر السابق. ص 17.
[61] . المصدر السابق. ص 17.
[62] . المصدر السابق. ص 16.
[63] . المصدر السابق. ص 13.
[64] . المصدر السابق. ص 13-14.
[65] . المصدر السابق. ص 14.
[66] . المصدر السابق. ص 14.
[67] . فريحة، أنيس. (1988). سوانِح منْ تحت الخرّوبة. بيروت: جَرّوس برس. ص 133.
[68] . العقاد، عبّاس محمود. (2014). رجال عرفتهم. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 149.
الصور المرفقة: استخدمت بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات ل [email protected].

د. إلياس زيدان
محاضر في مجالي القيادة التّربويّة وتنمية منظّمات المجتمع المدنيّ. مستشار تنظيميّ ومخطّط إستراتيجيّ.