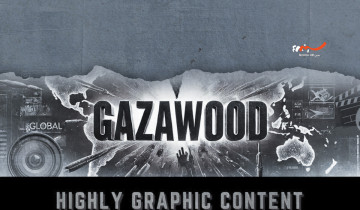مَن أَنا؟ عِلْمُ الهويّة بَين الجينات والذّاكِرة والمَكان
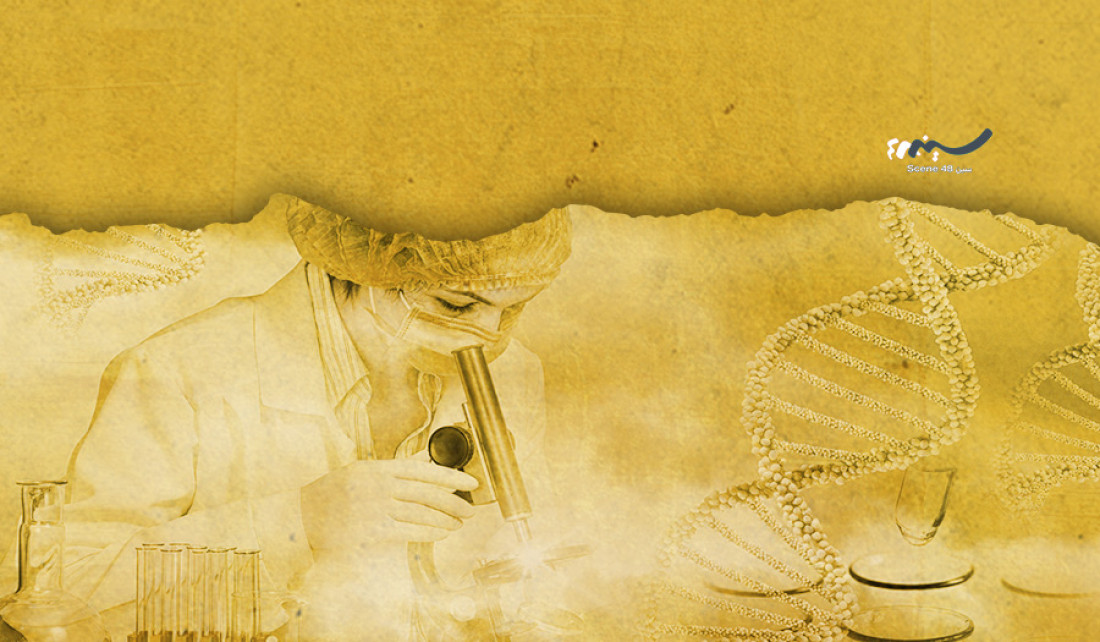
في إحدى الجلسات مع أصدقاء من خلفيّات متعدّدة، كان النقاش بسيطًا في بدايته: كيف نُعرّف أنفسنا؟ ما هي الهوية؟ وُلد بعض الحاضرين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجِرَين، والبعض الآخر وصل إليها في مرحلة متأخّرة من حياته، بعد أن عاش تجارب الحرب أو الغربة أو التهجير. السؤال الذي طُرح لم يكن جديدًا: "مَن أنا؟"، لكن طريقة الإجابة عنه انقسمت بشكل واضح:
فريقٌ رأى أن الهوية تولَد معنا، محفورةً في الحمض النووي، نحملها أينما ذهبنا، ونعود إليها حتى إن تعلّمنا لغات جديدة أو اكتسبنا عادات مختلفة. وفريقٌ آخر رأى أن الهوية تُبنى بمرور الوقت، وأن لكلّ شخص الحقّ في اختيار هويّته، وأن الأطفال لا يولدون بهوية جاهزة، بل تُبنى هويّتهم مع الوقت، ويمكن أن تتغيّر بتغيّر البيئة، والعقائد، والتفكير، وغير ذلك.
أَيقَظ هذا النقاش الذي بدأ عفويًا في داخلي سلسلة من التساؤلات العلمية العميقة: هل الهوية بالفعل تُختزل في الجينات؟ أم أنها نتيجة معقّدة للتجربة، والبيئة، والذاكرة؟ وهل يمكن أن تنتقل صدمة الحرب بيولوجيًا لأطفال لم يعيشوها؟
أُحاول في هذا المقال، تقديم قراءة علميّة لفهم الهوية، من منظور عِلم الأعصاب والوراثة.
مِن منظور عِلم النفس العصبي، يتكوّن الإحساس بالهوية من مستويات عدّة. تبدأ بما يُعرف بـ"الذات البيولوجية"، أيّ الإحساس بالجسد والزمان والمكان، ثم تتطوّر إلى "الذات السرديّة"، أيّ كيف نروي قصّتنا لأنفسنا وللآخرين. وقد أظهر العالم أنطونيو داماسيو في أبحاثه أن الهويّة تتطلّب وجود ذاكرة، وأن الإنسان الذي يَفقد القدرة على تذكّر ماضيه، يَفقد أيضًا الإحساس بـ "من هو".
ووفقًا لنظرية إريك إريكسون، فإن الهويّة تتشكّل عبر التجربة والتفاعل مع البيئة، وهي عملية مستمرة مدى الحياة، وتتحقّق حين يستكشف المرء قِيَمه ومعتقداته، ويَختار منها ما يناسبه.
هناك أبحاث عديدة عن التَوائم المتطابقة وغَير المتطابقة، الذين تَم فصلهم وتربيتهم في بيئات مختلفة. من أَشْهَر هذه الأبحاث تجربة مينيابوليس للتوائم المَفصولة، التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي بقيادة Thomas Bouchard وآخرين، وشملت نحو 100 إلى 137 زوجًا من التوائم (متطابقة وغير متطابقة) تم فصلهم عند الولادة وتربيتهم في منازل مختلفة. أظهرت النتائج أن للجينات تأثيرًا على تشكيل نحو 70% مِن الشخصيّة (التفضيلات، والطباع، والمواهب، والعادات، ونسبة الذكاء، والصحة النفسية وغيرها)، مقابل 30% تُعزى لتأثير البيئة، والتي تؤثّر في الآراء السياسية، والقَناعات، والمبادئ، والاعتقادات الدينية، والتجارب الفرديّة، وغير ذلك.
استنادًا إلى هذه الأبحاث، فإن الوراثة تضع الأساس، والبيئة تشكّل التفاصيل؛ بمعنى أن هناك تفاعلًا مستمرًا بين الجينات والبيئة.
انتشرت في السنوات الأخيرة شركات تحدّد أصلَ الشخص عن طريق فَحص جيناته باستخدام عيّنة مِن اللّعاب. فكيف نستطيع أن نُحدّد أَصلنا من خلال جيناتنا؟ وهل يحمل حِمضنا النووي أصولَنا وأصولَ أجدادنا؟
الأصل من الناحية الجينيّة ليس الجنسيّة أو جواز السَفر، بل يُقاس من خلال اختلافات جينيّة صغيرة تُعرف بـSNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)، وهي تغييرات ثابتة في حرف واحد من الشيفرة الجينيّة. تنتشر هذه الاختلافات بنسب مختلفة حسب المناطق الجغرافية التي أتى منها الأشخاص، وتُورّث من الأهل، ولا تتغيّر بتغيّر البيئة أو مرور الزّمن. فهي تُنقل وراثيًّا، وليس بيئيًّا.
لكن في العلم الحديث، وتحديدًا في مجال الوراثة فوق الجينيّة ((Epigenetics، نرى أن السمات الجينيّة وإن كانت موروثة، إلا أن البيئة تؤثر في تفعيلها أو تعطيلها. فعلى سبيل المثال: قد نَرِث (SNP) يُعرّضنا لخطر الإصابة بالسكري، لكن إذا حافظ الشّخص على نظام صحيّ ومارس الرياضة، فقد يَمنع تفعيل هذا الجين، ويُقلل من خَطر الإصابة بالمرض.
في دراسة علمية حديثة نُشرت عام 2025 بالتعاون بين جامعة ييل وجامعة الهاشمية في الأردن، تم تحليل التغيّرات الوراثية لدى ثلاثة أجيال مِن العائلات السورية التي عاشت الحرب (عام 1982 وعام 2011). وكانت المفاجأة أن الأطفال الذين وُلدوا بعد انتهاء الأحداث لم يكونوا بمنأى عن آثارها؛ فقد ظَهَرت لديهم علامات بيولوجية موروثة تشير إلى التوتّر والضغط النفسي. وأوضحت الدراسة وجود تغييرات في الوراثة فوق الجينيّة، وهي تعديلات لا تغيّر تسلسل الـDNA، لكنها تغيّر طريقة تفعيله. وقد ظهرت هذه التغييرات في 35 جينًا تتعلق بآليات التوتّر والقلق، وحتى تسارع الشيخوخة.
اقتباسًا من البَحث:
"لقد أثبَتنا أن التعرّض للعنف والصَدمات النفسية لا يؤثر فقط على من عايشوا الحدَث، بل يمتد إلى الأجيال القادمة من خلال التغيّرات في الـDNA، وهو ما يجعل الصّدمة النفسية إرثًا بيولوجيًّا أيضًا".
في دراسة أخرى على أطفال سوريين لاجئين في لبنان، وُجد أن بُنْية الجينات المسؤولة عن التعامل مع التوتر قد تغيّرت لديهم أيضًا، مما قد يُفسر ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى بعضهم، حتى في بيئات مستقرة نسبيًا. لم يعيشوا الحرب مباشرة، لكنّهم يحملون بصماتها في أجسادهم.
في السّياق الفلسطيني، هناك دراسات أكاديمية عدّة تؤكد أن هويّة "النكبة" تُنقل عبر الأجيال، ليس فقط من خلال السّرد الثقافي، بل تمتد آثارها إلى مجالات نفسيّة وبيولوجية تشمل الذاكرة، والجهاز العصبي، والاستجابة للضغوط.
بمعنى آخر: الهويّة قد تحمل في داخلها أثرًا بيولوجيًّا لذكريات لم نختبرها مباشرة، لكنها انتقلت إلينا من آبائنا وأمهاتنا، خاصة إذا نشأوا في ظروف حرب مُزمِنة.
في عالم يتغيّر باستمرار، وتُفرض فيه الهجرة والشتات والصدمات أحيانًا قسرًا، تصبح معرفة الذات ليست رفاهية فكريّة، بل أداة للبقاء.
أن تعرف مَن أنت، ومِن أين أتيت، وما الذي تحمله داخلك من تجارب وذاكرة وثقافة، هو شَكل من أشكال القوة.
الإنسان الذي يدرِك هويّته، حتى وإن كانت مركّبة أو مؤلمة أو غير مكتملة، يكون أكثر قدرة على بناء حياته، ومواجهة صدماته، وتربية جيل جديد لا يهرب من جذوره، بل يفهمها ويُعيد صياغتها.
أما من يتنكّر لهويته، أو لا يعرفها، أو يشعر بالخجل منها، فإنه غالبًا ما يفتقد إلى الاستقرار الداخليّ، ويعيش في صراع دائم مع الذات.
الهوية ليست سجنًا، بل مرآة نحتاج أن ننظر فيها بصدق — لأنها تمنحنا الاتجاه، والاتزان، والكرامة.

د. تالا خازن
مختصة في علم الدماغ، وباحثة في تأثير العَوامل الخارجيّة على تطوّر الدّماغ في فترة الطفولة.