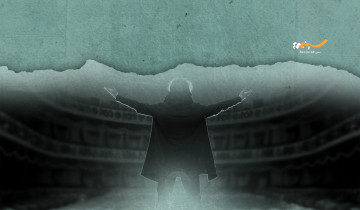كَيفَ يُجيب فِلِسطينيّو الدّاخل عن سُؤال: where are you from?

الصّراع بين حُبّ الوَطَن، وتَعريف الذّات، والّلباقَة السِياسِيّة
صَمَتَ! مرّت ثانية، ثانيتان، أربع. عليه الإجابة عن السؤال! صمتُهُ غريب على السائل.
"مِن أين أنت؟". ما أبسَطَه من سؤال! الفرنسي يجيب "فْغانْس" (فرنسا بالفرنسية)، الإيطالي "إيطالي" (باللكنة الإيطالية)، الأميركي "يو.اس.ايه" (الولايات المتحدة الأميركية بالإنجليزية)، والألماني "جيرماني" (ألمانيا)، وحتى الإسرائيلي يُجيب "إيسغائيل" (إسرائيل).... وحين يُسأَل فلسطينيّو الداخل، تتعدّد الإجابات، وَتَطول، منها:
إجابات تتنصّل من التاريخ
"أنا عربي إسرائيلي". الأصل الفلسطيني مَخفي أو مَمحي، وكأنّ العروبة أصبحت قومية.
"أنا من إسرائيل". تتعدّد الأسباب الواقفة وراء هذه الإجابة، مِنها التنصّل مِن الأَصل والانصهار مع المؤسَّسة الحاكمة، ومنها الالتزام بالأوراق الرسميّة، خصوصًا في أماكن رسميّة كالعمل والمطارات.. إلخ. عادةً ما يَستغرِب السائل من اللغة العربيّة، فيسأل عن ذلك بفُضول فتطول الإجابة.
إجابات كَشَجر الزيتون
"أنا من فلسطينيي الداخل؛ حامل جواز السَفر الإسرائيلي، أجدادي ممن بقوا في البلاد ما بعد ١٩٤٨". وتَكثُر الخلافات حول التّسمية: عرب الداخل، عرب الـ ٤٨، عرب النكبة.. إلخ.
"أنا من فلسطين". وهنا إمّا يتمنّى الشّخص إنهاء الحديث عن الأصل أو يتابع الشّرح والتّعليم والتّنوير حول أراضي فلسطين ما قبل النكبة. يتعلّق الأمر بِمَن هو السائل. وعلى هذه الإجابة تَكثُر المواقف الوجوديّة والنقاشات العنصرية، مِثل: 'فلسطين غير موجودة. تقصد إسرائيل؟' – عادة، وبشكل مفاجئ (أو لا) يأتي هذا الجَواب بالعبريّة. أو يسأل السائل عَن غباءٍ أو تغابٍ أو عدم معرفة عن مكانها [فلسطين] على الخارطة، أو ظَنّا أنها بلدة في الولايات المتحدة. ومِنهم على يقين تام عن فلسطين فيسأل: "أين بالضّبط؟ الداخل أو الضفة أو غزة".. ويطول الحديث خصيصًا مع أولئك الملمّين سياسيًّا والمثقَّفين عن القضية.
"أنا من أراضي فلسطين المحتلّة". إجابة قد يعتبرُها بعض السائلين مُوتِّرة كونها تَستَحضر السياسة لصُلب الحديث تلقائيًّا.
إجابات استراتيجية
"أنا من حيفا/الناصرة/يافا/عكا/القدس…"؛ ذِكْر اسم مدينة فلسطينيّة بَدَل الدولة، إما للشعور بالانتماء الملموس، أو للتّماهي، فغالبًا لا يَعلَم السائل أين تَقَع ويَخجل أن يسأل (القدس استثناء في هذه الحالة).
"أَنا من تل أبيب". هذه الإجابة خاصة بسكّان تل أبيب (تل الربيع) الذين يعتبرونها بمثابة دولة بحدّ ذاتها. ففي كثير من الأحيان هي تُعتبر كذلك لشُهرتها وسمعتها المعروفة بملذّاتها ومكانتها الثقافية، أكثر بكثير من موقعها السياسيّ.
هناك من يجيب السؤال بسؤال: "خمّن! مِن أين أنا؟ (Guess!)". على الأرجح يُشبَّه الفلسطيني بالإسباني أو الطلياني أو الأميركي الجنوبي كالمكسيكي والبرازيلي! في بَعض الأحيان يُعتبر هذا إطراء أو أُمنية خفيّة تعطي شيئًا من الراحة المؤقتة عن صمود القضية.
"أنا إنسان عالمي لا أَتبَع لمكان ما". إجابة فلسفيّة عادة ما تُنهي توابع السؤال.
"أنا من فلسطين أو إسرائيل، سمّها كما شئت".
"أنا من منطقة الحروبات والنزاعات".
"أنا من إنجلترا/فرنسا/ألمانيا/إيطاليا/إلخ"؛ إجابة من المُغترِب خاصة حاملي الجنسية المحليّة. والسائل الحُشَري يتبع بسؤال عن الأصل: "لكن من أين أين أنت؟" ترجمة حرفية لـ 'but where are you from from?'، مستشعرًا مثلًا أن البشرة داكنة سمراء لا تُشبه سكان المكان.
هَل كلّ هذه الإجابات آراء مختلفة أم ظاهرة ذات عمق؟
لَطالَما شَغَلني سؤال "من أين أنت؟" كما شَغَلني أكثر تعدّد الإجابات عنه. ناقَشتُه في دوائر الأصدقاء والمعارف والمطّلعين جغرافيًّا وسياسيًّا. ما كان مهمًّا في تلك النقاشات هو التفهّم وعدم الحُكم على أيّ إجابة كانت، بل مشاركة أسبابها والظروف المُحيطة بها.
ليس تعدّد الإجابات هذا من منطلق اختلاف في الآراء أو اختلاف على الحقيقة كما يَظُن البعض. إنه يعتبر ظاهرة. بَحَثتُ بغرض فَهم عمقها قليلًا في علم النفس الاجتماعي، ونظرية ما بعد الاستعمار ودراسات الهويّة، وأبحاث الصّدمات، والأنثروبولوجيا (علم الإنسان). أشارِكُكم هنا أهمّ ما قرأْت:
الظاهرة الأساسية
الأشخاص الذين أصبحوا أقليات في أراضيهم الأصلية بسبب الاستعمار أو الاحتلال أو التطهير العرقي غالبًا ما يجيبون عن سؤال "من أين أنت؟" بطريقة تَعكس الازدواج أو الهويّات المتعدّدة، أو سرديّات مَنشَأ مكبوتة أو مُعاد التّفاوض عليها، أو الاضطهاد الداخلي، أو المقاومة المبنيّة على الكبرياء.
لم تُصِب هذه الظاهرة الفلسطينيين فقط، بل تُعاني منها أقلّيات مشابهة عالميًا، مثلًا السكان الأصليون في كندا، الكشميريون، الصحراويون (من الصحراء العربية)، سكان هونغ كونغ، الأرمن، وآخرون.
إليكم بعض النظريات التي تفسِّر هذه الظاهرة:
١. تكوين الهويّة بعد الاستعمار:
تُفسِّر نظريات ما بعد الاستعمار كما شرحها إدوارد سعيد، وهومي بهابا، وفرانز فانون كيف أنّ الشعوب المستعمَرة تَعيش ما يُعرف بـانقسام الهويّة. الاستعمار يُزيح الهويّة الأصليّة، ويَخْلق ما وصفه بهابا بـ "الهويّة الهجينة".
في كتابه "الاستشراق" (Orientalism) يرى إدوارد سعيد أن الاستعمار لا ينتهي بانسحاب الجيوش، بل يستمر عبر "التّمثيل" و"الخطاب"؛ أي الطريقة التي تُصوَّر بها الشعوب والثقافات. بعد الاستعمار، يعيش كثير من الناس في "هويّة متصدِّعة" لأنّهم تربّوا بين خطابين متضادين: أحدهما غربّي يستصغرهم ويعيد تعريفهم ('إرهابيون'، 'ضحايا غير مرئيين'، استخدام الأرقام لا الأسماء على سبيل المثال)، والآخر محليّ قد يكون مهددًّا أو مكسورًا. لذا، عندما يُسألون: "مِن أين أنت؟"، تكون الإجابة غالبًا محاطة بالتوتّر أو التفاوض بين ما هُم عليه فعليًا وما فُرض عليهم أن يكونوا عليه. يرى سعيد أن هذا نتيجة لهيمنة ثقافية مستمرة تجعل الفَرد يُنكر أو يُعيد تشكيل انتمائه كردّ فعل على التّمثيلات الاستعمارية.
كذلك مفهوم هومي بهابا لـ "الفضاء الثالث" (Third Space): الهوية الثقافيّة التي تُصاغ في مساحة هجينة، ليست أصليّة خالصة ولا استعمارية بالكامل. عندما يُطرح سؤال: "من أين أنت؟" تصبح الإجابة تفاوضًا أكثر من كونها تصريحًا مباشرًا.
بحسب نظرية فرانز فانون: المستعمَر قد يُضطر إلى تقليد المستعمِر أو رفضه. في كلتا الحالتين، تنشأ أزمة في الهويّة الفرديّة والجماعيّة.
٢. نظرية الهويّة الاجتماعية:
طوّرها تاجفيل وتيرنر (1979)، وتفترض أن الناس يَبنون هويّتهم مِن خِلال المجموعات التي ينتمون إليها. عندما يتمّ تهديد هذه الهويّة: قد يُخفونها، أو يُعيدون تشكيلها لتحقيق الأمان أو القبول أو يستخدمونها كوسيلة مقاومة. تُظهر بعض الأبحاث مثلًا لـ فيناي (1990) وبيري (1997) أن الناس يستخدمون "الهويّة الغامِضة أو المعدّلة استراتيجيًا" عندما يَشعرون بعدم الأمان.
٣. الصّدمة الثّقافية والذّاكرة الجمعيّة:
بيّن عالِم الاجتماع جيفري ألكساندر، وعالِمة النّفس ياييل دانييلي، أن الصّدمة التي تصيب مجموعة (مثل الإبادة الجماعية أو التّهجير القسري) تؤدي إلى تحوّلات في الهويّة العابرة للأجيال. الناجون وذريتهم قد يعيدون صياغة أصولهم أو يقومون بإخفائها. تخلق الصدمة "ارتباطًا مجروحًا" بالمَكان والهويّة، ما قد يَظهر في الصّمت أو في التّصريحات السياسيّة. يظهر هذا بوضوح في رُدود السكان الأصليين في الدول الاستيطانية.
٤. التّمثيل الاستراتيجي:
طَرَحته غاياتري سبيفاك في مقالها الشهير (Can the Subaltern Speak?,1988) [هل يستطيع التابع أن يتكلم؟]، وهو اعتماد مؤقّت لهوية جماعيّة مبسَّطة لغرض مقاومة الخِطابات المهيمنة. قد يكيّف الأشخاص إجاباتهم عن أصلهم لـ: تجنُّب التمييز، ودَعم حركات سياسية، والتكيّف مع السياق الاجتماعي. قد نسميه أيضًا اللباقة السياسيّة، لكونه يتجنّب المساءَلات ويتفادى النّقاش أو لأن له مصلحة في ذلك.
٥. الاندماج الثّقافي وتَفاوُض الهويّة:
وفقًا لـ نموذج بيري (1997)، تَستجيب الأقلّيات للثقافة المهيمنة عبر: الاندماج، الفصل، الاستيعاب أو التهميش. تُؤثّر كلّ واحدة مِن هذه على الطّريقة التي يُجيب بها الشّخص على السُؤال "من أين أنت؟".
لغة الجسد
لا تَقتصر الإجابة على الكَلِمات فحسب، بل على لُغة الجَسَد أيضًا. أذكُر بَعض الأمثلة: يأتي التردّد والصّراع الدّاخلي على شَكل تأخُّر بَسيط في الإجابة (٢-٤ ثوان)، النظر إلى الجانب أو للأسفل، شدّ الشفاه أو عضّها، هزّ الكتفين بخفّة (نيابة عن "الأمر معقد")، العبث بالأصابع أو الإكسسوارات باليد، هزّ خفيف للرأس (قد لا يتوافق أحيانًا مع محتوى الإجابة). أما الإجابة الإستراتيجية فتأتي على شَكل وجه خالٍ من الانفعالات، فكّ مشدود، تجنُّب التّواصل البَشَري ونبرة صوتيّة مدروسة. أمّا الإجابة المفتَخِرة بالهوية فتستخدم النّظرات المباشرة والثابتة، والوضعيّة المستقيمة، ورفع الذّقن، وحَرَكات اليدين الواسعة والمفتوحة، ونَبرة الصّوت الثابتة والقويّة، وميل خفيف للجسم إلى الأمام.
العَوامل التي تؤثّر على اختيار الإجابة
في حين يتبنّى المُعظَم إجابةً واحدة يستخدمها، فإن مجموعة لا بأس بها تختار الإجابة بحسب السّائل والظروف. مثلًا:
هل السائل صديق، سلطة، غريب؟ وما هي آراؤه السياسية وما هي آراء دولته السياسيّة؟ فهناك من يجيب مليئًا بالحماس والأمل والامتنان "من فلسطين" للسائل الإيرلندي والإسباني على سبيل المثال حيث المواقف المناصرة للقضية، ويجيب 'من إسرائيل' للسائل الألماني والأميركي.
هل السؤال ضِمن مقابلة عمل، مَعبر حدود، صفحات التّواصل الإجتماعية، أم محادثة عفويّة؟
ما هو الوضع الراهن؟ هل الأمان وحريّة التعبير سائدان أم الحديث تحت المراقَبة؛ هل الهوية ملاحَقة أو محرّمة؟ هل الأحداث في ذاك اليوم تُدني أم تَرفع من مكانة الهويّة في الإعلام ومنصات التواصل؟
ما هو مدى الارتباك أو الازدواج الهويّاتي نتيجة التعليم، والإعلام، أو الضّغط الاجتماعي؟
هل يروق المزاج للنقاش السياسي والجدال المِحوري؟
هل الثقافة والوعي عن الهوية والتاريخ ناضج وزَخِم لإدارة نقاش صاحب مبدأ واثق وحقائق، خال من التردد والتأرجح؟
أيّ واقع يَوَد الشّخص أن يعيش ويسرُد؟ وكيف تؤثّر المواطنة على مفهوم الوطن وحبّه؟
وهنالك مَن يتّخِذ الإجابة كمنبر للمقاومة والفخر، فرصة بها يتمسّك أكثر بالهوية كتحدٍ. أما مجموعات الشّتات والمهجّرين أجيالًا ثانية فما فوق تتعلّق جدًّا إجاباتها بتعقيد الهويّة أو وضوحها بسبب تعدد الأجيال واجتهاد الأهل بتثقيف أبنائهم على الهويّة بالعمق الكافي لصمودها.
الخاتمة
من شِبه المستحيل أن يتّحد جميع الفلسطينيين من الداخل حتى الشتات، مرورًا بالضفة وغزة، بإعطاء الإجابة ذاتها، لكن على الجميع إدراك هذه الظاهرة ووعيها ووعي التّفاسير المختلفة. تحتاج هذه الظاهرة اهتمامًا خاصًّا كشكل من أشكال الصمود، ومن ثم ستحتاج إلى رحلة ترميم الهويّة حين تُقام دولة فلسطين.
شاركونا، كيف تجيبون أنتم عن سؤال: "Where are you from?"

د. حنان خميس
مهندسة مختصة في مجال الهندسة الطبية، مديرة منتج في شركة Siemens Healthineers الألمانية، ومؤسسة شريكة لجمعية نساء عربيات في مجالي العلوم والهندسة AWSc.