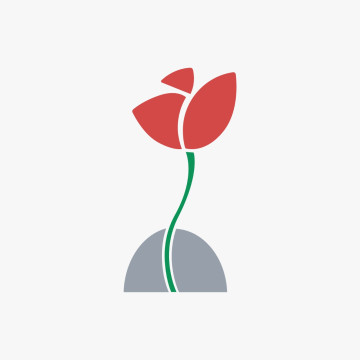هذا أَنَا وَهذا شَيءٌ يُقْلِقُني | بطلٌ واحِد، وَكَومة أَحداث

قبل أن يَدخل شَوك القُنفذ في جِلدي، كنت متعودًا أن أرفع يديّ للسماء، موشوم عليها جرس نُحاسيّ وهِلال فضيّ وبوق حديدي، لا يهمّني نوع الكلمات التي أُرسلها للسماء، بطعم البرتقال الغزّاوي أو تُشبه الشّمع في الكنائس أو رقيقة كالخُبز المُقَرمِش..
أخبرُ السماءَ عَن كلّ شيء أريده، وخاصة أن يكون شَعر مولودتي القادمة أَسود، وعيونها ملوّنة وصوتها عند البكاء يُشبه صوت فيروز.
وأن تَصير جيوبي دكانًا كبيرًا للملابس والطعام والمكياج والخضروات والفواكه واللحوم والماء المثلّج حتى لا تَغضَب زوجتي مِن رديّ اليوميّ: لا يوجد معي ثمنُ أحلامك. كنت أفهم أنّ الأحلام فقط تَخرج من جيوبي.
ولأنيّ أجيد اللغة كنت أيضًا أَطلب من السماء طَعامًا للعصفور الدوريّ الذي ينام فوق سطح الجيران، ولا أنسى دراويش الحارة، أن يجدوا مكانًا ينامون فيه ويخبئون ملابسهم المهترئة. مرةً طلبتُ من السماء أن تُرسل قدمًا خشبيّة من الزان لجارتنا التي تبيع عند عتبة بيتها السمسمية والفستقية والنمورة، حتى تَركض خلف الأطفال عندما يسرقون منها أيّ قطعة.
وأَنْ السماءَ تُعطي عضلاتٍ مدوّرة قوية للرجل الذي يجرّ عربة المهلبية بالعسل من سوق المدينة إلى بيته ليلًا ليصل بها قبل أن ينام صغاره وزوجته صاحبة الصوت الجهور.
وأطلب منها أيضًا أن يَرغَب زبائني باحتساء كأس قهوة آخر منيّ، وكنت أُردّد بشفقة أن تقبل دار النشر الأجنبيّة كتابي الجديد وتنشره ولا تعاقبني لأني أسكن في قطاع غزة وترفض كتابي، لأنه يفسّر كيف يُلمِّع جدّي مفاتيح بيارة الزيتون القديمة، وأُظهر فيه تفاصيل تطريز ثوب جدّتي يوم عُرسها. وسرّ مغلي المرمية الذي يُشفي وجع البطن، وصَوت أغنام عمّي التي تشبه مقطوعة الخلود. فأنا أكتب عن البندقيّة الطويلة المخبأة بين ملابس العائلة في الخَزانة، وعن الوسائد المرسوم عليها القبّة الصفراء، وأجراس كنسية المهد ووجه سميرة توفيق، أَخاف أن تكشف عن أنفاس شاعر الشَّجَرة بين الكلمات، ونَزَق محمود درويش، وشَعْر غسان كنفاني المجعَّد، أخاف أن تكتشف أنني أنا من فكّ قيود حنظلة في رسومات ناجي العلي.
وأختصِر الكلمات عندما يأتي في خاطري الخنافس السوداء أن تعبر الشارع دون أن تدوسها عجلات السيارات المسرعة. فأدعو لها أن تُفلت كما يُفلت الطالب من العقاب المدرسي لأنه ترك الواجب وركض خَلف كرة من قماش بأرجل حافية.
كان القنفذ بعيدًا عنّي وشكلُه جميل، كأنه فأر يرتدي سترة تركها الترزي دون أن يكملها. [القنفذ هو الحرب]، فجأة تضخّم القُنفذ بحجم ديناصور من العصر الطباشيري، وركض ناحيتي ووقتها فَقَدت بوصلة الهروب، فدخل شوكُه في جِلدي.
صِرت أركضُ في الشوارع على شكل شاحنة كبيرة تَحمل الناس والبيوت وقت النزوح، أركض وأركض كدجاجة مصابة بفقدان التّوزان، في وَقت من الأوقات أَصير حمارًا ينهق والناس تَركبُ فوقي، وثورًا رماديًّا في الحلبات الإسبانية مصابًا بعشرات الرماح، أصابعي صارت طويلة كأصابع السّاحرات، وأقدامي مِن كُثْر الركض وراء الخبز والماء صارت كأقدام الفيل.
أُخزّن في رئتي الكثير من الأكسجين خوفَ أن ينتهي أو يرتفع سعره، كالسكّر والزيت، والمَسامير والشامبو وقطع الصابون، ومرابط الشعر وفرشاة الأسنان.
بعد أن دَخَل شَوك القُنفذ في جِلدي كنت أرتدي سترةً لها جيوب لأضع فيها قطع البسكويت عندما يعطينا أحدهم (منّة) وبنطالًا قويًّا واسعًا حتى لا يتمزّق مِن عِراك الطوابير، وأحمل في حقيبتي بطاقتي الشخصيّة وصورة جماعيّة لعائلاتي وكَرْت التموين وصورًا عن شهادات ميلاد بناتي، وبطاقة دواء المرض المزمن لأبي وأمي، وشاكوشًا وخيطانًا وأسلاكًا وأكياس نايلون ومقصًّا وسكينًا وحبة مسكن وبخاخة فينتولين موسّع للقصبة الهوائية.
وأيّ قطع قماش أو خشبة أو حَبل أَجدها في الشارع أَحمِلها لأكمل جَسَد الخيمة التي أسكن فيها التي لا تَكفي أن تَفْرد أَقدامك ولا تستطيع أن تغسل وجهك ولا تحلم بها فيخرج حلمك من رأسك كسهمٍ فيثقب سقفها، وطوال النهار والليل وأنت تُلاحِق الزواحف والحشرات والشمس والعتمة لتمنعها أن تشاركك مساحة الخيمة.
أتجنّب المشي والركض خلف الماء والخبز في الأماكن التي تَسكن فيها عشيقاتي القديمات، حتى لا يرينني وأنا رثّ الثياب، فيرفضن لغتي الأنيقة التي كنت أهديها لهن قبل أن يدخل شوك القُنفذ في جِلدي.
وأُخفي وجهي ولهاثي عندما أقابل أحد تلاميذي من كُتّاب السرد فيكتب عنّي: رأيت الأستاذ بدون نظارة شمسية وبدون عطره المفضّل. لكن بكلّ صراحة لا أحد ينتبه لأحد في هذا الوقت، وجهاز الذكريات تعطَّل وقت التشابه العظيم في هذه الحرب.
وأنا أنتظر مع مجموعة من الرجال والسيدات أمام شُبّاك مطلي باللون الأزرق لنحصل على المعلبات وقليل من السكّر والخضروات، وَجَدتُ قطعة من زجاج المرايا بالقرب من بيت صار كومة من الحصى من وراء القصف، ارتعبت وحاولت ألا أرى وجهي فيها أو شكلي، لكن تشجّعت ونظرت لوجهي، وقبل أن أدقق في ملامحي الجديدة، لساني نطق جُملة [هذا أَنا وهذا شيءٌ يُقلقني] وجهي كشقوق الطّين الجافة، تَحوّل إلى خرائط التيه، وعيوني غائرة في جمجمتي تحتاج لملقط شعر لتُعيدها لمكانها المناسب، وخدودي بها ممرات جديدة من شتاء الدموع التي تَنزِل بدون قصد. وشعري زادت تجاعيده وكبرت دائرة الصلع في منتصف رأسي.
أَحَبّ الجميع أن يلعب معي هذه اللعبة ويَنظر إلى وجهه في المرآة، وكنت أسمع دقّات قلوبهم كقنابل صوتيّة، مررتُ المرآة لهم واحد تلو الآخر، انطلقت النُكات من أفواههم كخيول السباق لا تتوفق حتى تصل النهاية، منها: أَصبحتُ عجوزًا، أنفي أصبح طويلًا، وجهي كَرغيف الخبز المحروق، رأسي كرأس الفِجل الأحمر، شفاهي أصبحت كَشِفاه إسماعيل ياسين، رقبتي كرقبة الجمل، وجسمي كـ "أحدب نوتردام". أين ذَهَبت ملامحنا الجميلة؟ صِرنا نصفع بعضا البعض لعلّنا نُفيق من الصدمة.
حاولت أن أعطي المرآة للسيدات، لكنّهن رَفَضن أن ينظرن لوجوههن، لأننا كنّا لهن المَرايا فشاهدن أنفسهن دون اعتراض، مَسَكتها وألقيتها بعيدًا فوق كومة من القمامة فدخلت في جثة حِمار لم يمض على موته سوى ثلاثة أيام. ملامحنا الجديدة لا تليق إلا أن تُدفن في هذا الجسد....
[الرجال عندما يفقدون ملامحهم يضحكون كثيرًا، أما النساء فيَعلمن أن الملائكة هي من تسرق الملامح الجميلة وقت الحزن]
حاولت أن أَنزع عن جِلدي شوكة، وأذهب لأبحث عن الأولاد والبنات الذين يكتبون في مخيمات النزوح، وقد قَرَعت الأجراس وقابلتهم كما تُقابِل الإوزة صغارها بالرّقص في بركة الماء.
لأني أحمل معتقدًا داخلي بأن الكتابة هي من تُقاوم الريح وتحوّل الأقدام إلى جذور في الأرض، وَحدها الكتابة تستطيع أن تصلح ثقوب سترتك، وتضيف فصلًا خامسًا للطبيعة، ولأحصل على مجموعة منهم كنت أشاركهم طابور الماء المالح، وطابور الخبز، وأقول لهم بأن صوت الطائرات والقنابل هي موسيقى تصويرية لما ستكتبون، شَكلُ الخيمة المثلث البشع والجروح التي حصلت عليها من عراكك الأخير حول شُبّاك الكابونات هو ذروة الأحداث في نصك العالمي.
فقط عليكم أن تَكتبوا كما كَتب الأجداد على جذع النخيل بالفأس والعرق، تكتبوا لأصحاب الياقات البيضاء وربطات العنق كلمات تجعلهم يَشنقون أنفسهم فوق الموائد الفاخِرة، عليكم أن تكتبوا عن صَوت جوعكم الذي يشبه طبول الهنود الحمر حول النار قبل أن يُمسحوا من ذاكرة الأرض، اكتبوا حتى يزيد اتساع ثقوب الإسفنج لتبلع دموعكم قبل أن تسقط في صحن الفاصوليا والبازلاء، الكتابة ستصنع لكم ألعابًا من قماش وخشب وبعد أن تلعبوا بها تضعوها في فرن الطينة لينضج طعامكم الأخير قبل أن يشم رائحته جنود الدبابة الكبيرة بقبعاتهم الحديدية وجيوبهم المليئة بالرصاص والبارود والشوكولاتة والماء الحلو البارد.
حين أقابل الأطفال وأحثّهم على الكتابة كنت أَدخل في رؤوسهم كذكريات قبل الحرب أمام محل البوظة، كقرمشة المكسّرات في أفواههم. كأناقة الزيّ المدرسي ورائحة المقاعد المدرسيّة، وحارًّا كفلافل الصباح، كنت أدخل في رؤوسهم كشبّاك مفتوح على الساحة الخليفة لبيوتهم تطلّ على حوض النعناع والفراشات المرقّطة التي تدور حول صحن السُكّر، أدخل فيهم كفيتامين سي مضاد لنزلات البرد، أو كوجبة كاملة الدَّسم، أو كوقت الأرجوحة في المنتزهات العامة، أصبحت كلاصق على جفونهم، كشاشة عرض كبيرة تعرض فيلم كرتون.
علمتهم كيف يشمون رائحة الفكرة كأنهم صيّاد أفريقي ويخرجوها من ثقوبها ويصنعون حفلة شواء عليها. علمتهم كيف يحكّون جلدهم من تعب اليوم فيتساقط كأغنيات تغنيها ريم تلحمي فوق جبال بيت لحم، علمتهم أن يمسحوا الغبار عن أضواء السيارات لتكشف لهم عن حُفَر الشوارع فينجون من السقوط، وأن يدخلوا في عقل مايكل أنجلو ويصبحوا لوحات يعلّقها على جدران الكنائس الطويلة.
قلت لهم: فليسقط المكان والزمان عندما تكتب، فأنت المكان كشارع في فرنسا به أعمدة إنارة لا تنطفئ، وسيدة تمشي من تحتها بفستان الأميرات تنتعل حذاء كعب عالٍ أحمر، والزمان هو أنت يحتار المؤرخون أين يضعون زمانك في كتب التاريخ، لأن زمانك به رائحة الطين وانشقاق القمر وقرع الأجراس فوق شجرة الياسمين، أنت الزمن التي تتحكم بطول الليل والنهار وتتحكم بالتركيب الجيني للعشاق والراحلين في القطارات السريعة.
قلت لهم: أنت البطل، لأنك تُشبه دو كيشوت وقميصك من ورق الكرتون، أنت البطل حتى لو تكرّر طعامك اليومي، أنت البطل حتى لو ضاقَت عليك الخيمة، أنت البطل حتى بعد غياب أبيك من وراء القصف الأخير، أنت البطل وأنت تحمل دِلاء الماء وتوزّع الخبز كالسيد المسيح على عائلتك والجيران والحواريين، أنت البطل حتى لو زاد وَجَع ظهرك وضعف بصرك وخفّ وزنك من قلّة النوم من صوت الطائرات.
قلت لهم: أنت النهاية، وعليك أن تختار النهاية المغلَقة لنصك كما تُغلِق حديقة الأغنياء أبوابها أمام الجوعى، عليك أن تختار نهاية مغلَقَة كما تُغلِق باب الخيمة عليك أو تُغلِق أزرار سترتك وقت الريح. فلتكن نهايتك قوية كخشب القوارب وجميلة كطلاء الأظافر الأحمر، كلون حنّاء أصابع جدّتك، ناعمة كضحكة طفل حصل على علبة ذرة صفراء حلوة المذاق.
لم نقف وقتها على شكل دائرة أو مرَبع ناقص ضلع لنكتب، كنا نُعطي ظهورَنا لبعض، كأننا غرباء، كلّ واحد يكتب وله أذرع أخطبوط: ذراع للخبز، ذراع للماء، ذراع للخوف، ذراع للخيمة، وذراعان للكتابة، لا أحد منّا يرى ما يكتب الآخر، ولا نعلم لمن نَكتب، ولا يوجد شمّاعة ملابس لنعلّق عليها نصوصنا، أو حَبْل غسيل، فقط كنّا نكتب إلى السماء، ولتُصبح أرواحنا خفيفة رشيقة تقدر أن تقفز خلف السّياج لتسرق ورق العنب الأخضر، نكتب لنصير وتدًا للخيمة، لتصير منفوشة كحلوى غزل البنات.
بعد أن تكتب ماذا تُحِب وكيف تحب أن يراك العالم، يُمكن أن تقف مرتاحًا في الطابور الطويل، وأن تنظّم دقات قلبك وقت القصف، وتساعد ظلّك أن يمشي خَلفَك دون خوف، بعد الكتابة ستعرف أن تجيب عن السؤال السرمدي: ماذا تعني كلمة وطن تحت سقف الخيمة؟
يومًا بعد يوم كبُرت أشواك القُنفذ فوق جِلدي، ولم أجد أحدًا يزيلها عني، يبدو أنني تحوّلت إلى قُنفذ برّي، هذا أَنا وهذا شيءٌ يُقْلِقُني.