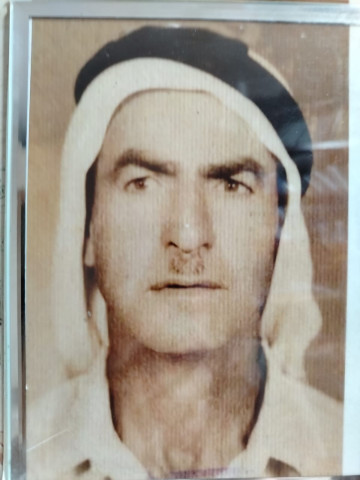هُنا إِقرث

لم يُدرك الأهل أنّ الغاصب ليس طيّبًا كطيبتهم الفلّاحيّة، وليس صادقًا كصدقهم الفِطري، وليس محبًّا كمحبّتهم التي تربّوا عليها، ظنّوا نيّته صافيةً كَنِيّتهم، إذ لم يَعرف قاموسهم المَكر واللؤم.
حين وَعَدهم بالمحافظة على حياتهم صدّقوه، وحين وَعَدهم بالعودة بعد أسبوعين صدّقوه، ولم يخطر ببالهم أنّ الخطّة المرسومة تُحتّم تَرحيلهم.
كانت الحرب في آخرها حين دَخَل الغاصب، واستقبله الفلّاحون العُزّل بالرّايات البيضاء والخُبز والمِلح والماء، ولم يَخطر بِبالهم أنّ هذه الرّايات ومِلحَهم وخبزَهم وماءَهم، لا تَعني شيئًا بالنّسبة له، فهو القويّ الآمر النّاهب النّاهي، وكانت الحرب قد انتهت وتوقّفت النّار على الحدود، ورغم هذا كان ادّعاؤه أن العمليّات الحربيّة لم تَنته بعد، ولم يعرف أحدٌ أن ترحيلهم كان مخطّطًا "مِن أَعلى"، ضمن خطّة إبقاء رقعة (نظيفة) على الحدود مع لبنان، أَدنى عرْض لها 5 كيلومترات.
وكان أن نَقَلهم الغاصب إلى قرية الرّامة واعدًا أنّ هذا الانتقال مؤقّت، ومن أجل إقناعِهِم بِصدق وعده، سمح بإبقاء عدد من الرّجال، بِمَن فيهم كاهن القرية، من أجل حراسة البيوت، مَرّ الأسبوعان كالدّهر، تلاهما أسبوعان وشهران، وبدل السّماح للمُبعَدين بالعودة طَردَ أولئك الذين ظلّوا في البلد، وتمرّ سَنَتان أُخريان وثلاث، والمماطلة تدور حول مِحور الكذب والخداع، مرّةً أن الوضع الأمني لا يَسمح، وأخرى أن الأمر ليس متعلّقًا بهذا الموظّف أو ذاك، فالأوامر أَعلى وأَكبر، الأمر الذي اضطرّهم للتّوجّه إلى المحكمة بواسطة المحامي النّصراوي محمّد نمر الهوّاري، ظنًّا بأنّها ستنصفهم، لكنّها رغم إبداء تعاطفٍ معهم، جاء قرارها متعاطفًا ظاهريًّا لكنّه لمّح للغاصب أن يُصدر أمرًا قانونيًّا، فكان أمر الإخلاء رغم مرور ثلاثة أعوام خارج البلد. أَعقَب الغاصب أَمرَه بهدم البلد كي يدبّ اليأس في القلوب ويموت الأمل بالعودة، وكان الهدم في ليلة الميلاد 1951، في العام نفسه الذي صدر فيه قرار المحكمة، وكأنّ الغاصب يهدي المُبعَدين هديّة العيد، لكن هذا لم يُثنِهم، بل زادَهم إصرارًا على حقّهم بالعودة وبناء بيوتهم من جديد.
لم يَستَطع الأهالي في سنوات الحكم العسكري زيارة البلد إلّا في ذكرى النّكبة حسب التّقويم العبري، لأن قوانين الحكم العسكري تتوقّف في هذا اليوم، ولا توجد رقابة على التّنقّل، وكانوا يستأجرون شاحنة يَتَقاسم أجرتها بعض العائلات، تنقلهم كبارًا وصغارًا إلى مدخل البلد الغربي، يترجّلون ويتوجّهون شرقًا صعودًا إلى قمّة التّلّة حيث الكنيسة التي بقيت شامخة رغم تحويلها لحظيرة أبقار، دون أيّ رادع ضميريّ.وكانت هذه الزّيارات مناسَبَة لتجديد العهد وتعريف الأجيال الصّاعدة على البلد بحاراتها وبيوتها وحواكيرها، وكانت تُروى الذّكريات، وتَسيل الدّموع، وتَعلو أصوات العتابا:
أوووف
هِلّي يا دموع العين هِلّي
ع البيوت الّكانت على التّلّه
يا ربّي إلك بشكي وبَصَلّي
تعمر بلدنا ويرجعوا الغيّاب
..
أوف
أبكي ع بيتي وع الحكوره
وع لِكنيسة اللي انطفى نورا
كانت عامره وأهلا نسورا
صارت بعدنا مسكن للغراب
..
يَبكي الكبار ويَبكي الصّغار الذين يحسّون الألم الذي يحسّه الكبار، وهكذا استمرّ حبّ البلد واستمرّ الإصرار على العودة.
وتمرّ السّنينُ وأمنيات الكبار أن يعودوا ولو قَبل وداعهم الحياة بيوم، لم يتحقّق هذا بَل عادوا لينضمّوا لآبائهم وأجدادهم في تُربة بلدهم، الأمر الذي تحقّق بعد نِضال طويل، والإصرار على التّمسّك بحقّ العَودة، كما تمّ ترميم الكَنيسة وتَطهيرها من دَنس الحيوانات ورَوثها الذي تكدّس فيها سنوات طوال، عادت الكنيسة تشعّ نورًا وتَصدح فيها أصوات المرنّمين، تَستَقبل الأهل في أعيادهم ومناسباتهم.
وعند انتهاء الحكم العسكري واحتلال الضفّة الغربيّة وغزّة والجولان وسيناء، وفي ظلّ نَشوة الانتصار، أَعلن وزير الدّفاع إلغاء كلّ المناطق الأمنيّة داخل "الخطّ الأخضر"، وهذه كانت بوّابةً نَدْخُل من خلالها إلى ضرورة العودة، لأن أمر الإخلاء العسكري يُعتَبر باطلًا بإِلغاء المَناطق العسكريّة، لكن وزير الأمن نفسه أصدر أمرًا يُعلن منطقة إقرث وبرعم منطقتين عسكريّتين، الدّخول إليهما محظور.
رغم ذلك، تنظّم الأهل وأعلنوا اعتصامهم في البلد، وفي ليلة واحدة امتلأت الكنيسة ومُحيطها والحواكير بالنّاس كبارًا وصغارًا، وحَدَثت صدامات مع الشّرطة ونُفّذت اعتقالات، وصَدَرت أوامر عدم الدّخول إلى البلد، لكن هذا لم يحبط إرادة النّاس وعزيمتهم، وتقرّر تصعيد النّضال باستمرار الاعتصام في الكنيسة والتّظاهر في حيفا والقدس، وكان مِن ثِمار هذا التّصعيد وهذا الإصرار أن حصلنا على حقّنا بترميم الكنيسة واستعمالها، وترميم المقبرة أيضًا واستعمالها، وفي أعقاب ذلك، جَرَت في البلد طقوس دينيّة، وتمّ فتح الكنيسة في مناسبات الأفراح، وإقامة القدّاس مرّة كلّ شهر، وهي مناسبة لالتقاء الأهالي وتجديد العهد.
كما أقيمت مخيّمات صيفيّة للتّلاميذ من أجل زَرع روح الانتماء لمَسقط رأس الآباء والأجداد. وكان أن قرّر عدد من الشّباب -وجميعهم لم يولدوا في البلد، وهم الجيل الثالث للمهجّرين- قرّروا الرّجوع، وتناوَبوا على المكوث في جوار الكنيسة ليلًا ونهارًا، وما زالوا يتناوَبون، ويتقبّلون كلّ مَن يأتي للتّضامن أو الزّيارة أو تَجديد العهد.
يَغيب جيل ويَليه جيل أكثر إصرارًا وأملًا، ومَن كان له مثل هذا الإيمان سينتصر حتمًا ويُعيد إلى البلد حياتها. جيلٌ يَمضي وجيلٌ يأتي حاملًا الرّاية ذاتها والانتماء ذاته والإصرار ذاته والأمل ذاته، فَلَو سأَل أحد أيّ طفل من إقرث، (مِن أين أنت؟) لأجاب بلا تردّد (أَنا مِن إِقرث، لكِنْ أَعيش في ....)، هذه الرّوح التي ستنتصر حتمًا، ويعود النّور إلى البلد بَعد سنوات العتمة، وتعود الحياة كما كانت، فالأرض تشتاق للنّاس كاشتياقهم لها، ولا يكفي أن يعود الأموات إلى تربة البلد، بل سيأتي يوم، نراه قريبًا وتعود الحياة حين يعود الأحياء.
الصورة: مظاهرة لأهالي قرية إقرث المهجرة من عام 1972 قرب الكنيسة، يطالبون بالعودة لقريتهم - من صفحة يوسف أمارة.

فوزي ناصر حنا
من مواليد إقرث سنة النّكبة، حامل لقب أوّل في تعليم الجغرافية والتاريخ، وشهادة مرشد سياحي مؤهّل، معلّم متقاعد، ومرشد سياحي منذ التّقاعد سنة 1998، يكتب القصّة والمقالة والقصيدة، نشر في العديد من الصّحف، باحث في مواقع الوطن وتاريخه، ينشر مقالًا أسبوعيًّا في هذا المجال منذ سنوات، أصدر العديد من الكتب، منها: (ما وراء الأسماء) وهو بحث في تاريخ أسماء 30 موقعًا، (نباتات وحكايات) وهو جمع لأساطير دينيّة عن نباتات فلسطين، (جلال الجليل) وهو تعريف بمواقع الجليل، (خطوات على طريق الذات) وهو حكايات حقيقيّة من حياة الكاتب.