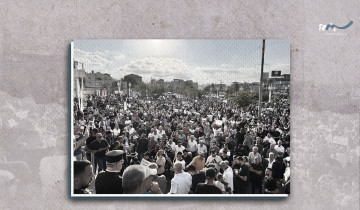فِلِسطينيّو الدّاخل في الشَّرِكات الإِسرائيليّة: سُقوطُ الأَقْنِعَة
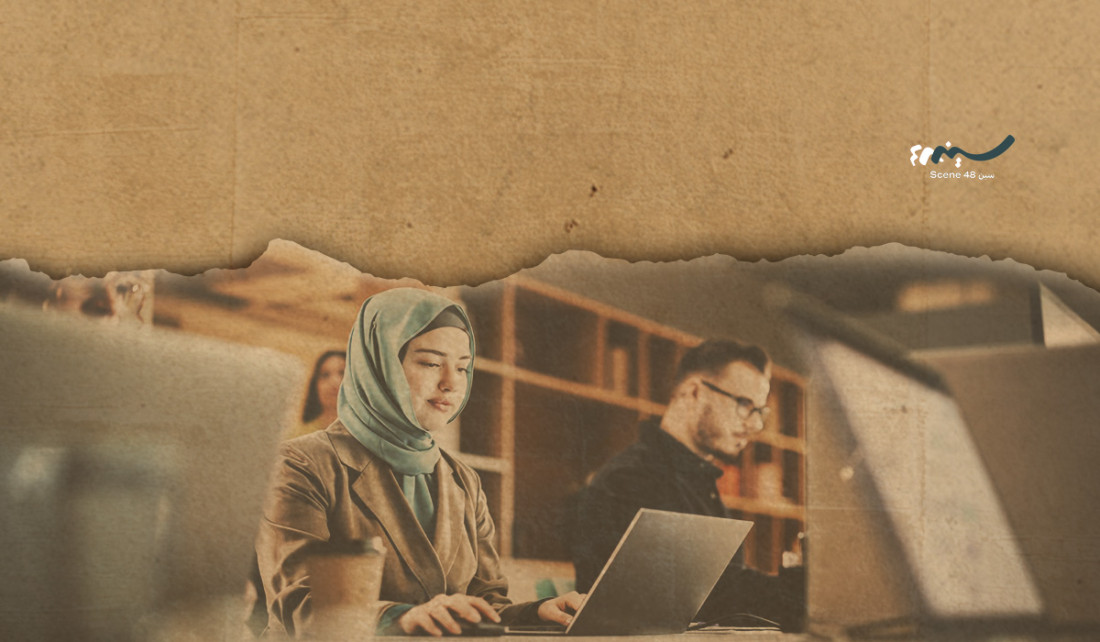
لطالَما كان الطالب العربي في الداخل الفلسطيني الواجهةَ الأولى لأيّ صراع سياسي، من شماليّ البلاد حتى جنوبها، بحكم دراسته في الجامعات بعيدًا عن قريته أو بيئته المألوفة، فهو محطٌّ للشكوك والأنظار. هذا هو الحال الطبيعي للطالب، أو العامل الذي يَعمل خارج مدينته الأصلية. تتفاقم هذه النظرات والشكوك في فترات الحروب، لتتحوّل أحيانًا إلى عائق حقيقي أم الحياة، تَشْغل الفلسطيني الذي يدرس أو يعمل في إحدى المدن الإسرائيلية. نحن، فلسطينيو الدّم والهويّة القوميّة، نعيش ونتعلّم ونعمل داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي خضم أيّ توتّر سياسي، تُوجَّه إلينا أصابع الاتهام لمجرد وجودنا هناك، وتلاحِقُنا النّظرات والشكوك في الشارع، في أماكن العمل وفي الجامعات.
أَذكُر في فترة إحدى الحروب، كم كان من المُقلق جدًا استخدام وسائل المواصلات العامة! إذا كنت تتحلّى بمَظهر يَشي بعروبتك — سواء من لون بشرتك أو لباسك أو حجابك — فعليك أن تلتزم الصّمت وتخفض رأسك في التجمّعات الإسرائيلية. يجب أن يشعر جميع من حولك بالاطمئنان أنّك لا تحمل نيّة سيئة، فهم يخافون من كلّ "دخيل"، وهناك؟ نحن دخلاء.
في فترة ما بعد أحداث هبّة الكرامة، كان من المُستحيل أن تَسير في شوارع المدن الإسرائيلية دون أن تُلاحقك النظرات، أو تتعرّض للمضايقات والشتائم، وربما الضرب او التهديد. لا أظن أن بإمكاني أن أنسى يومًا وَجْهَ أيّ شخص قَذَفني بعبارة "الموت للعرب"، لا في تل أبيب، ولا في القدس، ولا حتى في حيفا. وليس لديّ شكّ أن لكلّ واحد مِنّا مِن قصص العنصرية ما يكفي لـ "ألف ليلة وليلة". لكنّنا اعتدنا هذا المشهد، وصرنا نتداول النصائح بيننا للطلاب الجدد بنبرة فكاهيّة ممزوجة بالألم، ليدركوا أهمية الحذر والأمان في تلك الأماكن: "لا تتحرّك فجأة في الباص، لا تتحدّث بالعربية في الهاتف- فهم يخافون من اللغة، وابقِ يديك مرئيتين دومًا ليروا ما تحمله أو تفعله".
كانت في نهاية المَطاف قاعات الجامعات أو مكاتب العمل هي المَلاذ الآمن — حيث وُجودك لا يشكّل خطرًا على أحد، وحيث أنت في مأمن لأنّهم يألفونك. هم "أصدقاؤك وزملاؤك" الذين تقضي معهم معظم وقتك، تتبادلون أطراف الحديث والنّكات وربما الطعام والقهوة. تعلّمهم كيف يقولون "حبيبي" بالعربية دون استخدام حرف "الخاء"، ويحدّثونك عن الأكلات التي تنتظرهم يوم الجمعة في بيت الجدّة البولندية، التي على ما يبدو، نسبوها لأنفسهم، كما نَسَبوا الحمص والسَلَطة العربية. لكن لا بأس، لأنّك هناك تكون في أمان.
لكن الحرب الأخيرة لم تترك ثابتًا إلّا وزعزعته، وضَرَبت في عمق كلّ وهمٍ نَسَجناه حول الأمان والتّعايش، حتى "زملاؤنا وأصدقاؤنا" بدأوا يروننا بنظرة مختلفة، دون أقنعة ولا تلطيف. أصبحنا "الفلسطينيين" الذين يُطلب منهم في كلّ مكان أن يدينوا أو يشجبوا، أو أن يضعوا الشّريط الأصفر، كي يُصنَّفوا في دائرة "العربي الجيّد". صار الذّهاب إلى العمل يُثقل كاهلنا حتى أصبحنا نُفكّر كيف ننسحب من وجبة الغداء الجماعية عندما يبدأ الجميع بشتم أهل غزة ولعب لعبة انتقاء الدولة العربية التي يجب ترحيلهم إليها، فهل يمكننا في هذا الموقف فعل شيء غير الانسحاب؟ نحن لسنا جزءًا من المحادثة أصلًا، نحن الدّخلاء، أتذكر؟ وكلّ ما قد نقول، يمكن أن يعرّضنا للفصل من العمل وحتى المساءَلات القانونية.
أصبح مكانُ العمل المكانَ الذي تتصدّع فيه هويّتنا، حيث يتوقّعون منّا مشاركتهم احتفالات عودة أحد الزملاء، الذي عاد سالمًا بعد شهور من المحاربة في الجبهة الجنوبية (حيث يُقتل الأطفال والنساء ويجوّعون) ضمن جنود الاحتياط. كما كُتب علينا أن نتجوّل في ممرات مكاتبنا الأنيقة، نحمل فناجين قهوتنا الأمريكية بابتسامات معتادة، بينما نُشيح أبصارنا عن المسدّسات المعلّقة على خواصر زملائنا، والأسلحة الثقيلة التي يتباهون بحملها كأنها امتداد طبيعي لبيئة المكان.
مكان عملنا، الذي كان يومًا مدعاة للفخر، أصبح مصدرًا دائمًا للقلق والتوتر، تَرَكنا من أجله قريتنا الصغيرة، لنصل إلى "مركز البلاد"؛ حيث تُصنع الفرص وتُبنى السِيَر المهنيّة، ويُقال إن المستقبل هناك. هناك، حيث تُقدَّر الكفاءات برواتب أعلى، ويزدهر الانفتاح الثقافي في فضاءات أرحب، وتقوم البنى التحتية على أسس من التخطيط والرعاية. كان من الطبيعي أن أشعر بالفخر، أنا الشاب الفلسطيني الذي واجه التحدّيات، وجابه الصّعاب ليصل إلى هذا المكان، درس سنواتٍ طويلة، وتَحمِل ما لا يُحتمل ليصل عتبة ما كان يظنّه مَجدًا. وأنا، الشابة الفلسطينية التي تمرّدت على قيود مجتمعها، وقرّرت الانفصال عنه لا نكرانًا له، بل بحثًا عن ذات حقيقيّة، في مكانٍ يقال إن كلّ فرد يصنَع فيه هويته، حيث المختَلِف مرحّب به، أو هكذا قيل لنا.
لكنّه لم يَعد ذلك المكان الذي حلمتُ به يومًا، ولا تلك المحطّة التي ظننتُ أنها ستكلّل سنوات جهدي وتضحياتي. بل أصبح، على مضض، واقعًا لا مهرب منه؛ مكانًا ارتاده كلّ صباح لأنني لا أملك خيارًا آخر يسدّ حاجاتي أو يُنصف رحلتي الطويلة. فأين لي بفرصة عمل تكافئني بما أستحق، إن لم تكن هناك؟ أمضي يومي بين الجدران ذاتها التي كانت يومًا مصدر أمل للتقدّم، أمارس ما يشبه الحياد البائس، متناسيًا — أو متصالحًا قسرًا — مع جانب من هويتي لا يُرحّب به هنا. لم أعد أُخفي ما استطعت من هويّتي فقط، بل أُلبسها صمتًا متواطئًا.
مِنّا مَن قد يقول: "علينا أن نظلّ هناك، فواجبنا الوطني أن نكون شوكة في حلقهم. يجب أن تكون لنا بصمة في جميع مؤسساتهم". لكن، لِمَ علينا أن نفعل ذلك حقًا؟ لِمَ نسعى بإصرار لنكون تلك 'الشوكة'؟ كأننا في سباق لإثبات أمر ما — لأنفسنا؟ أم لهم؟ لنُظهر أننا قادرون، أننا نستحق مكانًا في دوائرهم، أننا نستطيع أن نكون أولئك الذين يعيشون من أجل مسيرتهم المهنيّة فقط، منسلخين عن ذواتهم، متناسين مجتمعاتهم وهوياتهم. هل نطمح إلى أن يَرونا حينها أكثر كفاءة، وأقلّ خطرًا؟ أكثر قابليّة للاندماج، وأقلّ إثارة للرّيبة؟
لكن، ربما يأتي يوم ندرك فيه أننّا قادرون على أن نكون زهرة، أو شجرة ضاربة بجذورها في عمق تراب مجتمعاتنا وبلداتنا. قد نكتشف أن بمقدورنا أن نكون أكثر من مجرّد 'شوكة' — أن نكون شيئًا أجمل، وأسمى، وأصدق، لا من أجل إثبات شيء لأحد، بل من أجل أنفسنا، ومن أجل الأرض التي ننتمي إليها.