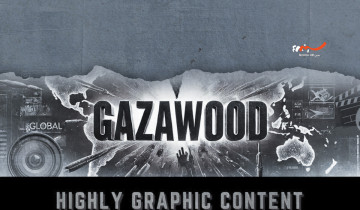لَيسوا مُجَرّد أَرقام في تَقارير الجَريمة!

أَذكُر جيدًا مقابلة العمل تلك، حين سُئلْت عن الآليات الممْكنة لاستقطاب الشبيبة أو الشباب إلى البرنامج أو الإطار. يومها قلت بثقة: "الاستقطاب هو الجزء الأَسهل، لكنّ المهمة الحقيقيّة أصعب بكثير، لأنها عميقة ولا يمكن حَصرها بكلمات أو أداء". هل من يعمل مع الشباب والشابات حقًّا يحمل في داخله روحًا مهنيّة شابّة، ومرنة، وخصبة؟ أم أن البعض يمارس هذه المهنة بروح متعَبَة ومتكلّسة؟
الواقع أن الظروف المادية والاجتماعية والعاطفية تَختلف من شاب لآخر. تَلعب الطفولة والرعاية الأولى الدورَ الأكبر في تَشكيل شخصيّاتنا وطريقتنا في التّعامل مع الحياة. لكن رغم كلّ ذلك، أؤمن بأن الأزمة تَبدأ من الخارج، لا من الدّاخل. وأعي تمامًا ما أقول.
كلّما تذكّرت مراهقتي، خَطَرت في بالي مادّة الطّين. كنت أَشْبَه بها: بحاجة إلى الماء، إلى الدعم، إلى العناية والريّ. حين يَحظى الطين بماء كافٍ وكلام محبّ، يصبح طيّعًا، ناضجًا، قابلًا للتشكّل. لكن عندما يُحرم من ذلك، ويواجه جفاف الكلام وحرارة الإحباط، يجفّ، ويقسُو، ويَصعب تشكيله—بل وربما يُصبح من المستحيل إصلاحه.
نحن، كأخصائيين وأخصائيات، نُؤْمن بهذه الاستعارة، بل ذوّتناها في صميم عملنا، لكنّنا نعرف أيضًا أن الممارسة اليوميّة ليست دائمًا بتلك السلاسة. لم يكن الطريق يومًا سهلًا أمام الشباب، لكن في ظل الحروب، والعنف، والجريمة التي تحاصرهم اليوم، أصبح طريقهم مليئًا بالأشواك، لا تحدّه أزمة تعليم أو وضع مادي فقط، بل يتغلغل التحدي في كلّ زاوية من زوايا الحياة.
الشباب والشابات، بطبيعتهن.م، هم الفئة الأكثر طموحًا وحيوية في أيّ مجتمع، هكذا رأينا وتربّينا. لكن في بلاد تعيش تحت ويلات الحرب، يصبح الطموح رفاهيّة، ويغدو الحلم عبئًا إضافيًا على كاهل شاب بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه.
وَجَد عشرات -أو ربما آلاف- من الشبيبة أنفسهم فجأة خارج مقاعد الدراسة في جيل صغير جدًّا، بلا إطار وبلا أمان، بلا خُطّة أو أيّ برنامج بسيط وحتى بلا بلاد مستقرة.
من يعيش هذه الظروف، لا يقرأ عنها فقط أو يراقِبها من بعيد، يعرف تمامًا ما معنى أن تُضطر لترك المدرسة أو الحياة الطبيعية أو للعمل في مهنة لا تَمتّ لك بصلة، فقط لأن عليك أَن تُعيل أسرتك أو تكون جزءًا من التيار الجارف وراء الماركات أو الحياة غير الحقيقة، أو ربما عَلِقت بإطار ظالم وأسود. يعرف ما معنى أن تهاجر رغمًا عنك، لا حبًا في الرحيل، بل هروبًا من الشعور بالعجز أو من الإحباط والقهر أو من عَدَم وجود شخص واحد فقط يقول لك: "أنا هون حَدَّك".
لكن، رغم كلّ هذه التحديات، فلا يمكن إنكار أن الشباب والشابات الفلسطينيين في الداخل أظهروا قدرة لافتة على التّأقلم، والصمود، بل وحتى الإبداع. من رحم الأزمة، خَرجَت مبادرات شبابية صغيرة، وظهرت مشاريع بسيطة عبر الإنترنت، الكثيرون تعلّموا البرمجة، والتصميم، والترجمة، أو التجارة الإلكترونية، وبدأوا ببناء حيوات جديدة في فضاء افتراضي بعد أن ضاق بهم الواقع الحقيقي.
لكن، هناك فئة ضاق بها الواقع مرّتين، وسط كلّ هذه التحديات والإحصاءات، فئة من الشباب لا تُذكر كثيرًا، تُركت في الظلّ، وكأنها لم تكن. هذا الشاب أو تلك الشابة الذين لم يَمنحهم الخارج فرصة عادلة؛ لا منظمات أو مؤسسات، ولا برامج دعم، ولا حتى اعترافًا حقيقيًّا بمعاناتهم. ثم، وكأن الظلم لا يكفي من الخارج، جاءهم من الداخل؛ من البيئة الطبيعية التي قالت: "أنت لست أهلًا"، من المجتمع الذي وَضَعهم على الهامش، من الطاقم التربوي أو الإداري الذي رفع يده وقال: "الأمر أكبر منّي".
هؤلاء الشباب لا ينامون بسلام، بل يستفيقون كلّ صباح ومعهم أُمنية واحدة: "ليت اليوم يحمل تلك الفرصة التي تأخّرت كثيرًا". يقول أحدهم في داخله: "ربما يكون هذا اليوم آخر يوم في هذا الظلام، وربما أخرج أخيرًا من هذه الحياة الميتة". يعرف تمامًا أنه لا يريد أن يتخلّى عن نفسه، لكنّه يشعر بأنه تُرك ثلاث مرات: مرّة من العالم، ومرّة من القريب، ومرّة من ذاته التي بدأت تُنهك من الانتظار.
هنا يصبح "التَرْك" حقيقة ثقيلة، ويغدو "الثالثة ثابتة"، لكن لا على شكل حَظ، بل على شَكل خذلان مستمر. ويتحوّل المستقبل في عينيه إلى شيء بعيد، باهت، وربما مخيف أكثر من أيّ وقت مضى.
شباب يُفترض أن يكونوا في مقدّمة الإبداع والعمل، وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة حقيقيّة مع الحياة اليوميّة. أصبح التنفّس والأمان والتّعليم رفاهية، والهجرة، حرفيًّا ومجازيًّا، خيارًا لا رجعة فيه، أما الصحة النفسية فهي تحت الضغط المستمر بسبب صدمة مستمرة وليس مجرّد حدث عابر.
رغم أن معظم الظروف أو الأحداث تروي لنا التخلّي عن دعم هذه الفئة، فإن بعض المنظَّمات أو الخطط الجديدة حاولت ملء هذا الفراغ، من خلال برامج تمكين مهنيّة وجدّية، وورش تدريب، ومشاريع دعم نفسي ومجتمعي. لكنّها تبقى جهودًا محدودة، لا تلامس حجم المعاناة، ولا تصل إلى كلّ من يحتاجها فعلًا.
اليوم، لا يحتاج الشباب والشابات العرب في هذه البلاد إلى خطاب مكرّر عن "الأمل"، بل إلى من يَعترف بوجعهم، يقدّر صُمودهم، ويمنحهم المساحة ليقودوا بأنفسهم عملية النهوض من جديد.
يحتاجون إلى مشاريع حقيقيّة تنبع من الداخل لا تُفرض من الخارج. برامج يبنيها الشباب بأنفسهم، لا تُبنى عليهم، ولا تُلصَق بهم. برامج تُصاغ وفق وقتهم، وظروفهم، وسياقهم. محتوى شبابي، عربيّ، حيّ، وليس نموذجًا غريبًا مستورَدًا.
عندما تُؤمن بأن مؤسّستك تتنفّس الشباب، وأن رؤيتك المهنية تشاركيّة، يحضر فيها الشباب كفئة صانعة للقرار، لا فقط كموضوع للمشروع – عندها فقط تبدأ الأمور بالتغيّر.
نحن بحاجة لمن يسمعهم حقًّا. لمن يمنحهم المساحة كي يصنعوا التّغيير بأيديهم.
عندما تنتظرهم لبناء الخطة السنوية،
عندما تضيف عشرات المَضامين التي وُلدت من أصواتهم،
عندما تمحو عشرات السطور التي لم تَعد تعبّر عنهم،
عندما تُعيد بلورة برنامج الساعات والأيام أكثر من مرّة لأن السياق تغيّر وهم تغيّروا.
عندما تَذهب إليهم أنت – لا تنتظرهم أن يأتوا إليك،
عندما تخرج إلى الميدان، إلى أزقة البلد، إلى متنزّهاتها المهمّشة وزواياها المنسيّة، وتخاطبهم كإنسان أولًا، وكمهني شغوف ثانيًا،
عندما تقول لهم: "لديكم القوة، وخصوبة العطاء، والهوية، والانتماء. تعالوا. شاركوا. أنتم الأمل، لا موضوعه"،
عندما لا تتنازل عنهم بسهولة،
عندما تصبح المكالمات والرسائل اليومية فعل محبة لا تمسّ بالكرامة،
عندما يصبح المهنيّ الحقيقي هو من حاول ألف مرّة، لا من استلم مجموعة "جاهزة" نصفها يداوم في ثلث مشاريع البلدة الأخرى –
عندها فقط يبدأ الشباب بالحضور الحقيقي.
عندها ربما تبدأ أنت بوضع حدّ لعدد الأيام المتاحة لهم، وتقول:
"يكفينا ثلاثة أيام يا شباب، بدنا نشتغل!"
بدلًا من أن تقنع نفسك بأن خمس ساعات لقاء – ساعة منها فعليّة – قد تُحدث التّغيير.
نحن كمجتمع نحتاج إلى سياسات تُبنى معهم لا لهم، إلى فرص تُخلق في بيئاتهم المحلية، لا في عواصم العالم البَعيد. يحتاج الشباب والشابات إلى تعليم عصري، وإلى شبكة حماية اجتماعية واقتصادية، حتى لا يُضطروا كلّ مرة للاختيار بين الموت أو الهجرة.
في النهاية، الحرب تغيّر كلّ شيء. لكنّها لا تستطيع قتل الحلم إذا وُجد من يَسقيه. والشباب العرب في هذه البلاد، رغم الجراح، لا يزال يحتفظ ببذرة الحلم. هذا الجيل، الذي وُلد أو كبر في قلب واقع مؤلم وغير عادل، لا يعرف إلا أن يقاتل من أجل البقاء، ليس فقط كأفراد، بل كَصانعي مستقبَل.
شباب صمدوا رغم "الألغام"، ويواصلون رغم كلّ شيء—يبحثون عن فرصة، عن صوت، عن معنى، وعن مستقبل. هذا الجيل، وإن تربّى وسط الظلام، لا يعيش بلا أمل كليًّا. إنه يحمل بذور النهوض، وهي بحاجة فقط لمن يسقيها.
إذا أردنا مستقبلًا أفضل، فعلينا أن نبدأ من هؤلاء. من الشبان والشابات الذين، رغم كل ما فقدوه، ما زالوا يحاولون كلّ صباح أن يثبتوا أنهم يستحقون حياة كريمة، وأنهم ليسوا مجرّد أرقام في تقارير العنف والجريمة أو غير المؤطّرين أو صور في نشرات الأخبار، بل أرواح حيّة، نابضة، تنبض بالحياة والإرادة.

حنان شحادة
أخصائية اجتماعية، وناشطة مجتمعيّة.