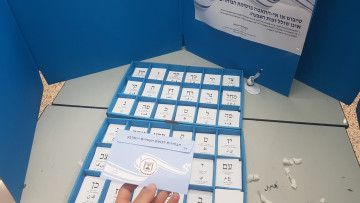"كلّ واحد وعفريته".. مشاهد من طفولة صحراوية

كان الزرعُ طويلا الى درجة أنّه يخفي قامتي تماماً، كنتُ في الرابعة أو الخامسة من عمري، أتجولُ صباحاً في مدينة كاملة من سنابل القمح، لوني اصطبغ بلونها، بتّ قمحيّا منذ بدأت رحلتي في ممرّات مدينة السنابل القمحيّة، أسمع أحياناً والدتي فاطمة تناديني حيث كان صوتها يتشتّتُ من بعيد في شوارع مدينة السنابل، سعدي كانوا ينادونني، عدتّ من رحلتي القمحيّة قبل المغيب بقليل، خرجت من المدينة القمحية التي غزاها القمر ليلا واتخذ لونها لون القمح وأضاء القمر سهوبها القمحيّة، كان عشائي من الخبز والمرق اتخذ لوناًّ قمحياً، أما فراشي أمام الخيمة فكان قمحياً يشطفه ضوء القمر، والدي ووالدتي، أخواتي السبع الواقفات حولي كالأقمار باتوا قمحيين تماما. اللّيل القمريِّ البهيج كلّه أصبح قمحيّاً، خيمتنا المهترئة أصبحت قمحية هي الأخرى، استحال العالم كلّه الى اللونِ القمحيٍّ، كنت افركُ عينيّ بينما استرق النظرات الى العالم القمحيِّ من تحت لحافي بين أخواتي ، أصبت بعماء قمحي قمريّ مما يذكرّني الآن بالعماء الحليبي الأبيض لشخصيات رواية العمى لجوزيه ساراماجو، في الصباح تلاشت قمحية العالم، عادت الألوان الى أمكنتها، هرعت الى أرضنا ولم أجد اثرا لمدينة السنابل، منذ أن عادت الألوان إلى قواعدها أصبحت مدينة السنابل أثراً بعد عين، عمري الآن خمسٌ وأربعون من الأعوام وما زلت أبحثُ كلَّ صباحٍ عن مدينةِ السنابلِ القمحيِّة في الأرضِ الرمليةِ التي أخفت سَنابلَ القمحِ فيها قامتي ذاتَ يوم.
في الطريق
الطريق الى المدرسة كانت معرضاً متحركاً يتراقص في ذاكرتي الآن، كنت أرى المعارك الصغيرة البريئة بين الطلّاب، أرهفُ السمعَ إلى أخبارِ رسائلِ الغرام المكتوبة بخطّ رشيق على الورق، الملاسنات الشعرية لأشعار عنترة وامرؤ القيس، الحرب الباردة ورعونة المعسكر الغربيّ و""شهامة"" الاتحاد السوفييتي مع العرب.
أتذكّر الأغاني الحزينة التي تصدح بها حنجرة الطالب النحيل صاحب الحقيبة الدبلوماسية، عصافير الدوري التي تطير من حولنا في الطريق والتي تشاركنا حفلتنا الصباحية المتنقلة، كانت الطريق تطول وتطول لتتسع لمغامراتنا الصباحية.
أمّا طريقُ العودةِ فكان مُتجهّما تعلو فيه أصواتُ الصِبيةِ وتحتدم فيه مشاعر الغضب والعصبيّة وترتفع الأصوات الحادة والجارحة ويرتفع غبار الشجارات الدّامية، الأرض تتحوّل إلى زوبعة متحركة، تترنّح الجبال المطليّة بالسّراب الهارب من القيظ الحارق. حرارة الصحراء عند الظهيرة والعطش تبدّل رهافة الصباح واعتدال المزاج النديّ وخفته الى عبءٍ ثقيل مُحمّل بالغطرسة الصبيانية وقسوة الصحراء وعطشها الأبديّ للحياة.
لقاء الصحراء والأم
نركضُ أنا وأخواتي بين الوديان ونقفز من حجرٍ إلى حجرٍ في الأرض الصخرية المحيطة بالخيمة، كنا نركض كالماعز المتمرّسة في الحياة الصحراوية، بدا ذلك العالم الضبابيّ في عيون الذّاكرة لا نهائياً، يَبدأُ من خيمتنا ولا ينتهي، كانت الرمال تُغطّي غَربيّ العالم حيثُ تهبط طائرات الجيش الإسرائيلي أثناء التدريبات وتُغطّس الأفق بالأتربة الطائرة، والشمسُ عجوزٌ شمطاء، كم كنّا نخاف طغيانها اللّاهب ساعة الظهيرة فوق رؤوسنا، والدتي فاطمة لم تعرف القراءة والكتابة ولكنّ قصصها التي أخذتها عن والدها الذي أخذها عن والده عن جدّه المغامر الأول هي مدرستي الأدبية الأولى ومذهبي الفني اللامعقول والعبثي والواقعيّ السحريّ الذي احتفى بالغيلان والسحرة والجان المردة، أما أغانيها التي علّلت ليالينا الطويلة فكانت درسي الأول في فنّ الشعر، لم أدرس الأدب ولا اللّغة في الجامعة، كُنتُ خِرّيجَ مدرسةِ فاطمة للشعر والقصّة والغناء الشجيّ في ليالي الصحراء الطويلة.
كنت الذّكر الوحيد بين الأخوات، سعدٌ واحدٌ هو عمودُ البيت، كان الحلم العائلي ان أحمل أعباء الخيمة على ظهري وأقود قافلة البنات وأشقّ بِعصايَ بَحرَ الحياة لأصُدَّ رياحها العاتية على ظهر مركب العائلة المتهالك. سقطتُ في كُلٍّ ذلك بدرجة ممتاز حتّى انّه لا يُعوّل عليّ في إصلاح لمبة في البيت، لم أحمل شيئاً على ظهري سوى الكُتب، كنتُ صَبيَا منزويا ومتواريا وراء صدى آيات تنبعث من المذياع وأغنيات عبد الوهاب وسيد درويش وأم كلثوم والبرنامج الثقافي في إذاعة القاهرة، لم امتلك أيِّ من مهارات الحياة اليوميّة كم توقّع الجميع، كنت خائبا وميؤوسا منّي في شؤون الحياة وما زلت كذلك، بينما غَرِقتُ في تفاصيل الحياة اليوميّة للغة.
كلُّ واحدٍ وعَفريتهُ الخاص!
في الصحراء كما في الصحراء لم يكن هنالك وقت، في الصحراء تسود حالة اللّا وقت. أنا وأخواتي السبع ""نستعمر"" أحد الوديان في عالمنا السّاحر ذاك ونصنع العرائس من العيدان وقطع القماش المرميّة في الوادي والسيارات ذات العجلات الصغيرة المصنوعة من علب رُبِّ البندورة، نلعب دون أدنى انتباه أو وعي لشيء اسمه الوقت، صوت فاطمة كان يطرق آذاننا الهائمة في عوالم سحريّة ""تعالوا يللّا يا يمه الشمس غابت) هذا النداء القصير والحازم والذي تعبث في ذبذباته ريح الصحراء الباردة عند المغيب كان كفيلا بجعلنا ننسحب من الوادي غير آبهين بمنجزاتنا الصغيرة الملونة من العرائس والسيارات.
وماذا يحدث للصحراء في الليل؟ فضلاً عن أغاني الرعاة الحزينة الآتية من المضارب البعيدة حيث الجلوس حول شعلة النار المتلألئة (ما زلتُ أذكرُ جملة جدّي عند المساء: ولِّع النَّار يا ولد) أيًّ سحرٍ لهذهِ الكلمات استحضره الآن بعيونٍ وآذان شبه استشراقيه بعد أن اندثرت حفرة النار وانطفأت جذوة اللغة الصحراويّة بما يكتنفها من سحرٍ، وفِتنةٍ وطعمٍ ورائحة. لا تستطيعُ اللغة أحياناً أن تفعل شيئاً حِيالَ حالةِ الاندثارِ العامّةِ التي تسودُ حياتَنا الآن. رُبّما عَجزُ اللّغةِ ونقصُهَا الدائمِ هو غايةُ جمالِهَا ومبعثُ الحاجةِ الماسّةِ للبحثِ الدائمِ عن المعنى.
الصحراء في الليل هي بيت الأرواح الكبير، يُمنعُ علينا الخروجُ في اللّيلِ اتقاءً لشُرورِ الجن، هكذا كانت تأمرنا فاطمة، في اللّيلِ تخرجُ الأرواحُ الشريرةُ والعفاريتِ من أمكنتها وتَفرِضُ سيطرتَها على أرجاءِ مَمْلكةِ اللّيلِ العُظمى (يذكّرني هذا بما كتبهُ طهَ حُسين في كتابهِ السير ذاتي ""الأيام"" حولَ خوفِ الطفلِ الشّديدِ منَ العفاريت عندما ينام فيشُدُّ اللّحافَ ويتغطّى به جَيِّداً خوفاً من العفاريت) والعفاريت لها شعبيةً خاصّةً عندنا، تحذيراتُ فاطمة من الجنِّ ساعةَ الغُروبِ خاصّةً تُحيلُ على أسطورةِ وادي عبقر وشيطانِ الشعرِ الّذي يُلازمُ الشّاعرَ العربيَّ القديمَ ويُملي عليه قصائدهُ. في الفنّ والحياة (وما أشبههما) في النّومِ واليقظة عالم العفاريت حاضرٌ وبقوةٍ وكلُّ واحدٍ منّا لديهِ عفاريتهُ الخاصّة!
تصوير: وليد العبره.