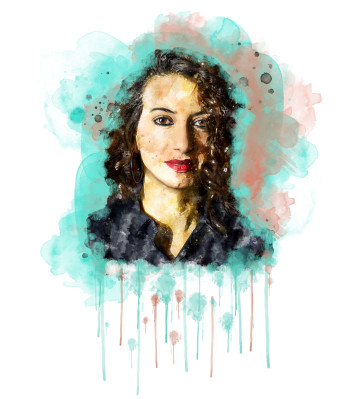عصر ما -بعد- الحقيقة، أزمة الإدراك وصراعات القوة في المجتمعات البشرية

يدّعي العديد من الفلاسفة بأننا نعيش اليوم في عصر ما-بعد-الحقيقة (Post-Truth)، وقد أعطِيَ هذا المصطلح المصطنع الكثير من الاهتمام في العقد الأخير، حيث إن قاموس أوكسفورد نعت المصطلح كلمة السنة لعام 2016. وقد منح مجمع اللغة الألماني هذا المصطلح (postfaktisch) منصب مصطلح العام في 2016 أيضا. ولهذا للمصطلح العديد من المعاني من أهمها أنه لا يعني عكس الحقيقة وإنما كما ادعى مجمع اللغة الألمانية يؤشر إلى فقدان مكانة الحقائق وازدياد الأكاذيب وارتفاع أهمية المشاعر في الخطاب العام، وخصوصا في وسائل الإعلام. يؤشر هذا النعت لهذا المصطلح على أن هنالك تحوّلا جاريا في التعامل مع الحقيقة في الحيز العام، حيث إن المؤسستين المرموقتين، أي أكسفورد ومجمع اللغة الألماني، تعبّران عن امتعاض من هذا التطور. ولكن من أجل التعمق بعض الشيء في دلالات هذا التطور وربطه بالمناسبة التي دفعت بالتعامل معه في هذا السياق، ألا وهي الاحتفاء غير الرسمي بالكذب في أول نيسان، لا بد من التساؤل حول دوافع الاحتفاء بالكذب وبالتالي استحضار وجوده كخدعة تهكمية من جهة وتغييب وجوده كجانب مركزي في المجتمعات البشرية من جهة أخرى. المتّبع هو أن يتم التأشير على الأول من نيسان كيوم متاح فيه الكذب ولو من أجل الدعابة ومن باب المزاح، بالرغم من أن أصوله تتعلق بالخداع، حيث يتم ربطه مع ما قام به البابا غريغوار الثالث عندما قام بتعديل تقويم موعد الاحتفال بعيد رأس السنة في القرن السادس عشر. وبالرغم من عدم وجود إثباتات قاطعة حول ذلك وربط هذا النوع من الاحتفاء بمواعيد استبقت هذا الموعد في بريطانيا وأماكن أخرى في العالم، المهم في الموضوع هو حضور الكذب وتغييب الحقيقة كفعل بشري لا يتم مرة في السنة وإنما جزء لا يتجزأ من يوميات المجتمعات الإنسانية. وللأول من نيسان دلالات متنوعة في عصر يتم فيه الحديث عن ""حقائق بديلة"" و""أخبار مصطنعة""، يضطرنا التعمق بعض الشيء في هذا الموضوع وتبعاته، خصوصا عند الحديث عن ذلك في عصر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلام المحوسب والخوارزميات.
هنالك مقولة مشهور للأديب التشيكي فرانز كافكا يقول فيها ""إنه من الصعب أن نقول الحقيقة، وذلك لأنه وبالرغم أن هنالك حقيقة واحدة، إلا أنها حية ولهذا فلها وجه حي ومتغيّر"". من الجائز القول بأنه لهذا السبب شغلت الحقيقة البشرية منذ نشأة الفلسفة، خصوصا في العصر اليوناني، حيث إن البحث عن الحقيقة تحوّل إلى هدف مركزي، بعد أن موضعه أفلاطون في مركز فلسفته الميتافيزيقية مقابل نسبية الحقائق في فكر بعض سفسطائيي زمانه. والبحث عن الحقيقة في كل مناحي الوجود والوعي البشري تحوّل إلى رحلة ""بطلها"" العلم الحديث، الذي من خلال تطويره اعتقد البعض أن الطريق للحقيقة مفتوحة، إلا أن الخلافات حول الأساليب الصحيحة لاستقصاء الحقيقة والصراعات الجارية في فلسفة الإدراك وعلى رأسها الخلاف بين النظريات الوضعية وآليات الاستدلال والاستقراء والنظريات الدلالية وعلى رأسها الهرمنويطيقا أظهرت بأن للحقيقة وجوها متعددة تتطلب التمحيص والتوافق حول ماهيتها وآليات الوصل إليها، مع الإبقاء على افتراض استمرار وجودها.
ولكن هذا النقاش الطويل لا يمكن أن يغيّب عن أنظارنا مركزية التساؤل حول ثنائية الحقيقة مع غيابها أي الزيّف أو الكذب أو الاحتيال أو المكر أو الخداع أو الغدر وما إلى ذلك. والاحتفاء في الكذب في أول نيسان يستدعي التنويه إلى أن عدم قول الحقيقة جزء محوري في السلوك الإنساني وبأن إحصائيات عصرنا تدل على أن الانسان يكذب بالمعدل مرة أو مرتين في اليوم ويتم الكذب عليه بين عشر ومئتي مرة باليوم. وبالرغم من أن هنالك اختلاف في الوزن النوعي للكذب، إلا أن مجرد وجوده كجزء مركزي في حياة الانسان اليومية تعني بأن التزام الحقيقة يتصادم مع العديد من الاعتبارات ومنها التغطية على سلوكيات لا تعتبر مقبولة أو الالتفاف على نمط حياة أو سجالات معهودة أو الخجل من القيام بعمل معين يمكن له أن يؤدي على ردود فعل غير محمودة. كل هذه الادعاءات وبالرغم انها متعددة الأوجه إلا أنها تستحضر متافيزيقيا الحقيقة، أي أن قول الحقيقة أو المقال الفصل حسب مصطلحات أبو الوليد ابن رشد هي العادة الملزمة والبحث عن حقيقة الأمور تعتبر هدفا ساميا ترقى إليه البشرية جمعاء.
لا يغيّب هذا أربع مواضيع لا بد التطرق لهم في هذا السياق. الأول هو إسقاطات ثنائيات الحقيقة وعكسها، حيث أن مجرد حصر التفكير في مصطلحات ثنائية مثل الحقيقة والكذب أو الصدق والتزييف وما إلى ذلك هي نوع من التعنيف الإدراكي لأنه يلزمنا بالتقوقع في ثنائيات ليست خارجة عن بعضها فحسب وإنما تنفي بعضها البعض ولا تفسح المجال لأنطولوجيا متعددة الاطياف، حيث أن الحقيقة وعكسها يتضمن واحدهما الآخر وليس هنالك إمكانية إدراكية لافتراض واحدها بدون نقيضه. فمقولة نزار قباني ""إني خيرتك فاختاري.. فجبن ألا تختاري...لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار"" هي ادعاء تعسفي لا يتيح المجال ليس فقط الخروج من قفص هذه الثنائية وكأنه لا توجد مناطق متعددة يمكن اختيارها وهنالك العديد من الألوان تقع بين الأسود والأبيض وإنما لأن لا معنى للجنة إذا لم تشمل النار وذلك من الباب المجازي وليس الفقهي، كما يمكن الاستدلال من المصطلحات المأخوذة من الفكر الديني. أهمية تفكيك هذه الثنائية لا تنبع من فتح المجال على إمكانيات أخرى بالمعنى الحرفي، وإنما لأنها تتضمن فتح أفق التفكير في بدائل عديدة لا تحتكم للثنائية القسرية ولتبعدنا عن إمكانية احتكار الحقيقة من قبل قوى اجتماعية أو سياسية أو دينية معينة من مصلحتها أن تتكلم باسم الحقيقة ومن أجل ذلك تسحب الشرعية عن أي بديل لها باعتباره منافي للحقيقة، دون إعارة اهتمام لنوعيته.
يأتي بنا هذا إلى الموضوع الثاني هو أن الكذب لا يمكن اعتباره الاستثناء في التاريخ البشري، لا ميتافيزيقيًا ولا وضعيا، حيث إن عدم قول الحقيقة كان وما زال جزءا لا يتجزأ من التفكير البشري وهو يكرس ويوظف بشكل دائم في خدمة مآرب أو تحقيق أهداف معينة. هنالك عدة أنواع من عدم قول الحقيقة لا يمكن التطرق إليها جميعها في هذا السياق. ولكن من المهم التنويه هنا إلى المقولة الشهيرة للملك سليمان الحكيم بحسب سفر الأمثال في التوراة، حيث قال ""كون الأفكار بواسطة الاستشارة وبالاحتيال قم بالحرب"". هذه المقولة تذكر بمصداقية الكذب والاحتيال في حال تم توظيفها من أجل هدف يعتبر اضطراريا أو له أهمية استراتيجية مثل حالات الحرب. وقد ثبت عن النبي محمد قوله بحسب أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط ""لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل وامرأته والمرأة وزوجها"".
والخداع والغدر والاحتيال والتي يمكن اعتبارها منافية لقول الحقيقة، والتي تطرح كنمط سلوكي جائز منذ آدم وحواء تحولت إلى جزء من الذكاء الاستراتيجي في حالات الحرب، حيث إن التاريخ البشري يعج بقصص حول قدرة قواد عسكريين بخداع خصومهم من أجل تحقيق النصر في حالات الحرب. وفي كتابه ""الأمير"" يعتق الفيلسوف الإيطالي نيكولو ماكيافيلي الكذب والاحتيال ويحوّله إلى آلية شرعية أساسية في الحفاظ على السيطرة ولولاية والحكم. وقد تحدث عن ذلك المفكر الألماني كارل فون كلاوزوفيتس عندما تحدث عن أهمية الاحتيال من أجل المفاجأة في حالات الحرب. كما تحدث عن ذلك منظّر العلاقات الدولية الحديثة هانس مورغنتاو، الذي وضع أسس النظرية الواقعية في العلاقات الدولة في القرن العشرين، حيث اعتقد بأن طبيعة الانسان صراعية وبالتالي هنالك مواجهة دائمة على القوة ولهذا على الإنسان أن يتجهز للحرب بشكل مستمر. في هذا السياق يشرّع مورغنتاو كل الوسائل، بما في ذلك الخداع والغدر والاحتيال وبالتالي تغييب الحقيقة.
ويأتي بنا هذا إلى الموضوع الثالث وهو يتعلق بطبيعة الحقيقة وعلاقتها بالإدراك وفي هذا السياق لا بد من التساؤل هل الحقيقة حقيقة أم انها مصطنعة؟ هذا التساؤل يعيدنا إلى بداية هذا المقال المقتضب حول البحث عن الحقيقة وكيفية ادراكها في حال وصلنا اليها. أي كيف لنا أن نعرف أننا وصلنا للحقيقة في شأن من، خصوصاً إذا ما اخذنا بعين الاعتبار مقولة كافكا السابقة وقضية الدوافع المتعلقة بصراعات القوة في المجتمعات الإنسانية؟ لا بد لنا هنا التوضيح بأن الحقيقة هي مصطلح بشري ولهذا هي دائمة خاضعة لاعتبارات عديدة من أهمية الإقرار بالمقاييس التي من خلالها يمكن البت فيها. من أجل التوضيح لا بد من طرح نظرية الوعي الزائف كآلية للوقوف عند العلاقة الجوهرية بين الحقيقة والوعي وبأن الأخير هو القادر الوحيد على البت في الحقيقة أي البت في قدرته على امتلاكها وبالتالي فهو قادر على تحديد ماهيتها ومن هنا الاستفراد بها أو صياغتها بشكل مطلق بمصطلحاته الاستثنائية. وبما أن الإدراك مفتوح على مصراعيه لاختلاق نفسه كل مرة من جديد فإن حقيقته متبدلة على شاكلته بالتوالي.
ولا بد هنا من التطرق رابعا لعلاقة الوعي بالدعائية والتنشئة أيضا، حيث إن صقل الوعي هي عملية معقدة من شأنها أن تؤدي إلى اصطناع وعي زائف يعتبر عند أصحابه حقيقة مطلقة، كما برهن لنا ذلك الفيلسوف جان بودريار حول حرب أمريكا في العراق. فاصطناع الحقيقة أصبحت أكثر إتاحة في عصر الإعلام المحوسب ووسائل التواصل الاجتماعية، حيث إن الدعاية والإعلان والتحكم ببث الصور وتأويلاتها من قبل دول قوية أو شركات ضخمة تظهر أن للحقيقة وجوها مختلفة تتعلق بالمصالح وصراعات القوة وبالرغم من ذلك هي تبقى، أي التوق إلى الحقيقة، هاجس إنساني أساسي يوّلد الكثير من الخلافات، ما يدفع بنا إلى محاولة تعريفها كل مرة من جديد من أجل التأكيد على الحاجة لها حتى في عصر ما-بعد-الحقيقة.
وللإجمال يمكن القول بأن للحقيقة وعكسها مكانة محورية في الحياة البشرية والصراع الفكري والسجالي الذي يراوح الحقيقة وادراكها، بين مفهومها المطلق وبين النسبية فيها وبين كونها ميتافيزيقة وبين كونها مجرد توافق إنساني بناء على قواعد قيمية وعقائدية متعددة، ستبقى البشرية تدفع أثمانا باهظة باسم حقيقة تلك أو أخرى. لهذا الحقيقة مهمة ليست كجوهر قيمي نصبو إليه وإنما كآلية إنسانية نحتكم إليها وقت الاختلاف وبالتالي هي تتضمن الكذب ولذلك عليها أن تكون ما-بعد-ميتافيزيقية، أي بشرية تصعد من عندنا إلى السماء وليس العكس.

بروفيسور أمل جمّال
باحث في مجال النظرية السياسية والاتصالاتية المقارنة والفكر السياسي وعمليات الدمقرطة والمجتمع المدني، ومدير فرع الاتصال السياسي في قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب