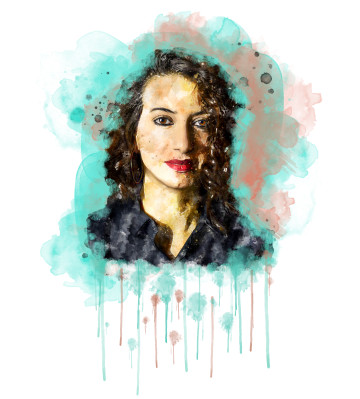الحروف مرايا الجذور..

لا نستطيع أن ننكر أن المشهد الثقافي والفكري في مختلف البلاد العربية ليس في أفضل حالاته، فعلى الرغم من تزايد أعداد معارض الكتاب المقامة وبعض الفعاليات التي ترفع لواء (الثقافة) ومفرداتها إلى جانب إصدار بعض الأعمال من هنا وهناك، إلا أن مستوى ونوعية الإصدارات (الحديثة) والذي يضم أسماء شابة تنشر للمرة الأولى أو أسماء قدمت بعض الأعمال في السنوات الأخيرة رغم تقديرنا لها ولمحاولاتها (بعيدا عن التعميم) يجعلنا ندرك أننا ندور في حلقة مفرغة بين محاكاة التجارب الغربية ومحاولة تعريبها، أو اجترار نجاحات الأسماء المعروفة والمحفورة في الأذهان وإعادة طرح مواضيع (قتلت بحثا) ولم يعد هناك من جديد في طريقة معالجتها أو بخصوصها بشكلٍ عام، وحتى على صعيد الترجمة لم يكن هناك من الاختيارات ما يشكل نقلةً نوعية للمكتبة العربية من حيث الأفكار والأسماء أو حتى الأسلوب أو اللغة أو المفردات، وكنتيجةٍ فعلية على أرض الواقع لم يتم إحراز تقدمٍ يذكر لذا لم نحظَ بإضافةٍ (حقيقية) في هذا العام على المستوى الثقافي والذي لم يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، لكنه أكد لنا مرةً أخرى أننا نهرب بالذاكرة وإليها حيث تظل أعيننا وأفئدتنا تشعر بأن هناك شيئا ما ذو قيمة بين باقةٍ من العناوين الخالدة والأيقونات التي حفرت اسمها ومكانتها في وجدان المتلقي، وساهمت في رفع مستوى وعيه والارتقاء بتفكيره واهتماماته وتطوير لغته مهما كان تحصيله العلمي، والذي لا يحدد بالضرورة مدى تفتحه وثقافته وإدراكه..
ومن هنا كانت الذاكرة العربية تعود باستمرار إلى الكلاسيكيات، وتتماهى مع الماضي بأحداثه ومدنه والأماكن التي كانت في قلب الحدث، ولا شك أن مدينةً عريقة مثل بيروت والتي عاصرت الجيل الذهبي من المثقفين العرب، وكانت محط أنظارهم واهتمامهم واختيارهم لاحتضان أعمالهم وأحدث إصداراتهم، كما كانت ملتقى لمختلف التيارات والوجوه والأصوات ومصدر حراكٍ حقيقي على مختلف الأصعدة لا يعطي للثقافة قيمتها وحسب بل يكسبها بريقا من نوعٍ خاص لا تعطيه مدينةٌ أخرى مثلها، فكانت مطابعها الأهم على مستوى بلادنا وهذا ما كان ينعكس على جودة الإصدارات شكلا ومضمونا وتصميما عدا عن جودة الورق والحرفية في التعامل مع الكتاب، ما يضفي عليه ألقا وسحرا يجعله من أوائل الأشياء التي تتبادر إلى الأذهان عند ذكر بيروت كدرةٍ من درر الثقافة في العالم العربي إلى جانب عددٍ كبير من المدن على امتداد بلادنا التي يمتاز كلٌّ منها ببصمته الخاصة.
ولذلك وبرغم الوضع الحالي الصعب في لبنان، قفزت بيروت مجددا إلى الواجهة في هذا العام مطلع شهر آب/ أغسطس بعد عامين على حادث انفجار مرفأ بيروت المروع في الشهر نفسه من عام ٢٠٢٠، وتعرضت إلى انتكاسةٍ شكلت الحدث الثقافي الأبرز والذي تمثل في إغلاق فرع أسواق بيروت لمكتبة (أنطون هاشيت) أحد معالم الثقافة اللبنانية الأدبية الذي حضن القرّاء والكًتّاب والكتب ونوادي القراءة والندوات والتواقيع، وقد تزامن ذلك الحدث أيضا مع إغلاق فرع (مكتبة مروي) الشهيرة والتي تأسست في نهاية الستينيات من القرن الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن سبقها إغلاق عدة مكتبات في سوريا ولبنان، وهو ما تسبب بخيبةٍ كبيرة حتى لمن لا يملكون أي اهتماماتٍ ثقافية كونهم شعروا بأنهم يتجردون تباعا من ذكرياتهم، وذاكرتهم وهويتهم التي ساهمت هذه الصروح وغيرها في تشكيلها، فوسط الواقع الضبابي الذي تعيشه بلادنا أصبحت هناك حالة من النزوح الجماعي إلى الماضي هربا من شظايا حاضرنا، من خلال عقد المقارنات بين الأمس واليوم بحثا عن عزاءٍ ما بين بقايا السنوات والصور التي تختزل صداها وحكاياتها ورائحتها في الكتب والمطبوعات والوثائق على اختلاف أنواعها، والتي تشكل الأماكن التي عاصرتها وعايشتها واحتضنتها العمود الفقري لها.
وبلا شك فإن التحول السريع نحو الرقمنة أضر كثيرا بالكتاب الورقي المطبوع الذي لا زال متواجدا في الغرب بالتوازي مع الكتب الإلكترونية والصوتية، لكن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة أجبرت الكثيرين على هذا الخيار حيث أصبحت المكتبات تئن تحت وطأة عدم قدرتها على تأمين جميع الكتب والإصدارات الجديدة من دور النشر العربية رغم قلتها إما لأسبابٍ تتعلق بغلاء أسعارها تبعا لارتفاع أسعار الورق وزيادة تكاليف الشحن، أو عدم قدرة القراء على شرائها بعد أن أصبحت الكتب من الكماليات في ظل وجود كفاحٍ حقيقي لتأمين أساسيات العيش الكريم حيث قد يلجأ البعض إلى النسخ الإلكترونية المقرصنة والمتاحة مجانا عبر مواقع الإنترنت وإن كانت بجودةٍ منخفضة، أو قد يقرأ النسخ المتوفرة ضمن مجموعةٍ كبيرة من الإصدارات بسعرٍ أقل نسبيا عبر التطبيقات والمواقع المتخصصة في عرض الكتب الإلكترونية والصوتية، أو ربما لأن بعض هذه الكتب ممنوعة.
مما ينذر بكارثة ثقافية ستعيشها الأجيال القادمة في ظل تجردنا بشكلٍ تدريجي وسريع من جذورنا وتاريخنا وأبسط تفاصيلنا كشعوب، ومن كل المقومات التي كانت تميزنا وتعمل بمثابة صمام الأمان الذي يحمينا من التأثر بكافة الموجات الوافدة علينا تحت مسمياتٍ مختلفة، فعندما لا يجد أطفال الغد ما يقرأونه بلغتهم الأم إلى جانب اختفاء الكتاب نفسه واختفاء المكان الذي كان يباع فيه فإننا نصادر ذاكرتهم ونتركهم في هذا العالم دون مناعة، دون سلاح، دون فكر، ودون سقفٍ حضاري يحميهم، حيث ستصبح مدنهم عاريةً تماما ليصير اقتلاعهم منها أكثر سهولةً ويسرا في ظل تسطيح العلاقة معها بدلاً من تقويتها وتدعيمها، فعلاقة الإنسان بالمكان هي علاقة حيوية بالغة الأهمية بالنسبة لكليهما بكامل مكوناتها وأركانها وهي الضامن لاستمرار وجودهما، وتراجعها يشبه انتزاع الأشجار التي أطعمتنا من تربتها واستبدالها بالبنايات الإسمنتية الشاهقة الصماء التي سلبنا وجودها الظل والغذاء والذاكرة والعاطفة والأمان دون أن نعي أن الحروف مرايا الجذور..
كاتب المقال: خالد جهاد وهو كاتب وشاعر فلسطيني - أردني، له مقالات متنوعة في الشأن الثقافي والاجتماعي.