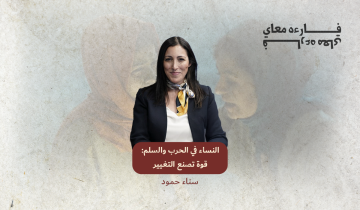بَين البَقاء والتّحوُّل: هَل تَتركنا الحَرب كَما نَحن؟

يتناول هذا المقال تأثير الحرب على الهويّة الأنثويّة، وكيفَ تُعيد الصَدَمات تشكيل النساء بطرق تتجاوز النَجاة الجسدية، لتمتد إلى أعماق الذّات. يسلّط المقال مِن خلال استكشاف التغيرات النفسية، والعاطفية، والاجتماعية التي تواجهها النساء في ظلّ الصراع، الضَوء على التحوّلات القسريّة التي تفرضها الحرب، ليس فقط على أدوارهن، بل على إحساسهن بذواتهن. كما يتطرق إلى هشاشة الهويّة الذكوريّة في مواجهة العَجز، وتأثير ذلك على النساء اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة مسؤوليات جديدة. في النهاية، يطرح المقال تساؤلًا عميقًا: هل تتركنا الحرب كما نَحن، أم أنها تعيد تَشكيلنا بطرق لا يمكن التنبؤ بها؟
يسعى الإنسان إلى تجاهل الموت أو الهرب منه من خلال العَيش بكلّ أنواعه، بداية من إيجاد المَعنى وانتهاء بالاستهلاك النّازع لكلّ معاني التواصل الإنساني مع ذاته والآخر. لكن الحرب تَجلِب عُنوةً الموت الذي يصبح كابوسًا يوقف حياة الناس ولا يتوقّف. في ظلّ الحروب، لا تتغيّر الخرائط السياسية والعسكرية فقط، بل تتغير الهويّات، تَتصدّع، تُعاد صياغتها قسرًا، أو أنها تنهار تمامًا. بالنسبة للنساء، تصبح الحرب اختبارًا مزدوجًا: هل يمكن أن ينجو المرء دون أن يفقد نَفَسه أو هويّته؟
في أوقات الحَرب، تتحوّل المنازل إلى سُجون نفسيّة، فَضاءٍ مُغلق مَشحون بالخوف والقلق، حيث تجد الأمّهات أنفسهن مُحاصرات بين مسؤوليّات عاطفية ومادية متزايدة تتعلّق باللجوء والبَقاء. تتصاعد غريزة الحِماية كردّ فِعل طبيعي لمواجهة الخطر، فتتحوّل إلى حالة مِن التيقّظ الدائم، حيث تُستنفَر كلّ الموارد العقلية والجسدية لضمان الأمان والاستقرار. في هذه اللحظات الحَرجة، يتكيّف العقل مع الضغوط عبر تعزيز استراتيجيّات البقاء، فيدخل في حالة التّأهب المستمر، مما يدفع الأم إلى تبني أدوارٍ تتجاوز الرّعاية التقليدية، فتُصبح أكثر صلابة، وأكثر قُدرة على التّدبير، وأحيانًا أكثر حزمًا. يحدث هذا التكيّف بوعي أو بدونه، إذ يتحفّز الجهاز العصبي المسؤول عن الاستجابة للخطر، مما يجعل ردود الفعل أكثر حدّة بين يقظة مستمرة، وانفجارات عاطفيّة ونوبات غضب نتيجة الإرهاق والتوتّر المُزمِن. لذلك، أولاً قد تُعاني الأمّهات مِن مُشكلات في النّوم أو صُعوبات ذهنيّة كالتركيز والتّذكّر، وثانيًا، قد يلجأ بعضهن إلى العصبيّة والانفعالات الحادّة، بينما قد تنحَرِف أخريات نحو العنف اللفظي أو الجَسَدي في محاولات لا واعية لاستعادة السّيطرة المفقودة. في ظل هذه الفوضى، لا تتحطم الهويّة فحسب، بل يُعاد تشكيلها في مزيج مُربك من القسوة واللين، والصلابة والهشاشة.
ليست الهويّة الأنثويّة مجرّد بناء ثقافي، بل هي تكوين نفسي واجتماعي وبيولوجي يتداخَل فيه المَوروث الفِطري مع التجارب الحياتية. فهي تتشكل عبر مراحل الحياة من خلال الرعاية، والعاطفة، والارتباط بالجسد، لكنّ الحرب تجبِر النساء على التكيّف بطرق لا تتناسب مع الصورة النمطيّة للأنوثة. فالمرأة التي كانت تَجِد هويّتها في اللين والاحتضان، تجد نفسها الآن مضطّرة إلى تبني سمات القوة، والتحكّم، وحتى القسوة أحيانًا كدرع يحميها ويَحمي من تُحِب. هذا التحوّل، وإن كان نابعًا من غريزة البقاء، فإنه يترك أثرًا عميقًا على إدراك المرأة لنفسها، حيث تُصبح هويّتها ساحة معركة بين ما كانت عليه، وما يجب أن تَكونه لتنجو.
لكن الحرب لا تُصيب النساء وَحدهنّ، بل تمتد آثارها إلى الرجال، فَتُزعزِع أسس هويّتهم وتعيد تشكيلها بطرق مركّبة. الرجل، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الحامي، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع العَجْز، حيث تنهار الأدوار التي بُنيت عليها صورته الذاتيّة عبر الأجيال. كيف يستمر الرجل في دوره التقليدي إذا لم يكن قادرًا على حماية أُسرَته، أو حتى نفسه؟ تَخلقُ هذه المواجهة القسريّة مع الضعف شعورًا بالانكسار العميق، يتجلّى في صَمت ثقيل، وانهيارات غير مرئية، ورِجال يمشون بأجسادهم لكن أرواحهم باتت عالقة في اللحظة التي فقدوا فيها السيطرة.
في الحرب، لا تعود هويّة الرجل كما كانت، بل تَدْخل في مرحلة إعادة تشكيل قد تأخُذ مسارات متباينة. يجد البعض في الفقدان فرصة لإعادة تعريف معنى القوة والمرونة، بينما يواجه آخرون انهيارًا نفسيًا يقود إلى الانعزال أو العنف. يَختار الرجال في بعض الحالات الانطواء كآلية دفاعية ضد الإحساس بالعجز، بينما في حالات أخرى، تتخذ إعادة التكيّف شكلًا أكثر تطرفًا، كالسلوك العدوانيّ أو الميل إلى فَرض السّيطرة كتعويض عن الإحساس المفقود بالقُدرة.
لا يَحدث هذا التوتر بين الانكسار وإعادة البناء في فراغ، بل يتأثّر بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي يُملي على الرجل كيف "يجب" أن يكون. في مجتمعات تُغذّي نموذج الرجولة التقليدية القائمة على القوّة المُطْلقة، قد يصبح الفشل في حماية الأسرة تهديدًا جوهريًا لهويّته، مما يزيد من احتمال تطور اضطرابات مثل الاكتئاب، أو اللجوء إلى آليات تأقلم غير صحيّة مثل العنف أو تعاطي المواد. وعلى الجانب الآخر، قد تدفع الحرب بعض الرجال إلى إعادة اكتشاف جوانب جديدة من هويّتهم، تقوم على التعاون، والمرونة، وتَقبل الضعف كجزء من التجربة الإنسانية.
لكن هذا التحوّل في هويّة الرجل لا يحدث في عُزلة، بل يمتد تأثيره مباشرة إلى المرأة، التي تَجد نفسها أمام واقع متغيّر يفرض عليها أعباءً جديدة. عندما ينهار الرجل نفسيًا، أو يَنسحب مِن دَوره، أو يلجأ إلى العنف كوسيلة لاستعادة السيطرة، تصبحُ المرأة المُسؤولة الرئيسة عن الحِفاظ على التّوازن في الأُسرة. في ظلّ هذا الفراغ، تتحوّل النساء من شريكات معتمِدات على دعم متبادل إلى مُعيلات، ومن راعيات للعائلة إلى حاميات لها. يُصبح عليهن اتخاذ قرارات مصيرية، وتأمين الاحتياجات المادية والعاطفية، وفي كثير من الأحيان، التّعامل مع رجل لم يَعُد كما كان، سواء أكان صامتًا وغائبًا أم حاضرًا لكنّه غارق في صراعه الداخلي.
يضع هذا التّغَير القسريّ في الأدوار المرأة أمام معضلة معقّدة: فمن جهة، قد يمنحها الاستقلالية وفرصة الخروج من الأدوار التقليدية، لكنّه من جهة أخرى يُثقلها بعبء لم تكن مُهيأة له، مما يزيد من الضغط النفسي، والإرهاق، والشعور بالوحدة. لم تَعُد النّجاة مسؤولية مشتركة كما كانت، بل أصبحت مسؤولية موزّعة بطريقة غير متكافئة، حيث يُتوقّع من النساء أن يُكملن ما تخلّت عنه المَنظومة الأُسرية والاجتماعية دون أن يُعاد النظر في توزيع المسؤوليات. في النهاية، قد تُعيد النساء تشكيل أنفسهن، لكن بأيّ ثمن؟
لذلك، تترك الحرب أثرًا مضاعفًا على النساء، ليس فقط في الأدوار التي يضطلعن بها، لكن في إدراكهن لذواتهن داخل هذا الواقع الجديد. تصبح الهوية الأنثوية ساحة معركة نفسيّة بين ما كانت عليه المرأة وما أصبحت مُجبَرة على أن تكونه. هذا التّغيير القسري لا يقتصر فقط على تبني صفات جديدة، بل يُجبر النساء على إعادة تعريف ذواتهن في سياق الألم والمعاناة المستمرة.
الألم لا يزول مع انتهاء الحرب. بل يظلّ حاضرًا في الجسد، والذاكرة، والفجوات غير المرئية التي يتركها الفقدان والخوف والتّغيير القَسري. النساء اللواتي أُجبرن على التحوّل من راعيات إلى ناجيات، من أُمّهات إلى حاميات، لا يعُدن كما كُنّ من قَبل. هناك إرهاق مُتراكم لا يمكن التعبير عنه بسهولة، حُزن طويل الأمد يتجذّر في الحياة اليومية، وكأن الحرب لم تترك أثرها فقط على العالم الخارجي، بل تسربت إلى الداخل، لتصبح جزءًا من تكوين الذّات.
إن الألم النفسيّ الناجم عن الصدمة لا يكون دائمًا صاخبًا أو دراميًا، بل يتسلّل إلى التّفاصيل الصغيرة: في صعوبة النوم ليلًا، في استيقاظ الجسد قبل الفَجر بتوتر غير مفهوم، في نوبات البكاء غير المتوقّعة، في الشّرود المفاجئ أثناء أداء المَهام اليومية، في تغيّرات المَزاج المُربِكة والانفعالات الحادة. إنه ألم لا يحتاج إلى جروح ظاهرة ليكون حقيقيًا، بل يكفي أنه يَسرق من النساء إحساسهن السابق بأنفسهن، ويجبرهُن على العيش مع نُسخ جديدة من ذواتهن، أحيانًا أقوى، وأحيانًا أكثر انكسارًا.
وإذا كانت الحرب تُعيد تشكيل الهويّة، فإنها أيضًا تُعيد تشكيل الحُزن. ليس مجرد حُزن على من فُقِد، بل حزن على الذات التي كانت موجودة قبل الحرب. على السيدة التي لم تكن تعرف معنى هذا النّوع من الخوف، على الأم التي لم تكن تعتقد أنها ستجد نفسها تُمسك يد طفلها بيدٍ مرتجفة، على المرأة التي لم تكن تُدرك أن قوتها ستُنتزع منها على شكل مسؤولية لا مفرّ منها. وعلى الجانب الآخر، هناك الرجل الذي لم يَعد كما كان، الرجل الذي اعتاد أن يكون مصدر الأمان، لكنّه بات يشعر بالعجز أمام عالم يتهاوى من حَوله. في بعض الأحيان، يتّخذ هذا الحزن شكل الصمت، وأحيانًا يتحول إلى غضب مكبوت أو انعزال ثقيل. إنه حزن مُعقد، لا يتحدث عن الخسارات الواضحة فقط، بل عن الخَسارات الخفيّة التي لا يراها أحد - خسارة الطمأنينة، وخسارة الأمان الداخلي، وخسارة القدرة على الشعور بالعالم كما كان من قَبل.
في النهاية، ليست المسألة عن النّجاة من الحرب فحسب، بل في التحوّلات العميقة التي تتركها داخلنا. كيف تتغيّر النساء في مواجهة الصدمات، وكيف تعيد التجربة تشكيل الهويّة؟ ليس كشيء يُفقد أو يُستعاد، بل كمسار مستمر من التشكّل وإعادة التعرّف على الذات.
الصورة: للمصوّر - الصحفي بلال خالد.