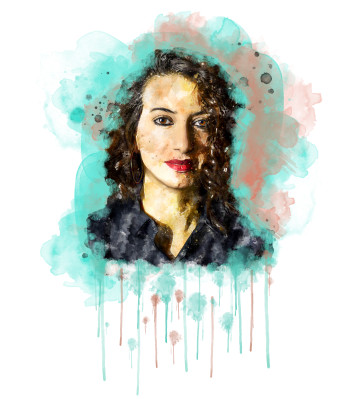المقدسيات بين مطرقة السياسات الاحتلالية وسندان المجتمـع الأبـــوي والثقافة المجتمعية السائدة

كنت في السادسة من عمري عندما اندلعت حرب عام 1967، وعلى الرغم من تجربة عائلتي الصعبة عام 1948 بالنزوح من بيوتها في حي القطمون بالقدس الغربية، وإصرار جدي على عدم مغادرة بيته مجددًا، إلا أننا نزحنا مرة ثانية إلى الأردن نتيجة هول الحرب وتداعياتها، وقد حالفنا الحظ بعد مدة وجيزة لم تتجاوز الشهرين، وبجهود والدي الذي بقي في البلاد، بالعودة إلى القدس قبل ترسيم الحدود مع الأردن بشكل رسمي.
وكمقدسية عاشت معظم حياتها تحت الاحتلال، فقد واكبت منذ الصغر سياساته القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس التي تم ضمها بشكل غير قانوني منذ بداية الاحتلال، ونتج عن ذلك واقع قانوني واجتماعي واقتصادي وسياسي معقد لمدينة القدس مقارنةً مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبمخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص لأنظمة لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، عملت دولة الاحتلال على فرض قوانينها على مدينة القدس وخلق حقائق على الأرض ترسخ الضم القانوني والفعلي للمدينة. ولم تحترم دولة الاحتلال التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضًا، وظلت عبر سنوات الاحتلال الطويلة، وما زالت، تمارس سياسة العقوبات الجماعية، وهدم المنازل، والتضييق على حرية الحركة والتنقل، وسحب الإقامات، والتهجير القسري بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية الصهيونية، وما محاولات الاستيلاء على البيوت في حي الشيخ جراح وبطن الهوى في سلوان، إلا واحدة من سلسلة ممارسات استيطانية توسعية ممنهجة على حساب المقدسيين/ات.
وعلى الرغم من انضمام إسرائيل للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنها ومن خلال التقارير الدولية التي ترفعها للجان المعنية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تمارس سياسة تمييزية، بحيث تطبق هذه الاتفاقيات على مواطنيها من اليهود على حساب المقدسيين والمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وعلى الرغم من كل الانتقادات والملاحظات والتوصيات التي ترفعها اللجان المعنية بانطباق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المختلفة، بما فيها القدس الشرقية، إلا أن دولة الاحتلال تصر على عدم انطباقها، وتمعن في سياساتها التمييزية ونظام الأبرتايد الممنهج ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة عام 1967 والمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
لقد منحت دولة الاحتلال للمواطنين/ات المقدسيين/ات عام 1967 مكانة ""المقيمين الدائمين""، وهي المكانة التي تمنحها إسرائيل عادة للمواطنين الأجانب الذين يختارون المجيء لإسرائيل، ويطلبون العيش فيها، ولم تعاملنا معاملة السكان الأصليين أصحاب الأرض، بل اعتبرت منح المقدسيين/ات حق الإقامة الدائمة امتيازًا وليس حقًا، وأعطت نفسها الحق في سحب هذا الامتياز متى أرادت، وبهذا أصبح بإمكان المقدسيين/ات الإقامة الدائمة وحق السكن والعمل داخل إسرائيل دون الاحتياج لتصاريح خاصة، ومنحتهم امتياز الحصول على الحقوق الاقتصادية وفقًا لقانون التأمين الوطني والتأمين الصحي من خلال منحهم بطاقة الهوية الإسرائيلية (الزرقاء)، إلا أنها تبنت في الوقت نفسه العديد من الإجراءات والقوانين التي كان منها ما يعرف بـ""قانون الدخول إلى إسرائيل"" مثلا، حيث قيّدت من خلاله إمكانية حصول المقدسيين/ات على جمع شمل العائلات بسهولة، ووضعت العديد من الشروط والإجراءات المعقدة، من ضمنها ضرورة الإثبات بأن ""مركز الحياة"" هو مدينة القدس ولمدة سبع سنوات متتالية، وجعلته شرطًا ضروريًا للإبقاء على الهوية المقدسية الزرقاء، وظلت تتبنى سياسات مختلفة ومعقدة تهدف إلى استغلال الهندسة الديمغرافية لصالح السكان اليهود على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، والحد من حقوق الفلسطينيين في مدينتهم.
لقد منعت دولة الاحتلال الفلسطينيين من التمتع بحقهم في اختيار شريك/ة الحياة وجمع شمل العائلات، وقيدت حق المقدسيين/ات في اختيار مكان الإقامة حفاظًا على حقهم/ن في الإقامة، وفرقت بين الأزواج، وشتتت الأسر الفلسطينية ومنعت الأزواج من العيش مع أزواجهم/ن من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة بشكل كبير، في محاولة لسلخ فلسطينيي القدس والفلسطينيين من داخل الخط الأخضر الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، عن امتدادهم الفلسطيني في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبسبب سلسلة من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية، حرمت العديد من العائلات من العيش كأسرة واحدة في بيت واحد في المدينة أو القرية نفسها، أو المكان الذي يختاره الفلسطينيون للعيش فيه، وقيدت حرية الحركة والتنقل من خلال وضع الحواجز العسكرية وبناء جدار الضم والتوسع، وحصرت حق الإقامة في القدس بالسكان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس فقط، وأخرجت بذلك مئات الآلاف من الفلسطينيين المقيميين في أحياء القدس أو على الجانب الآخر من الجدار.
وعلى الرغم من أن السياسات التمييزية الإسرائيلية الممنهجة تؤثر على جميع المقدسيين، إلا أن لها أثرًا مضاعفًا على النساء على وجه التحديد، خاصة النساء اللواتي يحملن وثائق مختلفة ويقطنّ في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجن من مقدسيين، وهن الأكثر تضررًا جراء اعتمادهن بشكل أساسي على أزواجهن لتقديم تصاريح الإقامة الدائمة لهن، تلك التصاريح التي تجدد بشكل دوري كل مدة زمنية تتراوح بين أربعة أشهر وستة، كما أنهن يعتمدن بشكل كبير على أزواجهن في تقديم طلبات جمع شمل العائلات بعد الإثبات أن مكان السكن والإقامة هو داخل حدود بلدية القدس وبعد تقديم عقد زواج رسمي، شريطة التوصية من الجهات الأمنية الإسرائيلية بعدم وجود ""ملف أمني""، ومنحت سلطات الاحتلال نفسها حق سحب الإقامات في حال قام الزوج مثلاً بعملية استشهادية، معاقِبةً بذلك باقي أفراد الأسرة. لقد قامت دولة الاحتلال ومنذ عام 1967 بسحب الإقامات لما يزيد عن 15000 مقدسي/ة منتهجة سياسة العقوبات الجماعية تحت حجج أمنية واهية.
إن قيام دولة الاحتلال بفرض قوانينها على المقدسيين في شتى المجالات، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، انعكس أيضًا على المحاكم التي تنظر في شؤون العائلة. فعلى سبيل المثال يوجد في مدينة القدس المحتلة ثلاث محاكم مختصة بقضايا الأحوال الشخصية، وهي المحكمة الشرعية الإسرائيلية، والمحكمة الشرعية الأردنية، ومحاكم شؤون العائلة الإسرائيلية، وتتميز كل محكمة بإجراءات مختلفة، وتتخذ قرارات مختلفة. وتزداد المسائل تعقيدًا عندما تكون الزوجة من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتعتمد بشكل رئيسي على زوجها في الحصول على تصاريح الإقامة، أو طلبات جمع شمل العائلات، فكثيرًا ما تظل النساء المعنفات في دائرة العنف خوفًا من خسارة الواحدة منهن حقها في الإقامة مع أطفالها في مدينة القدس، أو خوفًا من خسارة حقها في حضانة أطفالها، وبذلك تفضل أن تظل مع معنفها حفاظًا على حقوقها.
كما أن تنازع القوانين واختلافها ما بين مدينة القدس من جهة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية أو قطاع غزة) من جهة أخرى، يحول دون إمكانية تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم خارج مدينة القدس، ما يقلل من فرص النساء في الحصول على حقوقهن عبر التقاضي والوصول إلى العدالة، ويعزز من حل النزاعات بطرق عشائرية أو أسرية كثيرًا ما تكون في غير صالح النساء ضمن إطار مجتمع أبوي لا تكون فيه موازين القوى لصالح النساء.
لقد تعمقت معاناة النساء المتزوجات من مقدسيين خلال جائحة كورونا بشكل كبير، حيث ضاعفت من عزلهن ومعاناتهن النفسية لعدم إمكانية التنقل بين القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة مع توقف إصدار تصاريح الإقامة، ما أدى إلى حرمان النساء من الالتقاء بالأهل والأقارب، وتلقي الخدمات الصحية الضرورية خلال الجائحة، خاصة مع الحجر المنزلي من جهة، وتقييد حرية التنقل مع انتهاء تصاريحهن، وعدم إمكانية تجديدها من جهة أخرى، فزاد ذلك من معاناتهن النفسية والاجتماعية، وزاد من حالات العنف الأسري الذي تتعرض له النساء، وحرمهن من حقهن في الرعاية الصحية والإنجابية، وعمّق من معاناتهن.
حتى النساء المقدسيات اللواتي يقمن في القدس ويمكنهن الاستفادة من القوانين السارية التي فرضها الاحتلال بعد ضمه لمدينة القدس، والمتعلقة بقضايا العنف الأسري مثلاً، يتعرضن لضغوط اجتماعية وأسرية وسياسية بعدم التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية أو التقدم بشكوى إلى شرطة الاحتلال بخصوص العنف الأسري أو طلب الحماية من المؤسسات التابعة لدولة الاحتلال، لأن ذلك غير مقبول اجتماعيًا وأسريًا، وتتهم النساء بالخروج عن ""الصف الوطني""، ما يضطرهن إلى القبول بالأمر الواقع والاستمرار في العيش في دائرة العنف الأسري دون الإفصاح عن معاناتهن أو محاولة الخروج عن صمتهن، وبهذا تجد النساء المقدسيات أنفسهن بين مطرقة الاحتلال وسياساته التمييزية من جهة وسندان المجتمع الأبوي ومفاهيمه الاجتماعية والثقافية البالية التي تعزز دونية المرأة من جهة أخرى.
اليوم، وبعد مرور أكثر من خمسة عقود على الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أتساءل كامرأة عاشت طفولتها وشبابها تحت الاحتلال، وشارفت على سن الشيخوخة، وما زالت تعيش مع الاحتلال، ألا يحق لنا عيش حياة كريمة دون احتلال ودون معاناة مضاعفة جراء سياساته وتداخلها مع النظام الأبوي الذي نعيش؟ لقد علمتني تجربتي أن ذلك التقاطع السياسي والاجتماعي والثقافي يعزز من دونية المرأة في مجتمعنا، ولا خلاص إلا بمعالجة الأسباب الجذرية بإنهاء الاحتلال ومحاربة النظام الأبوي الذي ينتعش ويترعرع في كنف أدوات القمع وغياب الحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
يشار الى ان الصورة المرفقة للايضاح
تصوير: اورن زيف \ موقع سيحا مكوميت"