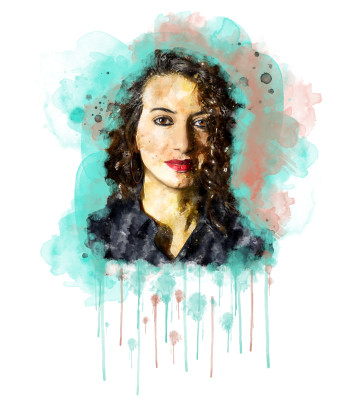المقاطعة كموقف وفعلٍ سياسيّين وجزء من مشروع وطني

النّقاش الجدّيّ حول المشاركة في انتخابات الكنيست أو مقاطعتها يتمحور في جوهره في سؤالين مركزيين تتفرع منهما أسئلة أخرى هامة، سعيًا إلى بلورة الرأي وصياغة الموقف. السّؤال الأوّل هو: لماذا نذهب إلى الكنيست؟ والسؤال الثاني: ما هو ميزان الرّبح والخسارة المتحصّل من المشاركة في الكنيست من جهة، أو من المقاطعة من جهة أخرى؟ سأحاول في هذه المقالة الإجابة عن هذين السؤالين بأقصى ما يمكن من إيجاز.
في الإجابة عن السّؤال الأوّل، يضع المؤيدون أهدافًا يمكن حصرها في: لكي نؤثر ونغيّر، لكي نخدم مجتمعنا، لكي ندافع عن أنفسنا، لكي نُسمِع صوتنا ولكي نحصِّل حقوقنا. في المقابل يطرح مؤيدو المقاطعة أهدافًا مماثلة، لكن من موقع آخر وبوسيلة أخرى يقولون إنها لم توضع موضع التّجربة حتى اليوم، هي التجنيد الجماعي لمقاطعة جماهيريّة شاملة كموقف إجماعيّ أو شبه إجماعيّ. يجدر التنويه هنا، بحقيقة أنَّ مؤيدي المقاطعة كما مؤيدي المشاركة أيضًا يختلفون في مشاربهم الفكريّة، في رؤاهم الوطنيّة وفي اعتباراتهم السّياسية الّتي قد تلتقي وتتقاطع في بعض المحاور والنّقاط وتختلف في أخرى؛ إلى جانب تأكيد حقيقة هامّة أخرى هي أنَّ قطاعًا واسعًا من المقاطعين اليوم هو في أغلبيته الساحقة، مصوتون سابقون لـ ""الأحزاب العربية"".
المقاطعة كما أفهمها، هي موقفٌ سياسيٌ وتجسيدٌ له، هي فعلٌ سياسيٌ له أثره ومداه، ليست موقفًا عاطفيًا أو اجتماعيًا مبنيًا على موقف شخصيّ من حزبٍ ما أو شخصٍ ما أو على العلاقة معهما. المقاطعة كما المشاركة، ينبغي أنّ تكون فعلًا حرًا ومستقلًّا يعبر عن رأي الإنسان الفرد وعن ضميره، قرارًا مبنيًا على قناعات ومحتكمًا إلى حجج واعتبارات، ليس من بينها ""مجاملة"" الغير أو إرضاؤه، من جهة، ولا ""معاقبة"" الغير أو ""الانتقام"" منه، شخصًا كان أم مجموعة / حزبًا، من جهة أخرى.
المقاطعة موقفٌ عقلانيٌّ مبنيٌّ على تحليل الواقع والوقائع وعلى دراسةٍ معمقةٍ لحصيلة تجربةٍ ممتدة على أكثر من ثلاثة وسبعين عامًا، وبكونها كذلك تحتاج مهمّة شرحها والإقناع بصحتهاـ كما تحتاج المشاركة تمامًاـ إلى الحجج والبيّنات، العقليّة والعقلانيّة، بعيدًا عن الغوغائيّة و/ أو اللّعب على المشاعر والغرائز البدائيّة.
لا يقود هذا التّحليل برسم الإجابة عن السّؤالين المركزيين المذكورين إلى استنتاج بعدم جدوى المشاركة في الكنيست فحسب، بل إلى تبيان ضررها الجسيم أيضًا، بالنظر إلى ظروف الأقليّة القوميّة ومكانتها السّياسيّة في هذه الدّولة وظروف شعبها الرّازح تحت الاحتلال.
في الإجابة عن السّؤال المركزيّ الأوّل (وما يُساق من أهداف يُرتجى تحقيقها من خلال الكنيست)، تثبت تجربة ما يزيد عن ثلاثة وسبعين عامًا حقيقة ساطعةً لا يمكن إنكارها أو تغييبها: من غير الممكن تحقيق المطالب والحقوق من خلال الكنيست، حتى لو أحرزت الأحزاب العربيّة أقصى استطاعتها من التّمثيل البرلماني، من غير الممكن تحقيق تغيير جدّي وجوهريّ يُحدث تحولًا ولا أقول انقلابًا، في المكانة السّياسيّة للفلسطينيين في إسرائيل، ثمَّ في واقعهم الحياتي المتأتي عن هذه المكانة طالما أنَّ الدّولة هي ""دولة اليهود"" /""دولة يهوديّة""، من حيث تعريفها القانونيّ في قوانين أساس وقوانين مركزيّة أخرى سبقت ""قانون القوميّة"" بكثير، ومن حيث مرجعياتها الإيديولوجيّة، العِرقيّة والدّينيّة، بكل ما ينبني على هذا التّعريف وهذه المرجعيات وما يشتق منها من سياسات وممارسات.
يعرف كل عضو كنيست عربي أنه حين يؤدي اليمين الدّستوريّة (بنصّها الحرفيّ: ""أتعهد بأنّ أحفظ الولاء لدولة إسرائيل...."")، فإنما هو يقسم بحفظ الولاء للدولة اليهوديّة القوميّة، وفق تعريفها القانوني، وأنّ تغيير هذا التّعريف غير ممكن من خلال الكنيست، وهو ما يعني بالتأكيد أنَّ شعار ""المساواة"" الّذي يطرحه هو شعارٌ خالٍ من أي مضمون، مجرد وَهْم وسراب غير قابل للتحقق. كما يعرف أيضًا أنّ مركّب ""الدّيمقراطيّة"" في تعريف الدّولة (كدولة ""يهوديّة ديمقراطيّة"") هو بدعةٌ وخديعةٌ يستحيل تحققها للعرب طالما بقيت ""دولة يهوديّة"" تتبنى الصّهيونيّة كفكرٍ استعماريّ عنصريّ (وهذا قبل الحديث عن الاحتلال وتناقضه التّناحريّ مع الدّيمقراطيّة).
والحقيقة المؤلمة الّتي يعرفها كل طفل: أنَّ التّمثيل العربيّ في الكنيست لم يمنع يومًا سَنّ قانون عنصريّ واحد، لم يمنع مصادرة دونم واحد من الأراضي العربيّة، لم يمنع هدم بيت عربيّ واحد، لم يمنع قتل شاب عربيّ واحد، بل لم يمنع تعرض أعضاء الكنيست أنفسهم للضرب والمحاكَمَات السّياسيّة؛ ولم يغيِّر شيئًا في المكانة السّياسيّة للعرب في هذه الدّولة.
في ميزان الرّبح والخسارة، نجد في كفة الرّبح: 1. الكنيست منبرٌ لطرح القضايا 2. فوائد ماليّة تجنيها الأحزاب (من التّمويل الرسمي) تتيح لها تمويل أجهزتها ومرتبات محترفيها وعامليها؛ 3. فوائد ماليّة مباشرة يجنيها أعضاء الكنيست ومساعدوهم، فضلًا عن الحصانة البرلمانيّة الّتي توفّر لهم مساحة من الحركة والنّشاط (لكنها مساحة محدودة ومكبلة بالقيود، كما أشرنا). أما في كفة الخسارة فنجد: 1. تستغل إسرائيل مشاركة العرب في عضويّة الكنيست وانتخاباتها لستر عنصريتها وترويج نفسها واحةً ديمقراطيّة في الشّرق الأوسط؛ 2. تُحارب إسرائيل بالعرب ومشاركتهم هذه، حملات المقاطعة الدّولية ضدها (وخصوصًا الـ BDS) على خلفية استمرار الاحتلال والتّقدم نحو نظام الأبرتهايد. وفي سياق هذين البندين، من المعروف أنّ إسرائيل لا يمكن أنّ تتحمّل وضعًا يكون فيه العرب خارج برلمانها (وفق ما تؤكده تصريحات مسؤولين رسميين كُثر وأبحاث عديدة صدرت عن مراكز أبحاث إسرائيلية، لا متسع لعرضها هنا)، 3. أنّ العضويّة في الكنيست و""النضال البرلمانيّ"" لم يعودا آليّةً واحدةً فقط من آليّات النّضال المختلفة المتاحة للفلسطينيين هنا. وحين تحوّل ""النضالُ البرلمانيّ"" إلى المجال الحيويّ الوحيد و ""مَنفس"" الجماهير الأوحد، فقد أصبح عاملًا مُضرًا بأدوات النّضال الأخرى وأدّى إلى ""تصفية عامّة"" وشبهِ تامّة لحضور الأحزاب والقيادات والنّشطاء اليوميّ الفاعل بين النّاس، والمتابعة اللّصيقة لما يَشغل بالَهم من هموم ومشاكل. هكذا حصل الانقطاع بين الأحزاب وجماهيرها حتى أصبحتْ أحزابًا بلا جماهير سوى في المناسبات و""نشاطات الطوارئ""، وحين انكمش هذا الحضورُ حدّ التلاشي انفتحت الأبوابُ على مصاريعها أمام كلّ ما نكابده في مجتمعنا من ظواهر مرَضيّة، اجتماعيًّا وتربويًا وأخلاقيًا.
إزاء واقع استنفاد "العمل البرلماني" طاقات هائلة من الأحزاب والنّاشطين والمثقفين، وخصوصًا في العقود الأخيرة الّتي تتكرَّر فيها الانتخابات بوتائر مذهلة، بينما نحن في أمسّ الحاجة لاستثمار هذه الطاقات على نحو أكثر جدوى وفاعليّة لترميم أوضاعنا والنّهوض بمجتمعنا، فإنَّني أؤمن بأنّ إعادة ترميم الأحزاب وحضورها الجماهيريّ اليوميِّ النّابض يحتاج إلى إعطائها اِستراحةً طويلة من ""النّضال البرلمانيّ"" لكي تعود إلى مجالها الحيويّ الطبيعيّ والشرعيّ، وعندئذ لن يبقى سوى الحزب المتواصل مع الجماهير يوميًا وفعليًّا، وسيكون بالإمكان بناءُ قوّة سياسيّة معبِّرة ومؤثِّرة، نتخلّص بواسطتها من الخلط المريب والمسيء بين ""حزب"" و""قائمة انتخابيّة""؛ وهو ما أضحى بمثابة خيانةٍ ارتكبتها الأحزابُ في حقّ مجتمعها حين طمست التّمايزاتِ الجوهريّة والضّروريّة بين السّياسة كمهنة والسّياسة كرسالة، بتعبير ماكس فيبر، وتخلّت عن دورها كوكيل توعيةٍ وتثوير وتغيير.
في هذا المنظور، ليست المقاطعةُ فقاعةً أو خطوةً منزوعَة السّياق والرّؤية والأهداف، وإنما هي جزءٌ من كُلّ خطوةٌ أولى في ""مشروع وطني"" لا يغفل ""الجانب التمثيليّ""، بل يؤكده ويؤسس عليه ـ التمثيل الأشمل والأعمّ- الأكثر تجسيدًا للإرادة الجمعيّة والأوضح تعبيرًا عنها في إطار ""لجنة متابعة"" (أو تحت اسم آخر أعمق دلالة) يُصار إلى انتخابها بآليات تضمن تجندًا حزبيًا حقيقيًا عكس ما هو قائم اليوم، ومشاركة جماهيريّة أوسع وأكبر بكثير من تلك الّتي تُفرز ""التّمثيل الكنيستيّ"" الّذي أصبح من العته ـ بتعبير آينشتاين ـ انتظار وتوقع نتائج أخرى منه تختلف عن تلك الّتي حققها حتى الآن!
* يعبّر المقال عن وجهة نظر الكاتب/ة وليس بالضرورة عن "فارءة معاي" او القيمين\ات عليها.