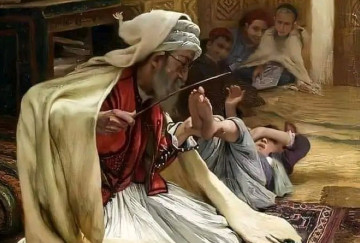جامعة حيفا كمسرح متخيّل لمشهد اليوم التالي

قد يكون تعاطي جميع من سيتناولون الموضوع الذي اختارته هذه النشرة، وهو "التبعات السياسية للحرب ومشهد اليوم التالي"، من باب التحليل أو التكهنات الأكاديمية والسياسية وحسب؛ إذ ليس بمقدور أحد أن يحسب بدقة مآلات هذه الحرب اللعينة، ولا كيف ستتصرف حكومة إسرائيل وحلفاؤها حيال نهاياتها المحتملة؛ لا سيمّا إذا افترضنا أن هدفها الرئيس، غير المعلن، هو تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، كما تشهد عليه تداعياتها الدموية المستمرة في غزة وممارسات الاحتلال واعتداءاته الجارية، بإمعان وبمنهجية في الضفة الغربية، وفق مخططات هذه الحكومة المعلنة منذ اليوم الأول لتشكيلها في نهاية شهر ديسمبر عام 2022.
أقول هذا وأمامنا جملة من التعقيدات والمعطيات الفلسطينية الداخلية المستعصية، والعوامل الخارجية التي تشير الى أن الصراع الدائر، وإن اتسم بمحليته التاريخية، الفلسطينية الإسرائيلية، هو في الواقع تجليات لصراع اقليمي أكبر تخوضه إسرائيل بالنيابة عن أمريكا وحلفائها في العالم ومنطقتنا، ويدفع ثمنه الفلسطينيون بالنيابة عن معسكر "دول الممانعة" وعلى رأسهم تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤها في المنطقة.
لست في صدد الاسترسال في هذه التقدمة، سوى أنني أوردتها كي أميّز بين التبعات السياسية المفترضة للحرب ومشهد اليوم التالي المتخيّل، في منطقه العام والأوسع، وتأثير ذلك على أوضاعنا، نحن المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل؛ ففي حالتنا لا مجال للتكهن ولا للافتراض إذ أنّ المشهد واضح ومحسوم، لا بل كان واضحًا قبل السابع من اكتوبر فصار بعده محسومًا لا لبس فيه ولا رهان عليه.
لا يخفي حكام إسرائيل نواياهم ولا ما يخططونه لمستقبل مواطني الدولة العرب؛ فعنوان سياستهم، المعززة بعقيدة تفوق اليهودية على سائر الأعراق وبرزمة قوانين عنصرية استئصالية اضطهادية قامعة، هو تدجين الأقلية الفلسطينية المنزرعة في أرضها، ولسان حالهم يقول لها بدون تأتأة: "إما أن تقبلوا أقفاصنا وتعيشوا كما عاشت نمور زكريا تامر في يومها العاشر، أو أن تكتبوا معلّقاتكم، ككبار شعرائكم، في السجون أو على "أعواد المشانق"؛ أو ، ربما، أن تكملوا "تغريبة الخيام" وتمضوا على وقع حداتكم نحو الشرق والبحر وإلى المهاجر.
لم نكن بحاجة لهذه الحرب كي ننتظر المشهد في اليوم التالي ولا لحسبة تبعاتها؛ بيد أن برقها أوضح لنا عتمة فضاءاتنا، ورعدها من المفروض أن يصحّينا قبل أن يغرقنا طوفانها. يشعر الكثيرون مثلي بالقلق ويخيفنا هذا التيه الذي نعيش في ظلاله ولا نعرف كيف نواجهه وكأننا نمشي الى الهاوية ورؤوسنا الى الوراء، فلا الطريق واضحة ولا من يقودنا الى النجاة. بعض من بيننا واثقون بدنوّ الفرج، لأن النصر يجب أن يكون لصاحب الحق ولا ينقصنا سوى التفاعل مع “النداء من أجل قيادة فلسطينية موحّدة" الصادر في نهاية شهر كانون الثاني الماضي على هامش الدورة الثانية لمنتدى فلسطين الذي عقد في الدوحة؛ فهيهات! والبعض واثقٌ بالخلاص المجاني لأن السماء عادلة ولن تهجر من يأوي إلى مضاجعها؛ فهيهات! والبعض لا ينجح بالنوم، وعلى عتبات دارهم يعوي الرصاص والذئاب، عاجزين بعد أن زاحوا عن دروب آبائهم وقادتهم المؤسسين، وتبقى أكثرية الناس متّكئة على حلم الإنجاز والترقي أو ساعية، بتقية، وراء لقمة عيشها والسلامة.
لقد كنا قبل غزة في محنة؛ فماذا بعد غزة، في وقت لا السياسة عندنا ولا أحزابها وحركاتها الدينية الناشطة ولا مؤسسات المجتمع المدني قادرة وطبعا لا أمساخ "نظام التفاهة" قادرون على حمل المسؤولية وإنقاذنا من هذا الجحيم؟
هذا هو راهننا؛ مجتمع يتخبط ويتأرجح على حافة السؤال الأعظم في حين تخطط إسرائيل لابتلاع هياكله وبناه ومنجزاته، بينما تصاغ هوياته الفئوية، في تفاعلاتٍ اجتماعيةٍ وسياسية "سائلة" وتتسرب جزيئياتها في قنوات إسرائيلية معطوبة أو في قوالب أيديولوجية وسياسية مستوردة تحت اسم "المشروع الإسلامي" حينًا وحينًا تحت اسم "المشروع الوطني الفلسطيني" أو سراب " القيادة الفلسطينية الموحدة "، وكل ذلك يجري من دون أن ننجح في مواجهة قضايانا المحلية الكبيرة والمتعثرة أو حتى مواجهة إفرازات واقعنا الإشكالية اليومية، وهي كثيرة ومربكة.
فمثلا، في شهر أبريل الماضي تم انتخاب البروفيسور منى مارون من قبل مجلس شيوخ جامعة حيفا لمنصب عميدة الجامعة وستبدأ في ممارسة مهامها في بداية شهر أكتوبر المقبل. مع انتشار خبر انتخابها باشر مئات المواطنين العرب، من خلفيات دينية وأكاديمية وسياسية مختلفة، بتهنئتها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين اعتزازهم بإنجازها وبكونها عربية وامرأة وجديرة بهذا الاختيار. بعد انتخابها صرح رئيس جامعة حيفا البروفيسور غور الروي على أنه سعيد "باختيار أعضاء مجلس الشيوخ لها" وأنه "ينتظر بفارغ الصبر العمل معها، فاختيارها يرمز أكثر من أيِّ شيء آخر إلى الروح الخاصة للجامعة" وأضاف أنه تم "اختيار منى لأنها باحثة متميزة، ولأنها نائب ممتازة لرئيس معهد أبحاث الدماغ في الجامعة، ولأنها عززت تفوقنا الأكاديمي، ولأن أعضاء هيئة التدريس كانوا يعتقدون أنها الشخص المناسب لمواصلة تقدم الجامعة نحو أهدافنا" وأنهى تصريحه قائلا: "في جامعتنا يمكن أن يكون الشخص المناسب رجلًا أو امرأة، يهوديا أو عربيا ، فهذا لا يهم حقا، وليس مهمًا ، هذا هو معنى وجودنا المشترك". هل من غضاضة في هذا الكلام؟
 |
|---|
بروفيسور منى مارون
قبل أيام أرسل لي صديق نصا نشر بتاريخ 2024/6/18 في مجلة نيتشر (nature) العدد (630) بعنوان "مقاطعة الأكاديميين في إسرائيل تعود بنتائج عكسية" وتدعو فيه البروفيسور منى مارون وعدد قليل من زملائها المحاضرين الى عدم مقاطعة الجامعات والأكاديميين الإسرائيليين. ولقد عللت موقفها بتخوفها من أن المقاطعة قد تؤدي الى تقليص فرص قبول الطلاب الفلسطينيين في معاهد الأبحاث العلمية العليا، كذلك بموقف الأكاديميا الإسرائيلية العام المساند لحقوق الإنسان والرافض غالبا لسياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية، وأخيرا لأنها وزملاءَها يعتقدون أن الحوار والمشاركة هما الطريق الأضمن للتغيير داخل إسرائيل.
هكذا كتبت في رسالتها، فهل سيتغيّر موقف مهنئي بروفيسور منى بسبب نصها المذكور؟ وهل يبطل رأيها حول عدم نجاعة مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين للأسباب العملية والنفعية الواردة، إنجازاتها كامرأة عربية مسيحية، كما قامت بتعريف نفسها في بعض مقابلاتها، عصامية رائدة في أبحاثها وقدوة لكثيرات من الطالبات والطلاب العرب كما أشاد بها مهنئوها؟ أكاد أسمع شلل الإجابات المنددة بها وبموقفها، وأسمع كذلك صمت من هم في منزلة منى مارون وأبناء شريحتها، وهم كثر.
سيبقى ما نشرته منى مارون وموقفها إزاء المقاطعة الأكاديمية، في هذه الأيام بالذات، موقفًا شاذا عن المقبول والمعقول وعن الموقف الرائج بين الأكاديميين العرب وكثير من اليهود أيضا؛ وسيحرج رأيها بعض الذين هنأوها، خاصة أولئك الذين لا يعرفون عنها إلا القليل كما نشر بعد تعيينها. وهل سيتأثر الموقف إذا عرفنا أنها في الحقيقة لم تخفِ رأيها في مسألة المقاطعة بل أعلنته في مقابلة أجريت معها قبل تعيينها بكثير وقالت حينها: أنا ضد المقاطعة. أنا لا أقاطع، لأنني اذا قاطعت أحدهم سأكون الأولى التي يمكن مقاطعتها؛ فأنا ابنة لأقلية، أنا عربية، أنا مسيحية، أنا امرأة، فمن الجائز إيجاد أسباب عديدة لمقاطعتي".
لم أعرف منى مارون شخصيا، لكنني قرأت عنها بعد اختيارها لمنصب عميدة الجامعة، وتعرفت على سيرة فتاة طموحة وقوية ومؤمنة بقدراتها على العطاء، ليس في ميادين البحث العلمي فحسب، بل في مساعدة أبناء مجتمعها العربي، خاصة البنات بينهم، وحضّهم على التعلم والتقدم في الحياة. سيرتها الذاتية لافتة، ومواقفها، التي لا أتفق مع بعضها، واضحة؛ فهي على سبيل المثال، كمسيحية، غير مستعدة لإيذاء أحد حتى ولا أعدائها رغم أنها تعرفهم وتعرف مشاريعهم. إنها ابنة لشريحة مواطنين عرب، من جميع الأديان، موجودة في مجتمعنا تحركها مفاصلها المتشابكة مع الدولة وأكثر مع أماكن عملها مثل الجامعة التي تعتبرها، البروفيسور منى، بمثابة بيتها الثاني. ورغم أنها امرأة متفائلة، لكنها تعي حدود ما تستطيع أن تناله كعربية ومسيحية لم ولن يحميها صليبها في الدولة اليهودية ومجتمعها المتطرف، خاصة في عصر قانون القومية العنصري.
سيبقى تصريح بروفيسور منى مارون المذكور سببا في انتقادها من قبل البعض وسيسجل في صفحات بعض الفسابكة وغيرهم، كمنقصة وككبوة أو كمداهنة للدولة وللجامعة، خاصة أنها تعرف أن إسرائيل التي احتضنتها كطالبة علم وكباحثة فذة لم تعد اسرائيل نفسها.
وسيرغب بعض القرّاء أن أُقفل الدائرة على عتبات جامعة حيفا لكنني لن أفعل؛ فالقضية التي نبشتها حادثة البروفيسور منى مارون تذكرنا، مع الفوارق طبعا، بقصص غيرها من البروفيسورات والأكاديميين والمفكرين العرب، وتفتح مواجع واحدة من معاضل وجودنا كفلسطينيين في الدولة اليهودية. إن ما نراه في كل مرة وكبوة ما هي إلا شظايا "لألغام" لم نعرف كيف نفككها قبل الحرب على غزة؛ فكيف سنعرف بعد غزة، وقد يصير “مشهد اليوم التالي"، حتى في جامعة حيفا، مشهد الختام ونهاية القصة؟