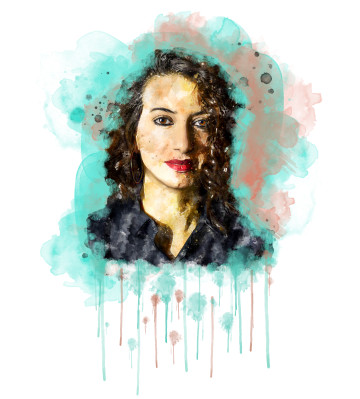مساء الأمل سوريتي الجريحة!

الكثير من الأصدقاء في قطاع غزة يسألوني دائمًا ما سر كتابتي لهذه الجملة كلّ مساء على حائط صفحتي على الفيس بوك ""مساء الأمل سوريتي الجريحة!""، وأرفق وراءها عدّد الأيام، عدّد الأيام تجاوز ال 3292 يومًا، فهذا العدّد تربطني به علاقة كبيرة لا يعلمها الكثيرون، هو عدّد الأيام التي غبت فيها عن سوريا الحبيبة منذ خروجي منها هربًا من الحرب الدائرة، هربًا من الموت والبراميل المتفجرة، هربًا للحياة، ولكن لا حياة وأنا بعيد عن رائحة وطني.
28/12/2012 تاريخ لن أنساه ما حييت، وقفت في أرض الدّار التي تكبرني بأعوام أتأمل الجدران، أتأمل ذكريات جدي وجدتي وأبي، في تلك السّاعة وتلك اللّحظة كاد قلبي أن يخرج من بين ضلوعي. فأمي غادرت هذه الحياة عندما كنت طفلًا، أما أمي الكبيرة ""سورية"" سوف أغادرها بعد لحظات مجبورًا ومقهورًا ومحملًا بألف كيلوغرام من الذّكريات. الحقائب رحلت بالأمس لتمهد لي الطّريق، وحقيبة السّكاكين الخاصة بي كذلك فهي كلّ ما أملك بعد أن تضرّر مطعمي الخاص، نعم حانت لحظة الرّحيل عن سوريتي، حملت ذكرياتي في معطفي الشّتوي وحملت رائحة سوريتي في زجاجة عطري وتوجهت للجهة المقابلة سيرًا على الأقدام.
كان عليَّ السّير مسافة لا تقل عن ثمانية كيلومترات حتى لا أعرض نفسي لحاجز من هنا أو هناك، وكان هدير الطّائرات يرافقني والقصف وأصوات الانفجارات، في السّاعة الرّابعة بعد الظّهر كنت في نقطة الانطلاق.
توجهت بنا السّيارة إلى ريف حلب الشّمالي وبالتّحديد مدينة اعزاز التي قضيت فيها ثلاثة أيام من القلق والتّوتر بسبب القصف، ثم توجهت لمعبر باب السّلامة ومنه للأراضي التّركيّة لأبحث عن حياتي الجديدة، لكن عائق اللّغة كان له هاجسًا كبيرًا فقرّرت التّوجه للقاهرة.
أربعة وأربعون ساعة في البحر المتوسط في رحلة انطلقت من ميناء ""اسكندرون"" في تركيا إلى ميناء بور سعيد المصري عبر باخرة ضخمة.
هنا القاهرة المدينة التي لا تنام، وازدحام شوارع هذه المدينة كازدحام الشّوق لسوريتي، سبعة أشهر من العمل في إحدى المطاعم في القاهرة حتى جاءت لحظة الرّحيل لقطاع غزة بمساعدة شاب فلسطيني يملك أحد المطاعم هناك.
التّردد في أخذ القرار كان صعبًا، لكن شيء ما في داخلي دفعني للمغامرة فالحياة واحدة والعمر واحد وكما يقول السّوريون (خربانة وخربانة).
حزمت أمتعتي وتوجهت إلى رفح المصريّة، خمس ساعات كانت كفيلة لترميني على باب أحد الأنفاق الواصلة بين البلدين، وأقل من خمس دقائق كانت كفيلة لأشاهد النّور في آخر النّفق مصحوبًا بالعلم الفلسطيني الذي يرفرف.
8/5/2013 وقفت استنشق الهواء الفلسطيني لأملأ الرّئتين بأكبر كمية، وسجدت لا شعوريًا أقبل هذه الأرض الغاليّة عليَّ وعلى كلّ السّوريين.
توجهنا عبر الشّريط السّاحلي من رفح إلى مدينة غزة وكان في استقبالي طبق كبير من المفتول الفلسطيني الذي تذوقته لأوّل مرة، وما أن أتحدث ويلاحظ النّاس لكنتي الحلبيّة حتى تنهال عليّ الكلمات الطّيبة، أنت في بلدك ... فلسطين هي أرضك ... ونحن بلد واحد وشعب واحد.
أوّل تحدي بالنسبة لي بما أنني أعمل كشيف منذ أكثر من 22 عامًا هو نشر المطبخ السّوري هنا وبالتّحديد المطبخ الحلبي، ومن هنا بدأت بالتّركيز على عملي وأطباقي وبدأت وسائل الإعلام المحليّة والدّوليّة في نشر تقارير مكتوبة ومصورة عن ""الشيف وريف"" لاجئ سوري أصبح سفيرًا للمطبخ السّوري في غزة.
مرت الأيام وكان لي النصيب أن التقي بشريكة حياتي الفلسطينيّة، وبعد أشهر من زواجنا كانت حرب غزة 2014، رافقت حينها زوجتي خلال تغطيتها للأحداث بحكم عملها كمراسلة للأخبار، في بعض الأحيان عندما يشتد القصف أتخيل نفسي في غرفتي في حلب فالأصوات ذاتها حتى الدّمار، كل شيء يعيدني بالذّاكرة إلى سوريا.
ثماني سنوات مضت وأنا في قطاع غزة محاصر كأهلها، لست لوحدي أعاني فأيضًا هناك عشرات العائلات سوريّة الأصل تعيش في قطاع غزة لا تستطيع السّفر أو التّنقل بحريّة، واستطعنا إيصال صوتنا للسلطة الفلسطينيّة التي منحتنا جوازات فلسطينية ""بدون رقم وطني"" ومع ذلك قرار السّفر ليس سهلًا في ظل الأوضاع المتوترة التي يعيشها القطاع سياسيًا وجغرافيًا.
عدد لا بأس به من العائلات السّورية استطاعت الخروج من قطاع غزة عن طريق مفوضيّة شؤون اللاجئين العليا التي تواصلت معنا عبر الفيديو لتسجيلنا ضمن ملفاتها .
ثماني سنوات ولا أستطيع أن أعبر معبر رفح لأسافر لأي بلد حتى التقي بأخواتي المنتشرين في أرجاء المعمورة، نتواصل فقط عبر وسائل التّواصل الاجتماعي ونرجع بذكرياتنا لأيام سوريا الجميلة، فكلّ تفاصيل تتعلق بطفلتي ايلياء تتابعها عائلتي عبر الفيديو، أوّل خطوة لها وأوّل كلمة نطقتها، لبس العيد، والتحاقها بالرّوضة، كلها تفاصيل تجمعنا في الواقع الافتراضي.
لم أخف أبدًا من أصوات الصّواريخ أو الانفجارات في سوريا أو خلال الحرب على غزة إلّا أنّ الحرب الأخيرة على غزة 2021 دفعتني للخوف والخوف الشّديد بعد أن رزقت بطفلتي. لا أريدها أن تشعر بالخوف أبدًا، فالأب هو مصدر الأمان لأبنائه إلّا أنني شعرت بالعجز لأنني لم أتمكن أن أشعرها بالأمان، حتى بعد أن انتهت الحرب لاتزال ايلياء تخاف من الأصوات المرتفعة.
نعم اللاجئ الفلسطيني خرج وأخذ معه المفتاح لأنه سيعود.
أما اللاجئ السّوري خرج حاملًا سوريا في حقيبته لأنه سيعود.
وسينهض بالبلد ويبنى سوريتنا الجميلة من جديد بإصراره وعزيمته واجتهاده
ومن قلب غزة هنا سوريا، ومساء الأمل سوريتي الجريحة.