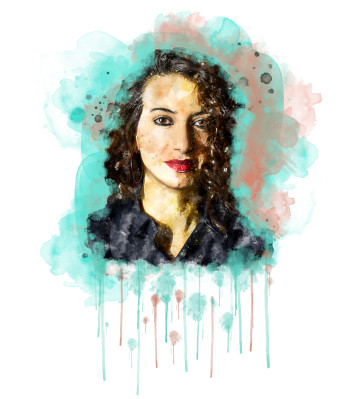كورونا وأثرها التعليمي على الأطفال

مما لا شكّ فيه، أن أزمة الكورونا ستعمّق الفجوات في المجال التعليمي بين العرب واليهود، وكذلك داخل مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، على خلفية الفجوات الاقتصادية والاجتماعية للطلاب، خاصةً وأن حوالي نصف العائلات العربية، وحوالي ثلثي الطلبة العرب، يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ومع ازدياد البطالة والأثر الكارثي للأزمة على واقعنا، فإنّ الوضع في الواقع هو أسوأ من هذه المعطيات.
يعالج هذا المقال، أثر الأزمة على الطلبة أبناء الطبقات التي تعاني من أوضاع صعبة، وعلى اتساع الفجوات داخل مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وضرورة وضع هذه القضية في مقدمة أولويّاتنا.
هناك تأثير كبير للعوامل الاقتصادية والاجتماعية على وضع الطلبة التعليمي وعلى تحصيلهم المدرسي؛ فوضع العائلة الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، له انعكاساته المباشرة على وضع الأبناء في المؤسسات التعليمية. هذا الأثر، يساهم في وجود فجوات تعليمية كبيرة بين الطلبة على أساس طبقي نراها في المدارس، وهي واضحة في الأبحاث والامتحانات المختلفة.
أزمة الكورونا المستمرة منذ اذار 2020، ولا نعرف متى ستنتهي، لها أثرها الكبير على التعليم. ومن السابق لأوانه، تلخيص هذا الأثر واستخلاص كل العبر منه، ولكن هناك حقيقة تبدو واضحة وضوح الشمس في ظهيرة يوم صيفي مشمس، تتلخّص في أنّ هذه الأزمة ستعمّق الفجوات في التعليم بشكل هائل، وأنّ أوّل وأكثر من يدفع الثمن الباهظ، هم الأطفال أبناء العائلات المسحوقة. ولهذا الأمر انعكاسات صعبة على الأطفال وعائلاتهم ومستقبلهم وكذلك على المجتمع. والمطلوب هنا، عدم تجاهل أو حتى إنكار هذه الحقيقة، بل وضعها على رأس سلم أولويّات المسؤولين ومتخذي القرارات في المستويات المختلفة، والمعلمين عمومًا، وبناء خطط تعطي الحلول لهذه الفئة الكبيرة من الطلاب.
لقد اختارت الحكومة في إسرائيل، إغلاق المدارس لفترات طويلة، كجزء من الخطّة للحد من انتشار وباء كورونا، وخطّتها كانت مواصلة التعليم من خلال منظومة "التعلم عن بعد" التي تعتمد على الحواسيب والإنترنت، بل أن بعض متخذي القرارات، اعتقدوا أنّه بالإمكان التخلي حتى عن دور المعلمين والمدارس، ومواصلة التعليم من خلال استديوهات خاصة يقوم بها معلم واحد، بتمرير درس لجميع الطلاب في البلاد. خطوات الوزارة هذه، تعكس فهم ضيق جدًا للعمل التربوي واحتياجات الطلاب المتنوعة، وكذلك عدم معرفة بالواقع الميداني، خصوصًا أن وزارة التربية لم تجرِ مسوحات لفهم واقع الطلاب، ومدى جهوزيّة المدارس والمعلمين والطلاب والأهالي لمثل هذه الخطوات. لم تفحص وزارة التربية بدائل أخرى لمواصلة العمل التربوي والتعليمي، وكان قرار الانتقال لمنظومة "التعليم عن بعد" شبه فوري، دون فحص خيارات أخرى قد تكون أفضل في ظل الظروف القائمة، كالدمج بين التعلم من المدرسة بمجموعات صغيرة والتعلم من البيت، على أن لا يقتصر التعليم من البيت على الحواسيب. حقيقة أنّه كان واضحًا منذ البداية، أنّنا أمام أزمة صعبة لم تدفع متخذي القرارات إلى التفكير في وضع أهداف خاصة بهذه المرحلة وظروفها، وحسب الواقع في الحقل. كذلك، جرى تجاهل معطيات المسوحات التي أجرتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في البلاد، بالتعاون مع مديري أقسام التربية في السلطات المحلية العربية في بداية الأزمة، والتي أظهرت بشكل قاطع أن حوالي 150.000 طالب عربي على الأقل، لا يملكون الحواسيب ووسائل مناسبة للتعلم عن بعد، وأنّ عشرات آلاف الطلبة العرب يسكنون في بلدات وأحياء تفتقر إلى البنى التحتية لشبكة الإنترنت، وحذرت من الظروف الصعبة في النقب عمومًا، وفي القرى غير المعترف بها خصوصًا. وبعد أن قمنا بطرح هذه القضايا والمعطيات التي جمعناها بطرق علمية بقوة في الإعلام والقضاء ولجان الكنيست وفي جلسات مختلفة مع الوزارة، أعترف بعد أشهر من بدء الأزمة، بفشل منظومة "التعلم عن بعد" في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، حيث أجريت تغييرات في السياسات، تضمنت توزيع حواسيب على الطلاب ورصد ميزانيات لحوسبة المدارس ومحاولة ملاءمة الخطط للمجتمع العربي. هذه التغييرات في السياسات التي جاءت متأخرة، كانت حصيلة نضال جدّي لقوى عديدة، وقد ساهمت في إحراز بعض الإنجازات الهامة، ولكن هذه الإنجازات مع أهميتها، بعيدة عن سدّ الفجوات وحلّ المشاكل والنواقص في الحقل. هذه الموارد الجديدة، ربما سيكون لها تأثير مستقبليّ إذا تمّ استغلالها بشكل جيد، ولكنّ تأثيرها على الوضع في الأزمة الحالية محدود.
لقد عانى التعليم العربي كثيرًا خلال الأزمة، بسبب الفجوات بين التعليم العربي واليهودي في إسرائيل، وهي حصيلة سياسة التمييز الممأسس والممنهج ضد الفلسطينيين في الـ 48 وعدم تجهيز المعلمين والمدارس لحالات الطوارئ والفجوات الرقمية والتكنولوجية القائمة في جميع المجالات، وعدم احترام واستعمال اللغة العربية ونقص المضامين المحوسبة بالعربية، وعدم دمج التكنولوجيا والأدوات الرقمية في ثقافة التعليم في المدارس العربية وما إلى ذلك من قضايا.
إلى جانب المشاكل المتعلقة بمنظومة "التعلم عن بعد"، هناك أزمة الثقة وانتشار كورونا في قرانا ومدننا العربية من الموجة الثانية ولغاية يومنا هذا، والتي فاقمت الوضع سوءًا وأدّت إلى إغلاق مدارس عربية كثيرة (بقرار حكومي أو بمبادرات محلية) وتشويش العملية التعليمية، في الوقت الذي تمت فيه مواصلة التعليم على مستوى الدولة.
عندما تغلق المدارس، فعمليًا يُحرم أكثر من نصف الطلاب العرب الفلسطينيين في الداخل من التعلّم، لأنّهم لا يملكون الحواسيب ووسائل تمكنهم من "التعلم عن بعد". كذلك كون التعلم عن بعد متعلق بمساعدة الأهل وظروف وإمكانيات البيت والعائلة، فإنّه زاد وعمق تأثر العملية التعليمية بوضع ودور وإمكانيات الأهالي وقدراتهم.
في الوضع الذي نشأ بسبب الأزمة، وإدارتها التي تجاهلت وضع واحتياجات المجتمع العربي والطبقات التي تعاني من ظروف الفقر والأوضاع الصعبة، تمّ حرمان فئات واسعة من الأطفال من التعليم، والخسائر التعليمية للطلاب هائلة. من المهمّ الإشارة إلى أن امتلاك الشروط الأساسية للارتباط بمنظومة "التعلم عن بعد"، لا يعني تلقي تعليم متساوٍ وبجودة عالية، حيث تتعلّق جودة وعمق العملية التعليمية بعوامل كثيرة تطرقت إلى بعضها سابقًا.
مع أنّ الغالبية الساحقة من الطلاب قد تضررت من الأزمة الحالية، إلا أنّني أعتقد أنّ هناك فئة من مجتمعنا ستتمكن من تعويض أبنائها على الخسائر التي لحقت بهم، ولن تعتمد فقط على ما ستقدمه الحكومة. وتبقى القضية المركزيّة، هي من سيعّوض الأطفال أبناء الطبقات المسحوقة والفقيرة، والتي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، وقسم منها يعيش في ظروف "الخطر"، ولا توجد إمكانيّات لتعويض الأطفال في هذه العائلات، عن الخسائر التي لحقت بهم.
عدم إيجاد حلول لهذه الفئة الكبيرة من الطلاب، سينعكس سلبيًا على واقعهم ومستقبلهم، وسيكون لذلك أثر على المجتمع ككل. هؤلاء الطلاب سيعانون من التهميش في المدارس وفي المجتمع، وستشعر بالمزيد من الاغتراب، وقد يكون قسم من هؤلاء الشباب فريسة سهلة لشبكات الإجرام المنظم والعنف، كلّ هذا، في الوقت الذي نرى مجتمعنا فيه، في أمس الحاجة إلى بناء حصانة مجتمعية ولحمة، تمكنه من مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها، وأبرزها مواجهة ظاهرة العنف والجريمة المنظمة.
سأختم هذا المقال بالإشارة إلى بعض الخطوات المطلوبة في المستويات المختلفة للمساهمة في إعطاء حلول:
مستوى السياسات الحكومية: المطالبة ببلورة خطط حكومية شاملة لمعالجة الفجوات وتعويض الطلاب، ورصد ميزانيات كافية لتطبيقها.
مستوى المدارس: لدى المدارس موارد وطاقات وإمكانيات هائلة يجب أن تستغل بشكل يساهم في معالجة قضايا الفجوات، ودعم الطلاب الذين تضرروا من أزمة كورونا. هذا يتطلب أيضًا تأهيل المعلمين وبناء برامج مدرسية عينية لدعم وتعويض هؤلاء الطلاب. بهذا الموضوع، يستطيع كل معلم الانتباه أكثر لاحتياجات الفئة التي عانت أكثر من غيرها ودعمها والاهتمام باحتياجاتها التعليمية، النفسية والاجتماعية. هذا يتطلب أيضًا العمل مع الأهالي، والعمل على تجنيد موارد وبرامج من مصادر مختلفة، تساهم في تلبية الاحتياجات للطلاب المتضررين. إلى جانب العمل على الناحية التعليمية للطلاب، ومن الضروري أن يتم بناء برامج على مستوى المدرسة، حول قضايا التربية للقيم والهوية والانتماء ومواجهة حالة الاغتراب.
المستوى البلدي: استغلال الموارد المخصصة للتعليم اللامنهجي والثقافة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية لبناء برامج تساهم في معالجة المشكلة.
مستوى المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والأكاديمية والبرامج الاجتماعية والتربوية المختلفة: إعطاء أولوية لبناء برامج تساهم في دعم أبناء الطبقات الأكثر تضررًا من أزمة كورونا.